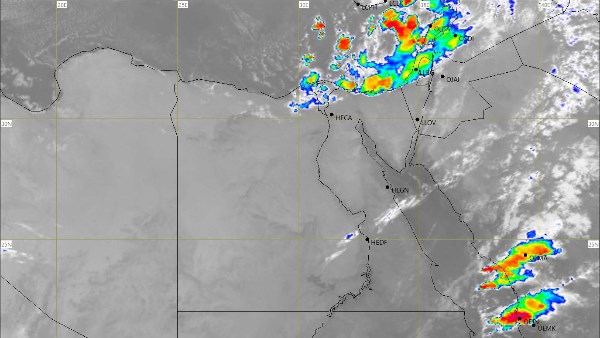دراسة: التغير النفسى ضرورة لمكافحة العناصر المدمرة لقوى المجتمع

لم تعد الحاجة إلى دراسة شخصية وسلوكيات الأفراد وما طرأ عليها من تغيرات وتحولات بعد الثورات ترفيها، وإنما ضرورة قصوى لفهمها وتفسيرها بصورة علمية حتى تتمكن الحكومات من السيطرة على الظواهر والمتغيرات الجديدة السلبية مثل العنف والانفلات السلوكي وضعف الانتماء وانعدام المسئولية وغيرها، مما تسبب في تشكيل جماعات عدائية للوطن وتكوين مجموعات سرية وأخرى علنية هدامة للدين ومدمرة لقوى المجتمع.
وتتمثل أهمية تفسير المتغيرات هذه بصورة علمية، من أجل مواجهتها أو التقليل من آثارها المدمرة على المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص ومسيرته نحو النهوض والتقدم والحفاظ على تماسكه واستقراره مثلما هو قائم بالنظم الديمقراطية بالدول المتقدمة، ومن أجل دراسة وبحث إمكانية استثمار مثل هذه الطاقات الهدامة وتحويلها إلى طاقات إيجابية داخل مجتمعات دول الربيع العربي وتنظيماتها الرسمية على وجه التحديد وبلدان العالم العربي بصفة عامة.
لماذا تغيرت العلاقات السيكولوجية - الاجتماعية للمجتمع المصري بشكل سريع وملحوظ للجميع في الآونة الأخيرة، ولم تعد مثلما كانت عليه ، سؤال يطرح نفسه على أذهان المصريين بكل فئاته وطبقاته، الأمر الذي دفع صانعو القرار والباحثون إلى "وقفة انتباه عميقة" لمعرفة دلالات وتداعيات التغير النفسي الاجتماعي الذي طرأ على دول الربيع العربي وتنظيماتها الرسمية على وجه الخصوص.
ومن المعلوم أن العلوم النفسية الاجتماعية لا تقل أهمية عن العلوم الطبيعية وأن مجتمعاتنا العربية أصبحت في أشد الاحتياج لها أكثر مما مضى، للمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنمية المجتمعية الشاملة.
ويرى الباحثون والمتخصصون في علم النفس الاجتماعي أن تغير سيكولوجية "نفسية" المواطن بالدول العربية التى تمر بفترات انتقالية أو حالة عدم استقرار يعد العامل الأساسي الذي يقف وراء تراجع مستوى الأداء والإنتاج بالمؤسسات الرسمية للدولة بجميع مستوياته.
ولهذا لم يكن أمام الباحثين بديلا عن حتمية التوصل إلى رؤية استراتيجية أو آلية مستقبلية لمساعدة صانعي القرار بشأن مواجهة ومكافحة ما تم توصيفه "إلحاق الهزيمة النفسية" بأبناء الوطن الواحد وتداعياته وثيقة الصلة بما أسموه "اليأس من التغيير"، خاصة داخل التنظيمات الرسمية جراء استهداف العنصر البشري بدول الربيع العربي وغيرها، بشكل منظم ومخرب للعقول والمجتمعات على حد سواء باستخدام تقنيات التواصل الحديثة "مقروء - مسموع - مرئي"، ومن ثم يسهل تنفيذ مخططات السيطرة على مقدرات الشعوب وبلدانهم لحساب قوى بعينها.
وهو ذات الأمر الذي انتبه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اختياره ولأول مرة عالما نفسيا ضمن المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، الذي تم تشكيله بقرار جمهوري.
ويؤكد المتخصصون وفقا لأحدث الدراسات والأبحاث حول علاقة التغير النفسي الاجتماعي للأفراد، بواقع الأداء والنتاج على مستوى الفرد والمؤسسة أن العلاقات النفسية الاجتماعية والوظيفية تؤثر بشكل مباشر على مستوى الإنتاج بشكل عام بالسلب أو الإيجاب بسبب ما أسموه "الحاجز النفسي بين الرؤساء والمرؤوسين" داخل المؤسسات.
وتركز هذه النظريات السيكولوجية - الاجتماعية على دور الفرد في التغير الاجتماعي وعلى دور الأفكار التي يحملها الأفراد في تغير أنماط الحياة ومسارها، وتتأسس هذه النظرية على فرضية أن التغير الذي يصيب المجتمع يحدث أساسا في الأفراد، كونهم الذين يغيرون وهم الذين يتغيرون، ولذلك فإن هناك مكانا للعوامل النفسية في حركة التغير الاجتماعي.
الدور التغيري للأفكار كان لب "نظرية ماكس فيبر"، والتى أظهرت أهمية الأفكار في إحداث التغير الاجتماعي من خلال دراسته عن الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية، حيث يؤكد على الدور الذي تلعبه نوعية خاصة من الأفكار في إحداث تغير اجتماعي معين، لقد ظهرت الأنشطة الرأسمالية في أرجاء مختلفة من الأرض وفي أوقات مختلفة عبر الزمن، ولكن أيا منها لم يكن مثل الرأسمالية يعتمد أساسا على المبادئ العلمية، وعلى نظام قانوني إداري متميز، والكفاءة الفنية والفضيلة والمنافسة الحرة والموازنة المستمرة بين التكلفة والعائد، العمل الحر الرشيد الذي يتحدد من خلال فضائل وقيم محددة تتمثل في الاقتصاد في الإنفاق وضبط النفس والابتكار والتجديد، وهذه كلها خصائص نموذجية للرأسمالية الغربية الحديثة التي تختلف في طبيعتها عن الرأسمالية التقليدية.
فيما ركزت نظرية الشخصية المحددة لإيفرت هاجن على دور المجددين في إحداث التغير الاجتماعي، وذلك بنظرته إلى المجتمعات التقليدية على أنها مجتمعات ساكنة راكدة تعرف نظما جامدة للمكانة الاجتماعية (وجود جماهير من الفلاحين وصفوة حاكمة) تحكمها علاقات تسلطية غير مبدعة وغير دافعة للتجديد، وينعكس ذلك على الأفراد الذين يعيشون في هذه المجتمعات، حيث يتصفون بعدم القدرة على التجديد وعدم القدرة على ضبط وتحليل العالم الذي يعيشون فيه ومثل هذا المجتمع يعد مجتمعا ساكنا وقد لا يعرف التغير لعدة قرون، ويفترض هاجن أن ثمة علاقة قوية بين طبيعة البناء الاجتماعي وبين نمط الشخصية، بحيث يمكن القول إن البناء الاجتماعي لن يتغير إلا إذا تغيرت الشخصية.
ومن هنا تبدأ نظرية هاجن في التغير الاجتماعي، فذلك التغير يرتبط بعوامل نفسية، أي يخلق أنماط الشخصية القادرة على التجديد، وتتسم مثل هذه الشخصية بالابتكارية والفضول والانفتاح على الخبرة، وأنها تسعى إلى ابتكار حلول جديدة ولا تقبل ما هو قائم منها، كما أنها تنظر إلى العالم من حولها على أنه عالم يقوم على نظام معين قابل للفهم ، وتكون قادرة على حل المشكلات التي تواجهها في العالم.
ويفترض هاجن أن التغير في البناء التقليدي للمجتمعات يبدأ عندما تظهر مجتمعات من الأفراد لها هذه الخصائص تهدد بناء الواقع القائم وتسحب البساط من تحت أقدامه، ومثل هذه الجماعات تظهر بالتدريج، ومن خلال عمليات مستمرة من الانسحاب، ويرتبط ظهورها وتكاثرها بظهور ظروف اجتماعية (ترتبط بالأسرة والتنشئة الاجتماعية)، وهكذا يحدث التغير بشكل تدريجي فينتقل المجتمع من حالة التسلطية، إلى حالة الابتكارية مرورا بعمليات وسيطة ترتبط بتحدي نظم المكانة القائمة والانسحاب منها.
فإذا كان الباحثون في السلوك التنظيمي يركزون على سلوك الفرد في عمله وجميع المفردات التي تتعلق به، فإنه لا توجد دراسات محلية حول التغير النفسي الاجتماعي وعلاقته على وجه التحديد بتطور العنصر البشري وتطوير المؤسسات والتنظيمات الرسمية، إلا أن دراسة بحثية نشرت مؤخرا عن المركز الوطني للمعلومات باليمن أكدت أن واقع التغيرات النفسية الاجتماعية شكلت ظواهر بالغة الخطورة وثيقة الصلة بتراجع الأداء على مستوى الفرد والمؤسسة.
ولم يكن أمام الباحثين سوى الاجتهاد لوضع آلية إنقاذ من مخاطر ومدمرات التغير النفسي الاجتماعي لعناصر وقوى التنظيمات الرسمية بالدولة، وقد شملت هذه الآلية على عدة بنود أهمها اتخاذ سياسة الإنصات للموظفين لسماع مشاكلهم والتحدث عن طموحاتهم والترحيب بأفكارهم الجديدة ومقترحاتهم، والمساهمة في مساندة العاملين بالدولة على استقرار حياتهم الأسرية والعائلية من خلال إنشاء إدارة بحوث إجتماعية داخل كل بيئة عمل يكون هدفها كشف وحل المشكلات الحياتية والمعيشية كالزواج وغيرها.
وتضمنت تحقيق الأمان الوظيفي عبر إجراءات تتخذها بيئة العمل نفسها تجعل الموظف يقدم إخلاصه وولائه للمنظمة أو المؤسسة التي يعمل بها بحيث يكون غير راغب في ترك العمل، والاستحواذ على قلوب العاملين والموظفين بالمؤسسة عبر تكوين علاقة أخذ وعطاء بينهم وبين الإدارات العليا للمنظمة ومع زملائهم في العمل، والتخلص من احتكار سرية المعلومات الخاصة بالمؤسسة وإعطاء شيء من الحرية في إطار العمل لعدم ظهور أية مشاكل أو مشاحنات.
كما تضمنت تقليل الفوارق في الأجور، والذي من شأنه أن يجعل جميع الموظفين على العمل، بدلا من إضاعة وإهدار الوقت والجهد، بل والعمر كله في التقرب للمدراء والرؤساء للحصول على مكاسب شخصية، وضرورة ألا يرتبط تواجد الموظف في مكان عمله بساعات الدوام الرسمي وإنما بوجود عمل مكلف به، تفعيل المشاركة في اتخاذ القرار الإداري، خاصة من قبل العناصر الشبابية من الرجال والنساء وإعطائهم بعض الصلاحيات بطريقة سليمة تحت إشراف الكفاءات من الكبار.
وشملت تشكيل لجان متخصصة مؤهلة تعمل على تقييم أداء الرؤساء في بيئات العمل، على أن تتم إتاحة الفرصة للمرؤسين في تقييم رؤسائهم، وإجراء بحوث ميدانية عن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الموظفين والعاملين بالمؤسسة وعن الحلول العاجلة لمواجهتها وكذلك بحوث عن دور وآراء النقابات المهنية بالدولة.