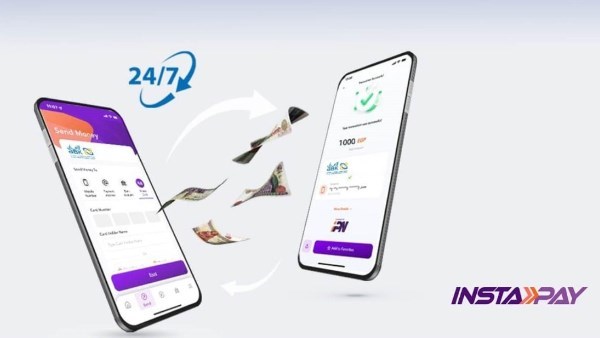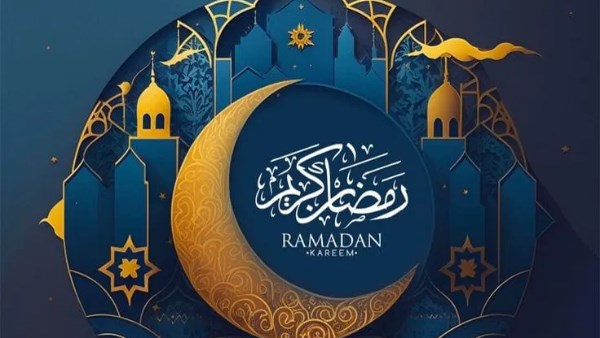عرف الكاتب إبراهيم عبد القادر المازني الذي تحل ذكرى ميلاده غدًا، الاثنين، كواحد من كبار الكتاب في عصره، كما عرف بأسلوبه الساخر سواء في الكتابة الأدبية أو الشعر، واستطاع أن يلمع على الرغم من وجود العديد من الكتاب والشعراء الفطاحل، حيث تمكن من أن يجد لنفسه مكانًا بجوارهم، على الرغم من اتجاهه المختلف ومفهومه الجديد للأدب، فقد جمعت ثقافته بين التراث العربي والأدب الإنجليزي كغيره من شعراء مدرسة الديوان.
ويعد إبراهيم المازني من رواد مدرسة الديوان، ومن مؤسسيها مع عبد الرحمن شكري وعباس العقاد، ويستطيع الكاتب عن الشخصيات أن يختار المهنة التي تناسب الشخصيات التي يقدمها، ولكن من الصعب أن يتخيل أحدا للمازني مهنة غير الأدب «فخيل إليه أنه قادر على ان يعطى الأدب حقه، وأن يعطى مطالب العيش حقها، فلم يلبث غير قليل حتى تبين لهُ أنه خلق للأدب وحده، وأن الأدب يلاحقه أينما ذهب فلا يتركه حتى يعيده إلى جواره».
وحاول المازني الإفلات من استخدام القوافي والأوزان في بعض أشعاره فانتقل إلى الكتابة النثرية، وخلف وراءه تراثا غزيرا من المقالات والقصص والروايات بالإضافة للعديد من الدواوين الشعرية، كما عرف كناقد متميز.
ولد المازني في عام 1889 م في القاهرة في الخديوية المصرية، ويرجع نسبه إلى قرية "كوم مازن" التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ولقد تطلع المازني إلى دراسة الطب، وذلك بعد تخرجه من المدرسة الثانوية اقتداءً بأحد أقاربه، ولكنه ما إن دخل صالة التشريح حتى أغمى عليه، فترك هذه المدرسة وذهب إلى مدرسة الحقوق ولكن مصروفاتها زادت في ذلك العام من خمسة عشر جنيها إلى ثلاثين جنيها، فعدل عن مدرسة الحقوق إلى مدرسة المعلمين، وعمل بعد تخرجه عام 1909 مدرسًا، ولكنه ضاق بقيود الوظيفة، وحدثت ضده بعض الوشايات فاعتزل التدريس وعمل بالصحافة حتى يكتب بحرية، كما عمل في البداية بجريدة الأخبار مع أمين الرافعي، ثم محررًا بجريدة السياسة الأسبوعية، كما عمل بجريدة البلاغ مع عبد القادر حمزة وغيرها في الكثير من الصحف الأخرى، كما انتشرت كتاباته ومقالاته في العديد من المجلات والصحف الأسبوعية والشهرية، وعرف عن المازني براعته في اللغة الإنجليزية والترجمة منها إلى العربية، فقام بترجمة العديد من الأشعار إلى اللغة العربية، وتم انتخابه عضوًا في كل من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمجمع العلمي العربي بمصر.
وعمل المازني كثيرًا من أجل بناء ثقافة أدبية واسعة لنفسه فقام بالإطلاع على العديد من الكتب الخاصة بالأدب العربي القديم ولم يكتف بهذا بل قام بالإطلاع على الأدب الإنجليزي أيضًا، وعمل على قراءة الكتب الفلسفية والاجتماعية، وقام بترجمة الكثير من الشعر والنثر إلى اللغة العربية حتى قال العقاد عنه: «إنني لم أعرف فيما عرفت من ترجمات للنظم والنثر أديبًا واحدًا يفوق المازني في الترجمة من لغة إلى لغة شعرًا ونثرًا».
وعشق الراحل الشعر والكتابة الأدبية وعمل في شعره على التحرر من الأوزان والقوافي ودعا كغيره من مؤسسي مدرسة الديوان إلى الشعر المرسل، هذا على الرغم من أننا نجد أنه غلب على شعرهم وحدة القافية، واتجه المازني للنثر وأدخل في أشعاره وكتاباته بعض المعاني المقتبسة من الأدب الغربي، وتميز أسلوبه بالسخرية والفكاهة، فأخذت كتاباته الطابع الساخر وعرض من خلال أعماله الواقع الذي كان يعيش فيه من أشخاص أو تجارب شخصية أو من خلال حياة المجتمع المصري في هذه الفترة، فعرض كل هذا بسلبياته وإيجابياته من خلال رؤيته الخاصة وبأسلوب مبسط بعيدًا عن التكلفات الشعرية والأدبية، وتوقف المازني عن كتابة الشعر بعد صدور ديوانه الثاني في عام 1917م، واتجه إلى كتابة القصة والمقال الإخباري.
وتأثر "المازني" بابن الرومي، وقرأ له كثيرا وهو ما نعرف من التشاؤم والتطير، وما يدفع قارئه إلى السخرية الممزوجة بالتشاؤم، و"المازني" ساخر بطبعه، ومرح يحب النكتة، يسرها في أحرج المواقف حتى ينفس عما بداخله حماية له من اليأس والضغوط، وهكذا انتهى المازني إلى السخرية التي عرف بها حتى في عناوين أعماله "خيوط العنكبوت، وقبض الريح، وحصاد الهشيم، وصندوق الدنيا"، وبيته كان يقع قريبا من عين الصيرة، وعلى بعد بضعة أمتار من الطريق الممهد المرصوف الذي يخترق الصحراء بين الإمام ومسجد عمرو، وكان لهذا الموقع أثر كبير في نفس المازني، فقد كان في ذهابه وإيابه يمر على المقابر وهو مشهد أورث نفسه انقباضا.
وروى أنه وجد أمامه شبحا أو رجلا لا يدري يجري خلفه فجرى المازني ولكنه تعثر في أحد القبور ووجد نفسه ملقى على جثمان أحد الموتى، وخيل له أنه يطوقه بذراعيه، وظل أياما يرعد من هول هذا المنظر، فإذا لم يلجأ المازني للسخرية لضاعت حياته منذ زمن، وهذا هو الأثر الإيجابي الذي حققته السخرية في نفس المازني.
ولجأ المازني إلى السخرية من العيوب الجسدية والعقلية والخلقية لنفسه وللآخرين، وسخر من العيوب الاجتماعية والسياسية للأفراد والأمم والجماعات، ولولا السخرية عند المازني لكان قد مات قبل وفاته بزمن طويل خوفا أو كمدا أو اكتئابا بفعل كل الظروف التي مر بها، جسدية وأسرية وحياتي، ولقد أفرغ طاقته الساخرة في الاستخفاف والمرح، ولا يبالي أن يجعل من الكتاب الذي ينقده أضحوكة مثيرة، وهذا نراه في نقده للدكتور طه حسين، ولمصطفى لطفي المنفلوطي، ولأشعار عبد الرحمن شكري، ونقده لأحمد شوقي، ويقال أن شوقي يقصد المازني ببيت الشعر الذي قاله:
"إذا ما نفقت ومات الحمار.. أبينك فرق وبين الحمار!".