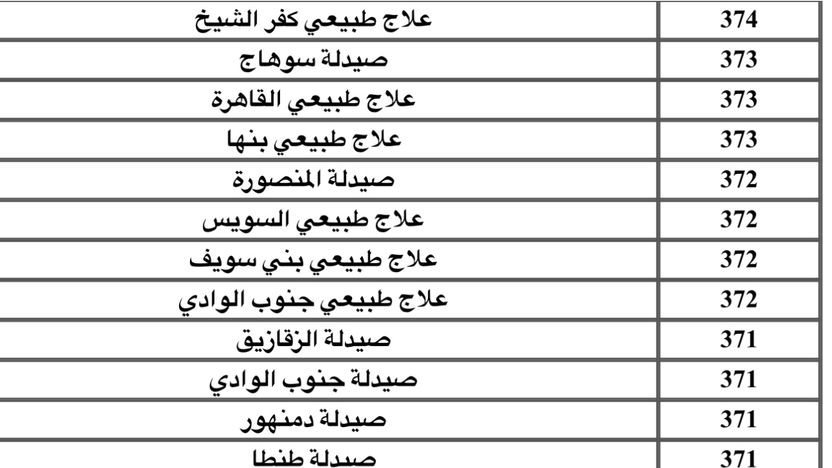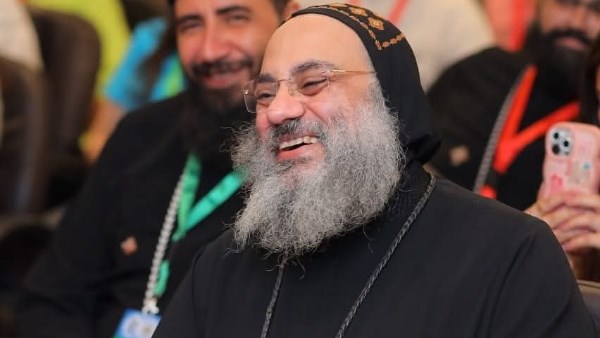القصة كالتالي: سيدة أربعينية حامل تعيش بمفردها في فيلا كبيرة.. زوجها محام نجاح سافر للصعيد في مهمة عمل، تقضي أغلب وقتها ما بين زيارة ابيها وقضاء بعض الوقت مع صديقتها ومتابعة حملها الخطِر عند الطبيب، في ليلةِ ما يقتحم لصان الفيلا لسرقة شيء واحد، ثم تحاول المسكينة الهرب منهما والنجاة بحياتها وطفلها، ولكن دون أي جدوى.
إنها المعالجة الدرامية أو الـPremise أو الثيمة أو الفكرة لفيلم "منى ذكى" الجديد.. "الصندوق الأسود" الذي طرح في السينما منذ شهرين، وعرضته شركة الإنتاج للجمهور على أحد خدمات البث الحي الترفيهي منذ أيام قليلة، وهو من إخراج "محمود كامل" وتأليف "هيثم مصطفى الدهان"، و"أحمد الدهان"، وبطولة "محمد فراج" و"مصطفى خاطر" و"شريف سلامة".
حين تشاهد تريلر الفيلم لأول مرة ستدرك أن القصة بسيطة تنتمي لنوع أطلقت عليه هوليوود قديمًا، أفلام الاقتحام المنزلي Home invasions، وهو نوع سينمائي منشق عن أفلام الرعب والتشويق، ظهر لأول مرة في الفيلم الأمريكي "الفيلا المهجورة" عام 1909 الذي أخرجه أحد الآباء المؤسسين للسينما الأمريكية وهو "ديفيد جريفيث"، ولم تشهد هذه النوعية من الأفلام انطلاقة حقيقة إلا على يد الراحل العظيم "ألفريد هيتشكوك" الذي وضع نظرية في التشويق سمّاها "نظرية القنبلة" Bomb Theory، ثم العملاق "ستانلي كوبريك" في تحفته "البرتقالة الآلية" إنتاج 1971، إلى أن أصبحت نوعية رائجة للغاية في الألفية الثالثة بعدما أخرج "ديفيد فينشر" فيلم "غرفة الهلع" من بطولة "جودي فوستر".
عندما نشاهد "الصندوق الأسود" سندرك تمامًا مدى تشابه ثيماته الرئيسية مع "غرفة الهلع"، لكننا لن نصل إلى حد السذاجة للقول إن الفيلم منسوخ منه، بيد أنه وبعيدًا عن أن إشكالية النسخ والاقتباس في الفن عمومًا هي في حد ذاتها أمر يثير الرثاء والاستهجان، نظرًا لسذاجة الأسطورة التي تحمل تراث أفلاطوني وتقول بوجود "أفكار فنية أصيلة" تتباين وتحلق في "عالم مطلق من المثل" بشكل قبلي يسبق أي صورة للفكر، وما على المبدع إلا أن يقتنصها ويدمجها في الوسيط الفني.
معظم أفلام الاقتحام المنزلي تتشابه وبعضها بشكل ما أو بآخر، يمكنك مثلًا أن تجد تماثلًا بين "الصندوق الأسود" و"لصوص لكن ظرفاء" من حيث البنية الأساسية للعمل، وهو فيلم أصلًا اقتبسه إبراهيم لطفي" من الفيلم البريطاني "قاتلوا السيدة".
وبعيدًا عن ذلك، تخيل لو أن مثلا "لطفي" اقتبس الفيلم بدون أي رؤية إبداعية، بدون إعادة إنتاج للصورة، بدون ما قصد "رولان بارت" حينما قال إن فعل الكتابة أو الإبداع هو "محاكاة ضائعة" لا تتوقف عن العودة إلى الوراء، فالمؤلف/المبدع ينطوي على صفات "النساخ" لا يكف عن النسخ، لكنه مع كل فعل من أفعال هذا النسخ يعيد إنتاج المنسوخ في نصوص هي هي، في ذاتها شبكة من العلامات التي تومئ إلى علامات أخرى غيرها إلى ما لا نهاية.. أشبه بعود أبدي نيتشوي.
أين الرؤية الإبداعية في "الصندوق الأسود"؟ أين صوت المخرج وأين "لذة النص"-بتعبير "بارت"- التي رأى فيها "هانز جورج جادمير" ذات مرة أنها تجليًا للجميل في "العالم الذي ينفتح عليه العمل الفني"؟
في كتابه "اتجاهات الإبداع"، يقول المخضرم "سعيد شيمي" إن ثقافة الصورة اغتصبت وقتنا وفكرنا، وكأنها تقول لنا: أنا ثقافة القرن الحالي، موجهًا باقي حديثه لكل صانع صورة-سينمائية-في مصر، سواء أكان مؤلفًا أو مخرجًا أو مصورًا أو مونتيرا. قائلًا إن الخيال الرحب المفتوح "أصبح محددًا حدود ما يعرضه صانعوه شكلًا وموضوعًا. وهذا مكمن الخطر".
المخيب للآمال في "الصندوق الأسود" أنه بلا هذا الـ"صوت".. وهي مشكلته الرئيسية التي تنبثق منها جميع مشكلاته الأخرى.. لا شيء جديد.. القصة معادة ومتوقعة.. تمثيل هستيري مفتعل من "فراج" بالتحديد، لا منطق درامي.. الشخوص رمادية.. الحوارات باهتة.. الموسيقى ملحمية لأحداث عادية،.. لا يوجد أي حكي للقصة عبر الصورة، من مونتاج أو إضاءة أو هندسة كادرات، ما نشاهده على الشاشة هو مجرد أحداث متعاقبة تحدث في فضاء القصة الزمكاني، الكاميرا هنا مجرد مراقب سلبي، يرقب الأحداث وينقلها لنا بموضوعية مطلقة.
هذا الأمر جعل الحوارات في الفيلم تُنطق بشكل آلي وفي قوالب كليشيهية، فمثلًا عندما اقتحم "سيد" و"هادي" الفيلا، نجدهم قد توقفوا لوهلة ثم شرعا يتحاوران عن الأسباب التي جعلتهم يسرقون المحامي أو حينما يحاول "سيد" اغتصاب "ياسمين"، أو مشهد النهاية كله، كلها حوارت تعتمد على تكنيك قصصي سردي شهير ويعرف باسم "شرح" Exposition، لكنه يأتي في أسوأ صوره حينما يكون بشكل تلقيني، كأن الممثلين يشرحون للمتفرجين دوافعهم، هذا ناهيك عن أن الحوارات نفسها خرجت من أفواه قائليها باهتة لا تخدم أي غرضًا إلا لمجرد أن تُقال، أو أن تشغل فراغات الزمن القصصي، فلا يمكن تصور شخوص يقولون كلام كالذي قيل في الفيلم على لسان أبطاله، لو وضعوا في ظروفٍ مماثلة.
هل يمكن تبرير كل ذلك أو غض الطرف عنه؟ لا. فإنتاج أفلام اليوم الواحد أو اللوكشين الواحد، لا يكلف كثيرًا، رغم أنه يضع صانعيها في تحدٍ كبير يكمن في شيءٍ واحد: الرؤية الإبداعية.
"سينما البابا" أو Papas Kino كما أطلق عليها مخرجون ألمان شباب عام 1962 حينما ثاروا على السينما الرديئة ببيان شهير بعنوان "مانفيستو أوبراهاوزن"، معلنين بذلك ولادة الموجة السينمائية الألمانية الجديدة.. فكان شعارهم آنذاك "لقد ماتت سينما البابا" Papas Kino ist tot
يصف الفيلسوف الألماني الفطحل وأحد كباري منظري مدرسة فرانكفورت، "ثيودور آدورنو"، هذا النوع من السينما بأنها "مراهقة" و"هجينة" و"هاوية" "ولا تتيقن نتائجها".