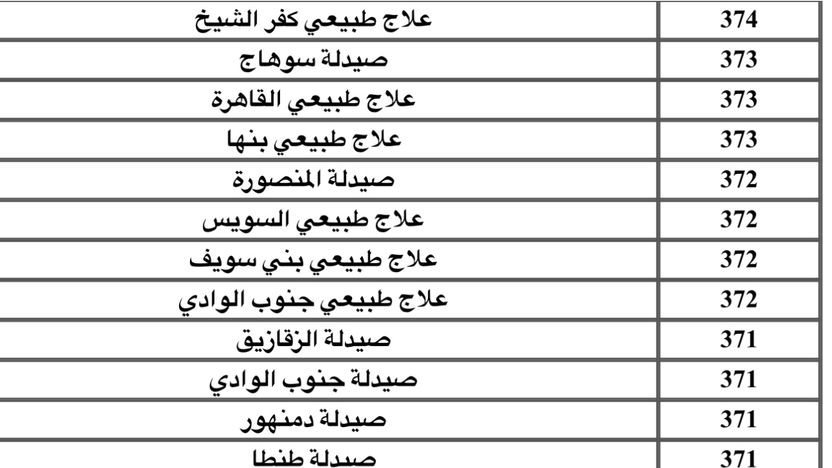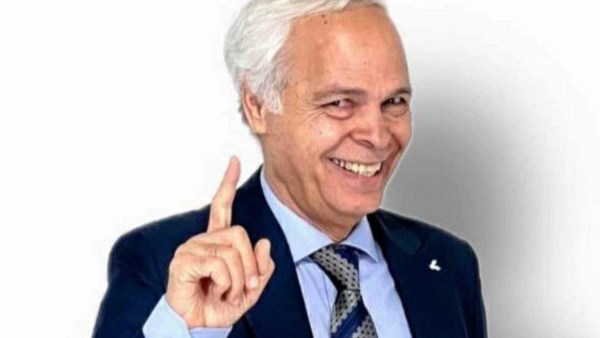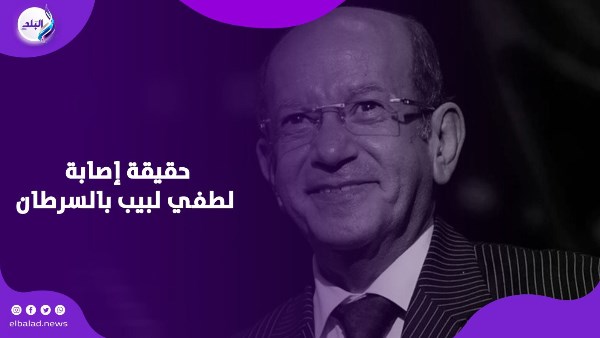* القاهرة
وبغداد وقع عليهما عبء توحيد العرب في مختلف العصور
* التحالف بين مصر والعراق يمثل درعا ضد أي قوى تحاول
السيطرة على المنطقة
* توفر عوامل التعاون الاقتصادي وملامح سياسية مشتركة بل
وحدة في التاريخ والمصير
* نمو العلاقات بين شعبي مصر والعراق عملية حتمية
وضرورية لما يربط بينهما من مصير مشترك وروابط تاريخية ودينية وعرقية
سلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رسالة للرئيس عبد
الفتاح السيسي موجهة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الرئيس عبد
الفتاح السيسي بالقاهرة، قبيل انعقاد القمة الثلاثية على المستوى الوزاري المقرر
انعقادها غدا في العاصمة المصرية.
وبحث وزير الخارجية العراقي، مع الرئيس السيسي العلاقات
الثنائيّة بين البلدين، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما
بحث موضوعات القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من
العام المقبل.
وعرض وزير الخارجية العراقي أهم موضوعات القمّة
الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غدًا في القاهرة.
ووصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين العاصمة المصريّة القاهرة
مساء أمس، وسيعقد اجتماعًا مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ
غدا الثلاثاء، لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في
اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في أغسطس الماضي.
كما سيلتقي المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة
العراقيّة-المصريّة في بغداد قريبًا، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة
الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.
علاقات تاريخية ممتدة
لم تكن العلاقات المصرية العراقية وليدة التاريخ الحديث
والمعاصر وإنما كانت موجودة في التاريخ القديم والوسيط، والتنافس بين القاهرة
وبغداد قد سبقه بزمن طويل تنافس حضاري بين العراق البابلي والسومري والآشوري وبين
مصر الفرعونية.
ولا ترجع أهمية العلاقات بين البلدين إلى كونها فقط
نموذجًا للعلاقات بين كيانين عربيين، وإنما تتمثل أهميتها في أنها تكشف مجمل
العوامل التي شكلت ملامح العلاقة بين مصر والعراق ومن ثم انعكاسها على المنطقة
العربية باعتبارهما أكبر دولتين عربيتين في المنطقة حينذاك والذي كان من المفروض
أن يقع عليهم عبء جمع ووحدة العرب.
وأدى وقوع مصر والعراق ضمن وحدة سياسية وجغرافية واحدة
ألا وهي منطقة الشرق الأوسط، بأن لازم هذا الرباط المكاني، رباط زماني جعل الأحداث
بين القطرين تتصل وتتشابه وتختلط مما خلق معه خطوطا تاريخية عامة متشابهة بينهما
ومن ثم كانت هناك علاقة تأثر وتأثير متبادل بين البلدين.
ونظرًا لتكامل موقع مصر والعراق الجغرافي والاستراتيجي
الذي فرض عليهم تحمل عبء الدفاع عن المنطقة وتأثير العلاقة بينهما على قوة الأمة
العربية من ناحية، ولخطورة تلاحمهما على أي قوى خارجية تهدف للسيطرة على المنطقة
من ناحية أخرى، لذلك كان من أولويات استراتيجية القوى الخارجية إخضاعهما لحكومة
واحدة وإحكام العزلة والتباعد بينهما وتعميق الاختلاف والتباين بين الاتجاهات
القومية للبلدين، ففقدان التلاحم بينهما صمام الأمان الرئيسي لأي قوى خارجية، فتوالت
عليهما حكومات أجنبية يونانية ورومانية وبعدها اندرجا تحت حكومة واحدة في ظل
الكيان الإسلامي العربي ويليه العثماني وأخيرًا السيطرة البريطانية، إذ كانا
يمثلان للأخيرة حلقة متصلة لحماية مصالحها في الهند وهذا يفسر إلى أي مدى لعبت
بريطانيا دورًا كبيرًا في وأد أي عمل عربي مشترك سواء كان سياسيًا أم عسكريًا، وبالتالي
كانت بينهما ملامح سياسية مشتركة بل وحدة في التاريخ والمصير، ورغم ذلك لم يكن
بينهما على المستوى الرسمي وحدة في الهدف للتصدي لمواجهة الخطر المشترك لانشغالهما
في المنافسة على الزعامة العربية.
استلهام الثورات المصرية
، كان لثورة 1919 المصرية تأثير غير مباشر على ثورة
العشرين العراقية، كما تمثل بداية التقارب بين الحركة الوطنية في مصر ومثيلاتها في
العراق، برغم ما فرضته بريطانيا من ستار حديدي على العلاقة بين البلدين، لأن
القضية التحريرية أقوى من الحصار والفصل بينهما، فنمو العلاقات بين شعبي مصر
والعراق عملية حتمية وضرورية لما يربط بينهما من مصير مشترك وروابط تاريخية ودينية
وعرقية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن مصر بثقلها وتأثيرها السياسي والثقافي
جعلها تلعب دور النموذج السياسي والوطني أثناء العشرينيات وحتى بعد الحرب العالمية
الثانية، فتطلعت إليها القوى الوطنية في العراق وغيرها من الأقطار العربية، تحدد
سياستها تبعًا لها، فقد كانت بحق المرجع السياسي في المشرق العربي حيث كانوا يرون
فيها قدوة سياسية لأمم الشرق كما صارت الوفدية وطنية عربية، ومن ثم نلاحظ خلال
الفترة محل البحث «1922 - 1952» أن للضغط الشعبي في العراق على حكومته دورًا
كبيرًا في تنمية العلاقات بين البلدين.
وقد يبدو ظاهريًا أن تشابه النظام السياسي الملكي
الدستوري فيهما قد يسهل الطريق إلى التقارب والتعاون بينهما ولكن هذا التشابه جاء
لصالح بريطانيا ليسهل عليها جمع خيوط الإدارة بهما في يدها بإشرافها على إدارة الشؤون
الخارجية والعسكرية من خلال ممثلها لديهما، لذلك سنلاحظ مدى الارتباط والتشابه بين
مصر والعراق خاصة فيما يتعلق بتسوية العلاقات مع بريطانيا، تلك السياسة الثابتة
التي اتبعتها الأخيرة لتحديد الصلات المستقبلية بهما مع اختلاف مصالحها في كل
منهما على حدة، إذ جعلت من العراق قاعدة حربية تهدد بها من تشاء من الدول المجاورة
وما وراءها، مما يؤثر حتمًا على اتصال وعلاقة العراق بجيرانه من الدول العربية
المحيطة، وبالتالي فإن سياسة بناء الجسور بين مصر والعراق في إطار تلك المعاهدات مع
بريطانيا، كان مقضيًا عليها بالفشل ما دام الإنجليز ضالعين في تلك السياسة
ويساعدهم ويتعاون معهم القائمون على حكم العراق.
ونتيجة لسياسة بريطانيا التقليدية التي دأبت على استخدام
العراق لتنفيذ السياسة البريطانية في المنطقة العربية، حيث ما لم تقبله مصر يأتي
العراق قابلاومرحبًا له، وقد مارست هذه السياسة فى معاهدة 1930، وبورتسموث 1948، ومشروع الدفاع عن الشرق الأوسط 1951، أدى ذلك إلى إحجام مصر حكومة وشعبا عن مشاركة العراق فى أية مشروعات سياسية أو دفاعية عن المنطقة العربية بل وتعبئة الرأى العام والرسمى العربى ضدها، للشك والريبة فى دوافع إقامتها بأنها تزيد من ربط مصر والمنطقة العربية بعجلة المصلحة البريطانية والقيام بدور التبعية مثل العراق، مما يتنافى ذلك مع مناهضة مصر لاستقلال سياستها الخارجية عن بريطانيا والتمسك بمبدأ الحياد وتجنيب البلاد ويلات الحرب.
ولم تكن الظروف الدولية العامل الوحيد المؤثر فى رسم ملامح العلاقة بين المملكتين المصرية والعراقية إذ كان لانتماءات السلطة الحاكمة فى كل منهما إلى مدرستين سياسيتين مختلفتين أثره المباشر فى تراوح العلاقة بينهما بين تقارب وتباعد، بل ويمكن القول فى الغالب كانت تصل إلى درجة التصادم فى سياستهما الخارجية، فالطبقة الحاكمة فى العراق كانت تنتمى إلى المدرسة السياسية العسكرية والواقعية التى تتمسك بالأهداف التى يعتقدون بإمكان تحقيقها وبالاختصار فهم يفضلون الواقع وغالبًا ما يتمتعون بمرونة أكثر ويطبقون سياسة خذ وطالب فى حين أن الطبقة الحاكمة فى مصر تنتمى إلى المدرسة السياسية المثالية والتى تميل نزعتها إلى تفضيل المثل العليا على الواقع والالتزام بأهداف قومية تعتبرها شبه مقدسة وبالتالى غير قابلة للتسويات أو الترضيات، ولعل أبرز مثل ينعكس عليه ذلك التصادم بين المدرستين السياسيتين فى كل من مصر والعراق، اختلاف موقفهما حيال مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط، حيث عدها القائمون على حكم مصر نوعًا من الاستعمار المقنع، بينما كانت السلطة الحاكمة فى العراق تعتبرها خير وسيلة للدفاع عن العرب ضد الشيوعية، وكان الخلاف الأساسى ينبع من مصدرين: الأول، أن مصر كانت تريد دفاعًا يحمى الشرق الأوسط من أى عدوان مهما كان مصدره، وكان العراق ومعه الغرب يريد دفاعًا ضد الشيوعية، والثانى أن مصر كانت تريد دفاعًا ينبثق من داخل المنطقة ويرتكز على شعوبها وكان العراق يريد دفاعًا من خارج المنطقة ويرتكز على الغرب، فمصر تؤمن بالحياد فى الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى والغربى ومحاربة الأحلاف العسكرية والاستعمارية والعراق كانت تؤمن بالتعاون مع الغرب وتهاجم سياسة الحياد على اعتبار أنها ضرب من الخيال، وأخيرًا حذا معظم الدول العربية حذو مصر مما كان من أسباب عدوان 1956 على مصر.
ودائما ما كان حل القضية المصرية هو مفتاح حل القضية العراقية فيما يتعلق بتحديد العلاقة المستقبلية مع بريطانيا ومن ثم فإن وساطة العراق لحلها كانت وساطة مزدوجة، يهدف الشطر الأول منها إلى حل المشكلة المصرية البريطانية، وأما الثانى فيهدف إلى تسوية المشكلة العراقية البريطانية، لأنه إذا استطاع تسوية المسألة المصرية البريطانية فإنه يقيم بذلك سابقة يمكن الاعتماد عليها فى حل القضية العراقية، إذ كانت مصر حجر عثرة فى سبيل حكام العراق الموالين للغرب لأنه كان بيدها مفتاح الموقف لوجود قاعدة قناة السويس على أرضها، إلى جانب زعامتها للجامعة العربية التى تؤثر بلا شك على أن تحذو الدول العربية فى سياستها حذو مصر، الأمر الذى يؤثر بلا شك على موقف حكومة العراق أمام شعبها الذى يعتبر القضية المصرية قضيته الوطنية وأعرب عن مساندة مصر وتضامنه معها فى كفاحها ضد العدو المشترك، لذلك أحبطت الحكومة المصرية والمعارضة العراقية محاولات حكومة نورى السعيد لحل المسألة المصرية على طريقته بالتحالف مع الغرب والذى كان ذلك الحل من وجهة نظره مدخلا لحل المسألة العراقية أيضًا مع بريطانيا، ويتضح من ذلك مدى التوافق والتقارب التام بين الحركة الوطنية فى البلدين إلا أن هذا التقارب لم يكن على المستوى الرسمى بسبب عدم وجود نقطة التقاء بين الحكومتين فى سياستهما الخارجية تجاه الموقف بين الغرب وخاصة الأحلاف الغربية.
ومن العوامل التى تحكمت فى العلاقات المصرية العراقية، موقف رؤساء وزارات العراق واختلاف اتجاهاتهم ما بين مؤيد لمصر راغب فى التعاون معها كـ"مزاحم الباجة جى" و"على جودت الأيوبى"، وبين معاد وراغب فى النزاع ك ـنورى السعيد.
واتخذ العراقيون من ثورة 23 يوليو 1952 كدليل لانتفاضتهم ضد العرش فى أوائل نوفمبرعام 1952 أى بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من وقوع الثورة فى مصر وكان هذا على المدى القريب، إذ لقنت الثورة المصرية الأحزاب العراقية فكرًا ثوريًا، فكانت الملهم لثورة 1958 على المدى البعيد، بمكوناتها الثلاثة السخط واليأس والأمل، والتى دكت قواعد الملكية والإقطاع إذ كانت أزمة النظام الملكى المصرى جزءًا لا يتجزأ من أزمة النظام الحاكم فى العراق.
ورغم أن المشاريع الوحدوية الجزئية التى كانت تطرحها العراق لم تكن تشمل مصر إلا أن العراق كان حريصًا على إطلاعها عليها شارحًا خطته، مما يعكس إحساس العراق بأهمية موافقة مصر أو على الأقل ضمان عدم معارضتها لمشاريعه باعتبار أن الدائرة العربية محور اهتمام مشترك بينهما لضرورتها الاستراتيجية، هذا إلى جانب المركز الذى اكتسبته مصر بين الدول الشرقية والإسلامية بحكم موقعها ومكانتها التاريخية وزعامتها الفكرية والروحية للعالم العربى تلك المقومات التى جعلتها أكثر خطورة وأهمية من بعض الدول التى قد تشترك فى تلك المشاريع، ولكن نتيجة للتنافس الأسرى بين الأسرتين العلوية فى مصر والهاشمية فى العراق على الزعامة العربية ترتب على ذلك رفض مصر لمشروعات العراق الوحدوية الجزئية، ووضع الملك فؤاد الأول برنامجًا سياسيًا واسع النطاق، استمر العمل به فى عهد الملك فاروق والتى التزمت به حكومات الأغلبية والأقلية باعتباره مشروعًا قوميًا، يجعل من مصر ليست فقط زعيمة للعالم العربى بل للشرق الإسلامى بأكمله، بوضع سياسة ثقافية واقتصادية لاحتواء العراق والانطلاق منها إلى الشرق الإسلامى، هذا إلى جانب احتضان مصر لقضايا استقلال سوريا ولبنان والمحافظة على النظام الجمهورى بهما.
ولما كانت العراق تعتبر منذ القدم القوة الثانية بعد مصر فى المنطقة العربية، وكانت العلاقات بينهما تتسم بالتنافس منذ أن كانا يمثلان المحورين الأساسيين فى الممر التجارى فى الشرق الأوسط، فقد ظلت تلك السمة تسيطر على العلاقات بينهما حتى بعد أن أصبح لكل منهما كيان سياسى شبه مستقل تحت النفوذ البريطانى، لمزاحمتهما لبعضهما البعض على زعامة الشرق العربى وذلك من خلال طرحهما لعدة مشاريع سياسية يمكن أن تحقق لهم ذلك، بداية من تبنى مصر الدعوة لفكرة إحياء الخلافة مما يكسبها مركزًا روحانيًا وسياسيًا وربـط الـدول العـربية والشرقية برباط دينـى الأمر الذىرأى فيه العراق تأكيدًا على زعامة مصر على البلاد الإسلامية بما فيها العراق، فرد العراق على ذلك بأنه تعمد الاتصال بالقوى السياسية المناهضة بالداخل لعودة فكرة الخلافة كفكرة سياسية على يد الملك فؤاد، ثم نجاح الوفد العراقى الممثل فى مؤتمر الخلافة (1926) - وبتأييد من الوفود المشاركة - فى تغيير وجه المؤتمر من البيعة لفؤاد كخليفة للمسلمين إلى اقتصار مهمته على مباحث فقهية متصلة بالخلافة والخليفة، باعتبار أن هيئة المؤتمر ليست من شأنها معالجة تلك المسألة التى تعد من اختصاص السياسيين فى الدول الإسلامية، وأخيرًا تبنى العراق فكرة إقامة رابطة عربية على أساس قومى وليس دينى.
ولم يختلف موقف العراق الرافض لإحياء فكرة الخلافة الإسلامية على يد الملك فاروق عام 1938 عما كان عليه عام 1926، لأنه سيتيح لمصر أن تلعب دورًا عظيمًا بالاتجاه إلى الشرق العربى وهكذا يمكنها أن تمارس نفوذًا له وزنه فى آسيا، مما أسهم فى إخراج مصر من دائرة اهتماماتها الإسلامية إلى دائرة اهتماماتها العربية ذلك الاهتمام الذى غلب عليه بالدرجة الأولى الشعور القومى المصرى أكثر من الشعور القومى العربى، بعد أن فهم الملك فاروق أنه يسبح ضد تيار الزمن بأن يعيد إلى الحياة نظامًا إسلاميًا بطل العمل به، ومع ذلك فلقد بقى حلم وحيد، أقل طموحًا، لكنه لا يخلو من تحقيق هدفه وهو أن يكون على رأس العالم العربى مما يزيد من قوة مصر ومكانتها ونفوذها، ليدخل فاروق بمصر فى حرب باردة مع العراق لتنافسهما على زعامة تلك المنطقة التى تعد المجال الحيوى له، وبالتالى سيحول ذلك دون إقامة المملكة العربية التى كانت تراود أحلام الهاشميين فى العراق.
وعندما طرح العراق مشروع تكبير كيانه السياسى فى شكل الهلال الخصيب الذى تعمد تجاهل مستقبل مصر السياسى والاقتصادى ونقل مركز الثقل فى المنطقة العربية من القاهرة إلى بغداد؛ وبالتالى يتحقق للعراق الترجيح السياسى والجغرافى على مصر وعزلها عن المجموعة العربية وإلقائها فى قوقعة إفريقيا وربط مقدرات دول الهلال الخصيب بعجلة المصالح البريطانية، عندئذ تبنت مصر مشروع إنشاء جامعة الدول العربية على أساس احتفاظ كل دولة بسيادتها واستقلالها، وتبع ذلك ظهور معالم محورين سياسيين فى الوطن العربى: محور القاهرة - دمشق - الرياض، ومحور بغداد - عمان، حتى يُضطر الأردن والعراق، الدولتان الهاشميتان إلى مسايرة الغالبية الأخرى من دول الجامعة العربية، فتسير مضطرة فى الخط السياسى العربى المستقل، ولعل هذا يفـسر لنـا أنـه مـنذ بـدأت مـباحـثات الجـامـعة بدأ التنافس على زعامة العالم العربى بين الأسرتين الهاشمية فى العراق والعلوية فى مصر، واستمر المحوران يلعبان دورًا مهمًا فى تطور الأحداث فى المنطقة العربية لسنوات عديدة التى لم تؤد إلى نتائج إيجابية لصالح الأمة العربية.
وإذا كان العراق قد أخذ بزمام المبادرة على المستوى الرسمى فى أعقاب تصريح إيدن الأول فى 29 مايو 1941، بدعوة مصر لتعزيز الروابط السياسية بينهما والتى انتهت إلى الاتفاق باتباع سياسة التدرج فى العمل السياسى المشترك والذى يبدأ أولا بالعمل الثقافى باعتباره حجر الزاوية الذى تقوم عليه أى رابطة ووحدة ثم يتبعه العمل الاقتصادى قبل الدخول فى الناحية السياسية، إلا أنه على المستوى الشعبى فقد بادرت مصر بدعوة العراق لتؤسس بها فرعًا لـــ نادى الاتحاد العربي فى القاهرة والذى تم انشاؤه فى 25مايو 1942، وكان هدفه تنمية العلاقات وتقوية الروابط دون أن تصل الروابط بينهما إلى اتحادهما تحت حكم سياسى واحد وإنما تبقى كل أمة مستقلة قائمة بذاتها، والتى لم تكن أول حركة شعبية وتجمع عربى يشارك فيه الشعبان المصرى والعراقى معًا لتعزيز الروابط بينهما وتحقيق الفكرة العربية، كما يعد تجاوبًا بين شعبى مصر والعراق للمصير والخطر المشترك، الأمر الذى يؤكد بوضوح وحدة موقف مصر الرسمى والشعبى تجاه مسألة الاتحاد السياسى الذى كانت تنادى به العراق فى ظل العرش الهاشمى، وفى أعقاب التصريح الثانى لإيدن فى 24 فبراير 1943، نشط العراق برئاسة نورى السعيد لإنشاء فروع للاتحاد العربى فى البلدان العربية تحقيقا لهدفه بعقد مؤتمر عربى تشارك فيه هيئات شعبية بالإضافة إلى الهيئات الرسمية لمواجهة التحرك الرسمى بقيادة النحاس باشا لقيادة مشاورات الوحدة العربية، غير أن الاتحاد العربى انكمش نشاطه مع قيام الجامعة العربية مع احتفاظة بكيانه.
ويرجع الفضل للوفد المصرى فى اقتراح المادة الثانية من الميثاق والتى تنص على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة وتتعهد بألا تقدم على أى عمل يرمى إلى تغيير النظام فيها والتى تعد تلك المادة سدًا أمام المشروعات الوحدوية الجزئية وخاصة العراقية، مما يعد نجاحًا للدبلوماسية المصرية، فى حين نجحت الدبلوماسية العراقية فى أن تجعل المقترحات العراقية بشأن طبيعة العلاقات العربية خارج نطاق الجامعة، جزءًا من الميثاق وذلك وفق ما جاء بالمادة (9) ضمانًا للتطلعات الهاشمية والتى نصت على أن دول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه فى الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذا التعاون.
لم يكن هناك اختلاف جذرى بين الموقف المصرى والعراقى حول خطورة قيام دولة يهودية فى فلسطين على الكيان العربى، وإنما كانت نـقـطـة الخـلاف بينهـمـا حـولسياسة المواجهة والإجراءات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الواجب اتخاذها تجاه الخطر الصهيونى المشترك، والدول التى تسانده لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، كما اختلفا أيضا ًحول مستقبل فلسطين الأمر الذى أثر بالتالى على فاعلية القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية مما أثر بالسلب على القضية الفلسطينية لافتقادها لوحدة الصف العربى فى معالجتها والتى ما زالت تواجهه حتى تلك اللحظة.
وأثر التنافس الأسرى بين مصر والعراق إلى حد كبير بالسلب على طرق المعالجة وبحث الوسائل العملية لإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية، نتيجة لموقف العراق من القيادة المصرية للجامعة العربية واعتبار أن أى دعم للجامعة من خلال الالتزام بقراراتها وتنفيذ مشروعاتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية سيؤدى فى نهاية الأمر إلى دعم النفوذ السياسى والأدبى لمصر فى المنطقة على حساب الكتلة الهاشمية، لأن العراقيين كانوا يؤمنون بأن الجامعة من عمل مصر، فإن أصابت نجاحًا لارتد هذا النجاح على مصر ورفع شأنها، لذلك حملت العراق لواء المعارضة على الجامعة فى حين كان عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية حاملا لواء الدفاع عن وجهة النظر المصرية ضد موقف العراق، لذلك اتخذت العراق من قضايا الدعاية وإنقاذ الأراضى والمقاطعة العربية الإسرائيلية كحلبات للصراع مع مصر لكسب الأنصار والدعاية للعراق، والنيل من مركز مصر ليس فقط فى فلسطين بل وفى العالم العربى ككل، الأمر الذى تصدت له السياسة المصرية بكل قوة.
وكان التنافس على زعامة العالم العربى بين الأسرتين الهاشمية فى العراق والأردن، والملكية فى مصر كان وراء هذا التقاعس عن نجدة الجيش المصرى فى الفالوجا، الذى ترك جرحًا لم يندمل، وبات من العسير مواصلة العلاقات بينهما دون تصفية هذا الموقف، كما أدى ذلك إلى تراجع الفكرة العربية فى مصر وبرزت الدعوة إلى التمسك بالقومية المصرية ووصل الأمر إلى مطالبة البعض الانسحاب من الجامعة العربية والتحلل من الالتزامات التى تضمنها ميثاق الجامعة العربية لأن مصر هى الوحيدة التى تخدم الفكرة العربية.
ولم تكن الجامعة العربية وحرب فلسطين هما فقط ميدان الصراع والتنافس على الزعامة العربية بين مصر والعراق ولكن كان هناك منطقة رئيسية أخرى وهى سوريا والدعوة إلى الاتحاد العراقى السورى، لذلك فإن الانقلابات العسكرية التى شهدتها سوريا كانت عاملا هامًا فى التباعد بين مصر والعراق، وإن كان العراق قد تخلى عن مشروع الهلال الخصيب وتوقف عن محاولات جر سوريا إلى الاتحاد معه إلا أن ذلك لم يكن إلا إقرارًا بالأمر الواقع، ويأتى ذلك فى إطار نجاح الدبلوماسية المصرية فى إحباط مخططات العراق والتى تبلورت فى تلك المحاور:
أ - احباط مناورات «نورى السعيد» خلال مشاورات الجامعة العربية( 43/ 1945) للحصول على اعتراف مصر بأولوية إنشاء مشروعى سوريا الكبرى والهلال الخصيب.
ب - العمل على تضمين ميثاق الجامعة العربية بنودًا تحول دون إقامة هذه المشروعات الجزئية.
ج - إقامة نظام الضمان الجماعى العربى، إذ إن مصر لا ترمى إلى تحقيقه للدفاع عن الدول العربية ضد إسرائيل أو أى عدوان أجنبى وإنما يكون دفاعى بين الدول العربية ضد تطلعات العراق إلى سوريا، لذلك إذا كان لتوقيع اتفاق الجنتلمان بين مصر والعراق بشأن سوريا يعد أول انتصار للدبلوماسية المصرية، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية هو المظهر الآخر لهذا الانتصار.
د - تنسيق الجهود مع السعودية التى كانت بدورها تعارض هذه المشروعات الهاشمية.
هـ - تطويق نتائج الانقلابات العسكرية فى سوريا، باستمالة حسنى الزعيم وتحريض القوى الوطنية على الإطاحة بـــ سامى الحناوى، وتحسين العلاقات مع أديب الششكلى.
و - دعم الحكم الوطنى فى سوريا وإحباط مشروع ناظم القدسى 1951.
ز - الاستجابة لمحاولات القوى القومية فى العراق لتنقية العلاقات وتسوية الخلافات بين مصر والعراق فعقدت اتفاقية الكرام مع "مزاحم الباجة جى" تلك الاتفاقية التى رفضها النظام الحاكم مما كشف حقيقة أهداف السياسة العراقية.
ونتيجة لتدخل الأمين العام لجامعة الدول العربية عزام باشا فى توجيهه السياسة فى سوريا لصالح المعسكر المصرى - السعودى، ظهر التنافس والصراع العلنى بين مصر والعراق، وبدأت اتهامات الساسة العراقيين لمصر والجامعة العربية ووصفوها بأنها صارت أداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية واستخدامها كعقبة فى طريق تحقيق طموح العراق فى سوريا ووصل الحال بالعراق إلى اتهام عزام باشا بأنه بمثابة موظف بوزارة الخارجية المصرية بدرجة سفير وأن الجامعة العربية شعبة من شعب الوزارة ثم انتقلت الحملة العراقية ضد مصر من نطاق التصريحات إلى الأفعال، بتقديمها مشروعا بتعديل الأنظمة الداخلية المتعلقة باختصاصات الأمين العام فى اللوائح الداخلية من أجل الحد من اختصاصاته ووضعها فى قالب إدارى أكثر منه سياسى، والتى تهدف إلى الحد من النفوذ المصرى الأمر الذى تصدت له مصر بقوة بتأييد من المحور الذى تتزعمه بالجامعة العربية.
دبلوماسية مصر الثقافية
وسبقت العلاقات الثقافية بين المملكتين المصرية والعراقية العلاقات السياسية فى تنمية العلاقات بين الشعبين، إذ كانت مصر على رأس قائمة المصادر الرئيسية لمد العراق بالخبرات العلمية والكوادر الإدارية والفنية فى شتى المجالات، الأمر الذى يمكن القول معه بأن مصر كان لها دور أساسى فى بناء العراق الحديث من حيث تأسيس وتعريب الثقافة والإدارة العراقية حيث كانت الواسطة الفكرية ودار التعريب بين أوربا والعراق.
كما سبقت مصر إلى اتخاذ علاقاتها الثقافية مع العراق وسيلة من وسائلها لاحتواء العراق فكريًا فى إطار مواجهة مشاريع الوحدة العربية للأسرة الهاشمية بالعراق فى الهلال الخصيب، وتدعيمًا لزعامة مصر على الشرق العربى والتى يمكن أن نطلق عليها دبلوماسية مصر الأدبية فى العراق، إذ تم إرساء قواعد سياسة ثقافية مصرية ثابتة، تمثلت فى تزويد العراق بالمدرسين والمدرسات وفتح أبواب التعليم العالى والأزهر أمام طلاب العراق ليتلقوا العلوم فى المعاهد المصرية مع المساهمة ماليًا فى تسهيل تحقيق هذين الأمرين خاصة وأن العراق كان يعانى حينذاك من ضعف الحركة العلمية واحتياجها إلى المال والمعلمين والمعلمات الذين يقومون بأعباء التعليم، لذلك سيلاحظ خلال الفترة محل الدراسة (1922 - 1952) أن العلاقات الثقافية المصرية العراقية كانت عرضة للتقلبات السياسية بينهما، ومن ثم تراوحها بين تقارب وتباعد.