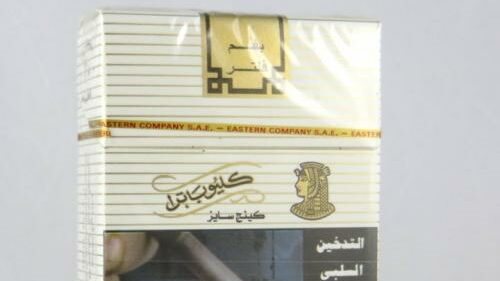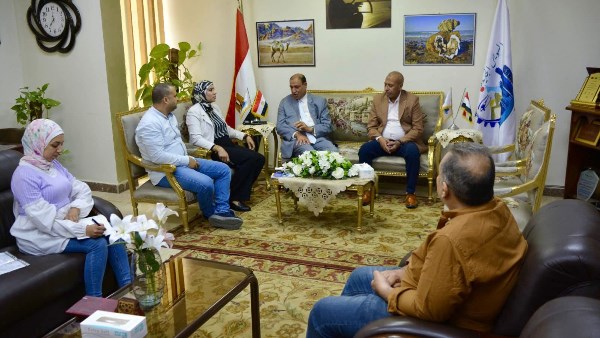تعرف على حقيقة محاسبة الإنسان على «حديث النفس»
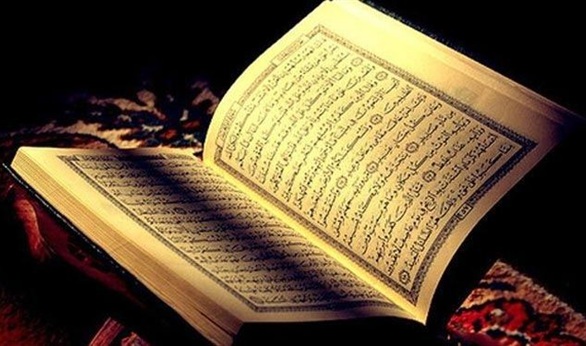
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّم»، رواه البخاري (2391)، ومسلم (127) .
قال النووي في كتابه المنهاج لشرح صحيح مسلم، أن المراد من قول سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي» أي عفا وغفر، مشيرا إلى أن المراد بالأمة هنا: هى أمة الإجابة وهم الذين استجابوا للدعوة فدخلوا في الإسلام.
وتابع: «فقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه (الفتح): والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس، حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك، وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من لفظ (ما لم يعمل) يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أو لم يتوطن».
وأضاف الإمام فى شرحه للحديث، أن قول النبى: « مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّم»، أى أن الله تعالى لايؤاخذ الإنسان على حديث النفس ما لم يعمل تلك المعصية أو يتكلم بها، مؤكدا أن حديث النفس لايعد كلاما لأن الكلام هو ما يسمع من المتكلم.
واستطرد: «أنه قد قال المازري: إن من عزم على المعصية بقلبه، وعزمت نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها، على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مرّ ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا هماً، ويفرق بين الهم والعزم، وهذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث».