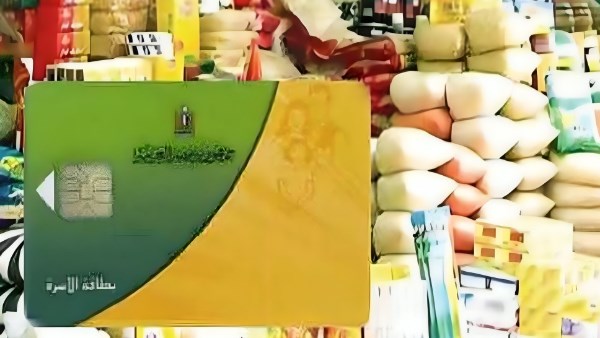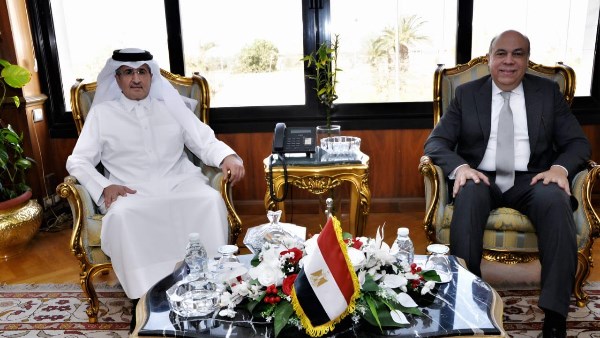مر على العالم الإسلامي نفحات ذكرى الإسراء والمعراج تلك الحادثة المباركة التي توجت بالصلوات الخمس إحدى المحاور العقدية التي تمس يقين المؤمنين، التي دفعت إلهاماتها الشيخ الشعراوي لنظم سيرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وهو لم يزل طالبا في المعهد الأزهري بطنطا متخذا من "الباكورة" عنوانا لها؛ فلنشتري خير بضاعة بذكر الهادي محمد ، ونستمع للشيخ الشعراوي وهو يقول في أبياته الشعرية ، مناجيا و مستعطفا:
يا ليلة المعراج و الإســـــراء :: وحــي الجــــــــــلال و فتنة الشـــعراء
الدهر أجمع أنت سر نــــــــواته :: و بمـــــــــــا أتـــــــــاك الله ذات رواء( )
فلك العلا دارت عليه شموســـــه :: والشمـس واحــــــــدة من الإنشــــــــاء( )
من ذا الذي يحظى بما استعصي:: علـــي موسي وعيسي صاحب الإحياء( )
لتكون هذه القصيدة آذنة بأن يطل الشيخ على سطح الحياة الشعرية والأدبية ، رغم أنه أبقى على نظمها الأول دون تعديل أو تغيير، لكي يعرف أهل التخصص أنه ولد عملاقا شاعرا، والمتأمل في القصيدة يجد أنها جاءت حاملة لرؤى تفسيرية لتقاطعات ملازمة للحادثة المباركة تتفق مع النتائج التفسيرية التي توصل إليها الشيخ في مرحلة نضجه الفكري و التفسيري، فضلا عن كونها تعتبر محاكاة واضحة لقصيدة "نهج البردة" التي نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي الذي تأثر به الشيخ أيما تأثر.
وعلى الرغم من ذلك لم تنل القصيدة حظها من الذيوع والانتشار على الساحة الأدبية، والغريب أنه قد لا يعرف الكثيرون من الناس أن الشيخ بدأ حياته الفكرية شاعرا ، الأمر الذي أثار انتباهي و أعمل فكري نحو البحث والتنقيب، فوجدت أن العلة كامنة في إخضاع القصيدة للدراسة النقدية تحت مجهر الثقافة الكتابية الإرث الذي نمى على إطلالة العديد من النماذج الأدبية والفنية، بيد أن المتتبع لتراث الشيخ الشعراوي التفسيري يجد أنه إنحاز إلى الخطاب الشفهي آلية دعوية تواصلية مع المتلقين، الأمر الذي يرجح ولادة القصيدة في المهد الشفهي لا الكتابي، وقد عضد هذا الاتجاه في الضمير إشكاليتان لا يمكن أن نغض الطرف عنهما:
الإشكالية الأولى : تفاوت مفهوم جمال الكلم وتباينه في آراء المؤصلين لعلم جمال الكلم العربي، وما دفعني إلى هذا الرأي ما جاء به علماء البلاغة العربية من اصطلاحات ومفاهيم بلاغية تشي بتطور المنظور البلاغي عبر الأزمان والسنين، علما بأن البلاغة العربية تتقارب في تعريفها العام مع التعريف الغربي كما عرف أرسطو لها – البلاغة - و بين غايتها الممثلة في الإقناع والإمتاع.
الأمر الذي لا يجد فيه الباحث غضاضة من إعلان التقعيد الشفهي آلية نقدية للنصوص المعايشة للظرفية المكانية و الزمنية في آن.
الإشكالية الثانية: إشكالية إخضاع النصوص الأدبية بعامة و الشعرية بخاصة لتقعيد علم البلاغة العربية التي استقيناها من علمائنا السالفين، أكانت هذه التعريفات خاصة بالنص الشفهي أم النص المكتوب ؟
علما بأن الإنتاج الشعري الذي خلفه لنا فحول الشعراء تنقل في أرحام الشفهية متفقا مع أطرها الزمنية والثقافية.
الأمر الذي جعلني أنظر إلى القصيدة باعتبارها قصيدة شفهية لها صفاتها ومميزاتها التي تميزها عن العمل الفني الذي ولد مكتوبا ، وإلا وضعنا هذه القصيدة تحت المقارنة غير المنصفة بل و الظالمة.
وإذا كان مقام المقال لا يتسع لذكر وتفنيد الأسباب والمبررات الدافعة إلى هذا الرأي، إلا أن الإشارة قد تكون لبيبة بالمراد:
- بدت جماليات القصيدة باعتبارها عمل فني عنى بأدب السيرة المختص بضوابط يجب أن نراعيها في الدراسة، حيث تنبثق بلاغة السيرة الذاتية في التصور من النقطة التي يتقاطع فيها (التخييل) و(التداول) مما يشي بأن السيرة الذاتية جنس سردي يجمع بين الواقع والمفترض. وهو ما يجعلها تنطوي على عناصر شعرية ترتبط بالإدهاش والتعجب على نحو ما تنطوي على عناصر الخبر الواقعي الصادق، الأمر الذي تعامل معه الشيخ ناظما بطاقة فكرية استطاع من خلالها تعين الجانب ( التداولي) من خلال استدعاء ما هو كائن في ضمير المسلم بما حاكاه من ألفاظ مقتبسة من النص القرآني المبارك و السنة النبوية المطهرة ؛ ليحيل من خلاله الإطناب النثري إلى نظم شعري دون إفراط أو تفريط.
- إن السيرة الذاتية تأرجح بين "التخييل" الروائي الفني ، و"التصديق" التاريخي؛ أي أنها واقعة في مركز التقاطع بين قطبي الإمتاع والإقناع، ومن ثم فإن الباحث في بلاغة هذا النوع السردي مدعو لأن يأخذ المكونين معا بعين الاعتبار.
و في هذا الجانب عمد الشيخ في توظيفه النظمي إلى الدلالة الهامشية للفظة الشعرية اعتمادا على اعتبارات عدة منها ما هو راجع إلى التراكم الثقافي للمتلقي، ومنها ما هو مرتبط بعقائده الدينية و الاجتماعية إلى غير ذلك من عوامل تؤثر في الثقافة المتراكمة في ذهن المتلقيي المحركة للأنثربولوجيا الجماعية ، وهو ما يمكن أن نشير إليه اصطلاحا من خلال " التناسق اللفظي" ، و التي تعد آليات شفهية تواصلية مع المتلقي لا يتسع المقام لتفنيدها.
- كما نود الإشارة في هذا المقام إلي دقة الشاعر في نقل الأحداث إلى صور مشاهدة للمتلقي، و التي ظهرت جلية ما بين التشخيص، والتجسيد تارة من خلال الألفاظ المستعملة في القصيدة كـــ ( يالليلة ، قصي) ، فالإحالة اللفظية المحيلة إلى التشخيص جعلت الأحداث الفائتة من السيرة النبوية المطهرة مصورة للمتلقي كما جسدتها الليلة الكريمة حيث قامت بدور الراوية للحكاية ؛ ليتجلى لنا أشكال التشويق والإثارة في هذا العمل الفني الذي يأتي بظلال (مضيئة أو مظلمة ، ساكنة أو مضطربة) وهذا ما جعل المتلقي أكثر تفاعلا مع نظم الشاعر ليصل إلى مرحلة الإقناع و الإمتاع بهذا العمل الفني.
و لعل هذا التفنيد الموجز ربما يكون كاشفا و لو بالقليل عن مكانة قصيدة الإسراء والمعراج " للشيخ الشعراوي التي ولدت في مهدها الأول شفهية ؛ الأمر الذي دفع الشيخ إلى عدم التعديل أو التغيير فيها ؛ للبقاء على جمالياتها التي ولدت بها ، لتكون جذوة التفكير التي تكشف عن دور الثقافة الشفهية في الفكر الآني والمستقبلي.