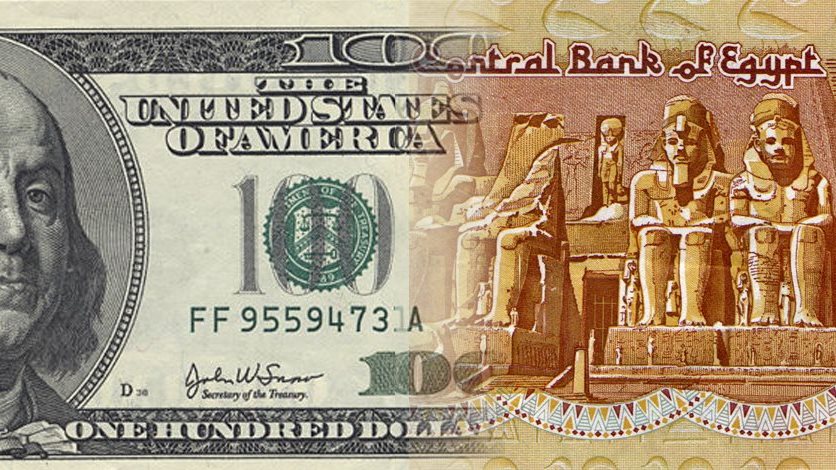رجال في قلب الحضارة الإسلامية..الشيخ محمد عبده إمام التنوير

يعد الإمام محمد عبده واحدًا من أبرز المجددين في الفقه الإسلامي في العصر الحديث، وأحد دعاة الإصلاح الحقيقي، وواحدًا من أعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة.
ساهم بعلمه ووعيه واجتهاده في تحرير العقل العربي من الجمود والركود الذي أصابه لقرون طويلة، كما شارك في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر، وبعث الوطنية، وإحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم، ومسايرة حركة المجتمع وتطوره في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية.
ولد الإمام محمد عبده في عام (1266 هـ - 1849 م) لأب تركماني الأصل، وأم مصرية تنتمي إلى قبيلة بني عدي العربية، ونشأ في قرية صغيرة من ريف مصر هي قرية محلة نصر بمحافظة البحيرة.
أرسله والده كسائر أبناء قريته إلى الكتاب، حيث تلقى دروسه الأولى على يد شيخ القرية، وعندما كبر الابن قليلاً أرسله أبوه إلى الجامع الأحمدي -وهو جامع السيد البدوي- بطنطا، لقربه من بلدته، وذلك من أجل أن يتعلم تجويد القرآن بعد أن حفظه، ويدرس شيئًا من علوم الفقه واللغة العربية.
وكان محمد عبده في نحو الخامسة عشرة من عمره، وقد استمر يتردد على الجامع الأحمدي لحوالي العام ونصف العام، إلا أنه لم يستطع أن يتجاوب مع المقررات الدراسية أو نظم الدراسة الجامدة التي كانت تعتمد على الكم وليس الكيف، وتفتقد الوضوح في العرض، فقرر أن يترك الدراسة ويتجه إلى الزراعة.. ولكن أباه أصر على تعليمه، فلما وجد من أبيه العزم على ما أراد وعدم التحول عما رسمه له، هرب إلى بلدة قريبة فيها بعض أخوال أبيه.
وهناك التقى الإمام محمد عبده بالشيخ الصوفي درويش خضر -خال أبيه- الذي كان له أكبر الأثر في تغيير مجرى حياته.
وكان الشيخ درويش متأثرًا بتعاليم السنوسية التي تتفق مع الوهابية في الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام الخالص في بساطته الأولى، وتنقيته مما شابه من بدع وخرافات.
واستطاع الشيخ درويش أن يعيد الثقة إلى محمد عبده في نفسه، بعد أن شرح له بأسلوب بسيط ما استعصى عليه من تلك العقول المغلقة، فاستطاع أن يزيل طلاسم وتعقيدات تلك المتون القديمة، وقربها إلى عقله بسهولة ويسر.
وعاد محمد عبده إلى الجامع الأحمدي، وقد أصبح أكثر ثقة بنفسه، وأكثر فهمًا للدروس التي يتلقاها هناك، بل لقد صار محمد عبده شيخًا ومعلمًا لزملائه يشرح لهم ما صعب عليهم قبل موعد شرح الأستاذ.
انتقل الإمام محمد عبده بعد ذلك من الجامع الأحمدي إلى الجامع الأزهر عام (1282 هـ - 1865 م)، فدرس الفقه والحديث والتفسير واللغة والنحو والبلاغة، وغير ذلك من العلوم الشرعية واللغوية.
وكانت الدراسة في الأزهر لا تخرج عن هذه العلوم في شيء، فلا تاريخ ولا جغرافيا ولا طبيعة ولا كيمياء ولا رياضيات، وغير ذلك من العلوم التي كانت توصف آنذاك بعلوم أهل الدنيا، ولذلك فَقَد شاب الدراسة في الأزهر كثير من التخلف والجمود.
واستمر محمد عبده يدرس في الأزهر اثني عشر عامًا، حتى نال شهادة العالمية سنة (1294 هـ - 1877 م).
بعدها بدأ رحلة كفاحه من أجل العلم والتنوير، فلم يكتف بالتدريس في الأزهر، وإنما درس في دار العلوم وفي مدرسة الألسن، وكانت دروسه في الأزهر في المنطق والفلسفة والتوحيد، وكان يدرس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون، كما ألف كتابًا في علم الاجتماع والعمران.
واتصل بعدد من الجرائد، فكان يكتب في جريدة الأهرام مقالات في الإصلاح الخلقي والاجتماعي، فكتب مقالاً في الكتابة والقلم، وآخر في المدبر الإنساني والمدبر العقلي والروحاني، وثالثًا في العلوم العقلية والدعوة إلى العلوم العصرية.
ووجد الإمام عبده شخصية رفيق الدرب في جمال الدين الأفغاني، الذي كان يفيض ذكاء وحيوية ونشاطًا، ورأى فيه الدنيا التي حجبتها عنه طبيعة الدراسة في الأزهر، ووجد الأفغاني فيه الذكاء وحسن الاستعداد، وعلو الهمة.
نادى الأمام عبده بتجديد مناهج التعليم بشكل عام، كما عني بالتجديد أيضًا في المجال الديني على وجه الخصوص، وقد دخل العديد من المعارك الفكرية في سبيل الدعوة إلى التجديد، لأنه في مواجهة الدعوة إلى التجديد هناك دعاة يدعون إلى الجمود والانغلاق.
وعاب على المسلمين عدم تقدمهم في مجال الصناعة الحربية وابتكار آلاتها، وأن غيرهم من الشعوب والتي كانت أقل منهم قد سبقتهم في هذا المضمار، مع أن المسلمين هم أولى الناس بالتقدم العلمي والصناعة الحربية، لأن أول آية نزلت من القرآن الكريم كانت دعوة للعلم والمعرفة والقراءة وحملت مفاتيح الحضارة الإسلامية، حيث قال الله تعالى في أولى آيات القرآن نزولاً «اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الانسان ما لم يعلم»..
وفي سبيل دعوة الإمام محمد عبده إلى التجديد نهض في دعوته على أسس قويمة، رأى أنها ضرورية للقيام بالتجديد، ومن هذه الأسس التخلي عن رذائل الجهل والتقليد والخرافات، والتحلي بالعلم واحترام العقل والتفكير، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، وأنه لا خصومة بين الدين والعلم والتجديد.
تأثر الشيخ محمد عبده بعدد من الرجال الذين أثروا في حياته، وكان من أولهم الشيخ درويش خضر الذي ساعده على تجاوز حدود العلوم التي درسها بالأزهر، ونبهه إلى ضرورة الأخذ من كل العلوم، بما فيها تلك العلوم التي رفضها الأزهر وضرب حولها سياجًا من المنع والتحريم.
كما تأثر بالشيخ حسن الطويل الذي كانت له معرفة بالرياضيات والفلسفة، وكان له اتصال بالسياسة، وعُرف بالشجاعة في القول بما يعتقد دون رياء أو مواربة.
وعندما اشتعلت الثورة العرابية عام (1299 هـ - 1882 م) التف حولها كثير من الوطنيين، وانضم إليهم الكثير من الأعيان وعلماء الأزهر، واجتمعت حولها جموع الشعب وطوائفه المختلفة، وامتزجت مطالب جنود الجيش بمطالب جموع الشعب والأعيان والعلماء، وانطلقت الصحف تشعل لهيب الثورة، وتثير الجموع، وكان «عبد الله النديم» من أكثر الخطباء تحريضًا على الثورة.
وبالرغم من أن الإمام محمد عبده لم يكن من المتحمسين للتغيير الثوري السريع فإنه انضم إلى المؤيدين للثورة، وأصبح واحدًا من قادتها وزعمائها، فتم القبض عليه، وأودع السجن ثلاثة أشهر، ثم حكم عليه بالنفي لمدة ثلاث سنوات.
وانتقل الإمام محمد عبده إلى بيروت عام (1300 هـ - 1883 م) حيث أقام بها نحو عام، ثم ما لبث أن دعاه أستاذه الأفغاني للسفر إليه في باريس حيث منفاه، فاستجاب محمد عبده لدعوة أستاذه على الفور حيث اشتركا معًا في إصدار مجلة «العروة الوثقى» التي صدرت من غرفة صغيرة متواضعة فوق سطح أحد منازل باريس، حيث كانت تلك الغرفة هي مقر التحرير وملتقى الأتباع والمؤيدين.
وقد أزعجت تلك المجلة قوى الاحتلال الإنجليزي في مصر، وأثارت مخاوفهم، كما أثارت هواجس الفرنسيين، وكان الإمام محمد عبده وأستاذه وعدد قليل من معاونيهم يحملون عبء تحرير المجلة، وكانت مقالات الإمام تتسم في هذه الفترة بالقوة، والدعوة إلى مناهضة الاستعمار، والتحرر من الاحتلال الأجنبي بكل صوره وأشكاله.. إلا أن الإنجليز تمكنوا من إخماد صوت «العروة الوثقى» الذي أقلق مسامعهم، فاحتجبت بعد أن صدر منها ثمانية عشر عددًا في ثمانية أشهر، وعاد الشيخ محمد عبده إلى بيروت بعد أن تهاوى كل شيء من حوله، فقد فشلت الثورة العرابية، وأغلقت جريدة «العروة الوثقى»، وابتعد عن أستاذه الذي رحل بدوره إلى فارس.
وبالرغم من أن مدة نفيه التي حكم عليه بها كانت ثلاث سنوات فإنه ظل في منفاه نحو ست سنين، فلم يكن يستطيع العودة إلى مصر بعد مشاركته في الثورة على الخديو توفيق، واتهامه له بالخيانة والعمالة، ولكن بعد محاولات كثيرة لعدد من رجال السياسة والزعماء، منهم: سعد زغلول، والأميرة نازلي، ومختار باشا، صدر العفو عن محمد عبده سنة (1306 هـ - 1889 م)، وآن له أن يعود إلى أرض الكنانة.
وأصبح في يد الإنجليز عند عودة الإمام محمد عبده إلى مصر، وكانت أهم أهدافه تتركز في إصلاح العقيدة، والعمل على إصلاح المؤسسات الإسلامية كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية. واتخذ محمد عبده قراره بمسالمة الخديو، وذلك حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الإصلاحي الذي يطمح إلى تحقيقه، والاستعانة بالإنجليز أنفسهم إذا اقتضى الأمر، فوضع تقريرًا بعد عودته حول الإصلاحات التي يراها ضرورية للنهوض بالتعليم، ورفعه إلى اللورد كرومر نفسه، فحقيقة الأمر التي لا جدال فيها أنه كان القوة الفاعلة والحاكم الحقيقي لمصر.
وكان الشيخ «محمد عبده» يأمل أن يكون ناظرًا لدار العلوم أو أستاذًا فيها بعد عودته إلى مصر، ولكن الخديو والإنجليز كان لهما رأي آخر، ولذلك فقد تم تعيينه قاضيًا أهليًا في محكمة بنها، ثم الزقازيق، ثم عابدين، ثم عين مستشارًا في محكمة الاستئناف.
بدأ الإمام محمد عبده بعد ذلك يتعلم اللغة الفرنسية وهو قاضٍ في عابدين -وكانت سنه حينئذ قد شارفت على الأربعين- حتى تمكن منها، فاطلع على القوانين الفرنسية وشروحها، وترجم كتابًا في التربية من الفرنسية إلى العربية.
وفي عام (1317 هـ - 1899 م) تم تعيينه مفتيًا للبلاد، ولكن علاقته بالخديو عباس كان يشوبها شيء من الفتور، الذي ظل يزداد على مر الأيام، خاصة بعدما اعترض على ما أراده الخديو من استبدال أرض من الأوقاف بأخرى له إلا إذا دفع الخديو للوقف عشرين ألف دينار فرقًا بين الصفقتين.
وتحول الموقف إلى عداء سافر من الخديو، فبدأت المؤامرات والدسائس تحاك ضد الإمام الجليل، وبدأت الصحف تشن هجومًا قاسيًا عليه لتحقيره والنيل منه، ولجأ خصومه إلى العديد من الطرق الرخيصة والأساليب المبتذلة لتجريحه وتشويه صورته أمام عامة الناس، حتى اضطر إلى تقديم استقالته من الأزهر في سنة (1323 هـ - 1905 م)، وبعد ذلك أحس الشيخ بالمرض، واشتدت عليه وطأة المرض، الذي تبين فيما بعد أنه السرطان، وما لبث أن توفي بالإسكندرية في 8 من جمادى الأولى (1323 هـ الموافق 11 من يوليو 1905 م) عن عمر بلغ ستة وخمسين عامًا.