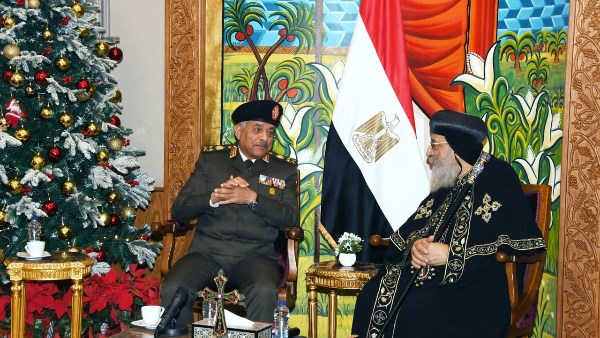قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام بمناسبة عيد الأم إنه عيد الأم الرابع الذى لا أجد فيه أمى بانتظاري، لأقبّل يديها ورأسها، وتشدنى إليها لتحتضننى. كانت تعرف بمجيئى قبل أن أطرق الباب، وكأن لها حاسة استشعار عن بعد، كانت تقول افتحوا الباب، لقد جاء علاء، ولم أكن أستغرب كيف كانت تميز صوت خطواتى على الأرض، فعندما كنا صغارا، كانت تميز ملابسنا رغم تشابهها فى اللون والمقاسات، ولم تخطئ مرة، وترتب ملابس كل واحد منا فى مكانه الخاص، ولا يفوتها أن تخيط ما تمزق، أو تعيد تثبيت «زرار» فى قميص أو بيجامة، بل كانت تعرف أين كنا وماذا فعلنا دون أن تسأل، وكنت أسأل نفسى من يشى بى لأمي، أم أن لها عيونا فى كل مكان؟ لكننى أدركت أن قلب الأم يرى عن بعد. حتى فى يوم رحيلها، وبينما كنت فى الوفد الإعلامى المسافر مع الرئيس، تلقيت وأنا فى المطار مكالمة بأن أمى فى المستشفى، وعرفت من صوت أخى أن حالتها متأخرة رغم تأكيده المتكرر أنها بخير، وغادرت الوفد مسرعا إلى الأقصر، وما إن شاهدتنى واحتضنتنى بعينيها، حتى صعدت روحها بعد دقائق، وكأنها كانت تنتظرنى لتودعني.
وأضاف ثابت فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بجريدة "الأهرام" : ولا أنسى أنها كانت ترسلنى بعيدا إلى سيدة عجوز كفيفة لأقدم لها وجباتها، وتوصينى بالحرص على ألا يرانى أحد، ولم أكن أدرك لماذا كل هذا المشوار اليومى والسري، وتقول لى هذا لخالتك فلانة، وبعدها خالتك فلانة، فتعاملت مع كل السيدات على أنهن خالاتي، وأن قرابة تجمعنا، حتى أصدقائى من المسيحيين كنت أعتبرهم أولاد خالاتى كما كانت تسميهم أمي، ولا تعترض على أن أذهب معهم للفسحة فى أعيادهم أو حتى إلى الكنيسة، فقد كانت تزورهم وتهنئهم فى الأعياد وتشاركهم الأفراح والأحزان، هكذا كانت الأقصر وجميع مدن الصعيد، أما جماعات التكفير فلا تمت بصلة لهذه الروح الإنسانية الرحبة، التى لا تعرف الضغينة، ولا تفرق بين الناس إلا على أساس طيبتهم وأخلاقهم وسلوكهم. كانت أمى تقلق من هؤلاء المدعين القساة، وتحذرنا من الحديث معهم، وكأنهم أغراب خطيرون.
إلى نص المقال:
عيد الأم الرابع الذى لا أجد فيه أمى بانتظاري، لأقبّل يديها ورأسها، وتشدنى إليها لتحتضننى. كانت تعرف بمجيئى قبل أن أطرق الباب، وكأن لها حاسة استشعار عن بعد، كانت تقول افتحوا الباب، لقد جاء علاء، ولم أكن أستغرب كيف كانت تميز صوت خطواتى على الأرض، فعندما كنا صغارا، كانت تميز ملابسنا رغم تشابهها فى اللون والمقاسات، ولم تخطئ مرة، وترتب ملابس كل واحد منا فى مكانه الخاص، ولا يفوتها أن تخيط ما تمزق، أو تعيد تثبيت «زرار» فى قميص أو بيجامة، بل كانت تعرف أين كنا وماذا فعلنا دون أن تسأل، وكنت أسأل نفسى من يشى بى لأمي، أم أن لها عيونا فى كل مكان؟ لكننى أدركت أن قلب الأم يرى عن بعد. حتى فى يوم رحيلها، وبينما كنت فى الوفد الإعلامى المسافر مع الرئيس، تلقيت وأنا فى المطار مكالمة بأن أمى فى المستشفى، وعرفت من صوت أخى أن حالتها متأخرة رغم تأكيده المتكرر أنها بخير، وغادرت الوفد مسرعا إلى الأقصر، وما إن شاهدتنى واحتضنتنى بعينيها، حتى صعدت روحها بعد دقائق، وكأنها كانت تنتظرنى لتودعني.
كانت تعمل كل شيء فى صمت وحب، تستيقظ مع طلوع الفجر، لتجهز الفطور الطازج، وكل الأطعمة الشهية مهما كانت بسيطة، فكانت ماهرة للغاية فى صنع كل شيء من الخبز الشمسى إلى أنواع المربات والمخللات، وكل شيء تقريبا تصنعه بنفسها للأسرة الكبيرة: وكل أنواع الخزين محفوظة بعناية لكى تكفينا شهورا طويلة، والطيور بكل أنواعها تربيها لنأكل من بيضها ولحومها، فهى سيدة مدبرة يمكن أن تجعلنا نأكل أشهى المأكولات بنكهة طعامها الشهي، وكان للجيران وللفقراء نصيب دائم من كل ما تطهوه، ولأنى كنت أصغر الأبناء، كانت ترسلنى بالطعام المغطى الطازج إلى جيراننا من المسيحيين والمسلمين، سواء فى الأعياد أو غيرها فلهم فيها نصيب.
ولا أنسى أنها كانت ترسلنى بعيدا إلى سيدة عجوز كفيفة لأقدم لها وجباتها، وتوصينى بالحرص على ألا يرانى أحد، ولم أكن أدرك لماذا كل هذا المشوار اليومى والسري، وتقول لى هذا لخالتك فلانة، وبعدها خالتك فلانة، فتعاملت مع كل السيدات على أنهن خالاتي، وأن قرابة تجمعنا، حتى أصدقائى من المسيحيين كنت أعتبرهم أولاد خالاتى كما كانت تسميهم أمي، ولا تعترض على أن أذهب معهم للفسحة فى أعيادهم أو حتى إلى الكنيسة، فقد كانت تزورهم وتهنئهم فى الأعياد وتشاركهم الأفراح والأحزان، هكذا كانت الأقصر وجميع مدن الصعيد، أما جماعات التكفير فلا تمت بصلة لهذه الروح الإنسانية الرحبة، التى لا تعرف الضغينة، ولا تفرق بين الناس إلا على أساس طيبتهم وأخلاقهم وسلوكهم. كانت أمى تقلق من هؤلاء المدعين القساة، وتحذرنا من الحديث معهم، وكأنهم أغراب خطيرون.
تعلمت الكثير من الدروس من هذا النموذج للمرأة الصعيدية الأصيلة الرقيقة القلب والصلبة فى الوقت نفسه التى لا تكف عن عمل كل ما هو مفيد، ولا تشكو ولا تغتاب، ولها كلمتها المسموعة فى كل الشئون، وإن كانت تقولها بنظرة تعبر عن عدم الرضا أو القلق، فكثيرا ما كان يشاورها أبى فى مختلف الشئون، وتستمع منه فى صمت، وتعليقاتها القصيرة تكتنز عصارة حكمة المرأة المصرية. هكذا كانت أمى محاسن أبوزيد ــ رحمها الله، وقد افتقدتها كثيرا عندما انتقلت من الأقصر لألتحق بالجامعة فى القاهرة، وعرفت كيف كان لطعامها نكهة لا تضاهى ولو فى أرقى المطاعم، وكيف كانت تطعم وترعى هذا العدد الكبير من الأبناء حتى تخرجوا فى الجامعات، وحققوا النجاح فى حياتهم، ولم يكن النجاح فى الدراسة والعمل هو كل ما يشغلها، فالأهم هو النجاح فى الحياة بالحب وتقدير الآخرين، فكانت تشعر كلا منا بأنه الأكثر تميزا، وأنه الأفضل، ويمكنه أن يحقق النجاح الباهر، فتمنحنا الثقة فى النفس، والاعتزاز والشعور بالكرامة وحب الخير للآخرين.
كنت أشعر بالفقد عندما تركت الأقصر، وأعد الأيام حتى أعود إلى بيتنا الذى ترفرف فيه روح أمي، للبيت رائحته الذكية من شدة النظافة، وللطعام لذته التى لا تضاهى، والأهم هو ذلك الحنان الذى لا ضفاف له، ويتسع للعالم كله، لهذا كانت الشهور بل السنوات الأولى قاسية وأنا فى القاهرة، بعيد مئات الكيلو مترات عن هذا البيت الدافئ والهادئ، كنت أشعر أنه أجمل بيوت العالم لأن فيه أمي.
وكلما كنت أشعر بالوحدة والفقد عند التحاقى بالجامعة كنت أجد مفاجأة تحلق بروحى إلى سماء الأقصر، ترسل لى أمى مع قريب أو جار بعضا من أطعمتها الشهية التى تعرف مدى حبى لها، ومع أن معظمها متوافر فى القاهرة إلا أن مذاق طعامها ورائحته ليس لهما مثيل سواء فى القاهرة أو أى مكان فى العالم، كنت أجد ما يؤكد أنها تشعر بي، وأنى لا أغادر قلبها وعقلها، فما ترسله من طعام وأشياء صغيرة تؤكد لى ذلك، وكانت تبعث برسالة فيها كل الحب والحنان والحث على عدم التنازل عن التفوق وأن أكون فى المقدمة دائمًا، وتدعو لى : «ربنا يحبب فيك خلقه»، وهى دعوة تلخص الإيمان والإنسانية وعبقرية التربية، فلا يحظى بحب خلق الله إلا من يحبه الله، ثم أجد مبلغا من المال إلى جانب المصروف الشهري، فكنت أشعر أن الأقصر كلها جاءت، وأنى أمضى أياما فى بيتي.
وتظل السعادة تغمرنى طويلا بهذه اللفتات التى تتكرر، والتى تؤكد لى أن الأم المصرية لها ملامح مميزة للغاية، وأنها معجونة بالحكمة والحب، ووريثة حضارة عريقة كانت فيها المرأة وستظل مصدر الخير والعطاء بلا حدود، وأنها أعظم البنائين، فهى تبنى وتنتج الأجيال، وتمنحهم اللقاحات الضرورية للحياة التى تحميهم وتجعل منهم رجالا، وهى تختلف تماما عن صورة المرأة ورؤية الجماعات التكفيرية لها، كما تختلف عن نموذج المرأة الأوروبية، فللأم المصرية سمات خاصة، وأندهش ممن يتحدثون عن المرأة المصرية وهم لم يعرفوها فى عمق الصعيد والدلتا، إنها النموذج الأكثر رقيا من كل تلك النماذج، وستظل أمى هى نموذج الأم المثالية، التى علمتنى كيف أحترم وأحب زوجتى وبناتى دون تفرقة، ودون قوانين، فالأعراف والتقاليد للمرأة المصرية الحقيقية تجاوزت كل تلك النماذج.
تحية لكل أم مصرية رعت أبناءها وجعلت منهم رجالا ونساء صالحين، وأنتجت الحياة والحب واحترام الآخر والتسامح والإنسانية، تحية لأمهات الشهداء وكل من فقدت فلذة كبدها وضحت به من أجل الوطن، وكل عام والأم المصرية بكل خير.