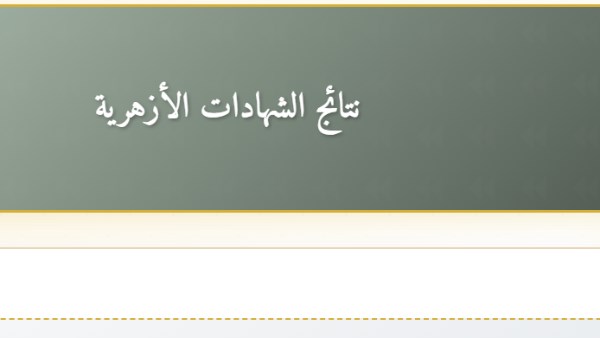منذ أواخر القرن التاسع عشر، سعت البعثات الأثرية اليهودية والغربية الموالية للمشروع الصهيوني للتنقيب في أرض فلسطين بهدف إثبات الروايات التوراتية التي تزعم ارتباط بني إسرائيل التاريخي والديني بالأرض المقدسة. لم تكن هذه التنقيبات مجرد عمل علمي محايد، بل جاءت تحت دافع أيديولوجي قوي لتثبيت ما سمي بـ"الحق التاريخي لليهود" في فلسطين، ليشكّل هذا الزعم لاحقاً ركيزة أساسية في تبرير المشروع الاستيطاني الصهيوني.
لكن بعد أكثر من قرن من الحفريات، لم تأتِ النتائج كما أُريد لها. فبدلاً من إثبات الروايات الدينية التوراتية، راحت نتائج التنقيبات تهز الثقة حتى لدى بعض علماء الآثار اليهود أنفسهم، بل ودفعت عدداً منهم لمراجعة شاملة للمقولات التي طالما بُنيت عليها الأسطورة الصهيونية.
فقاعات تاريخية
(سبعون عاماً من الحفر لم تكتشف مملكة، بل كشفت أكذوبة) بهذه الجملة يمكن تلخيص مأزق الرواية الصهيونية التي طالما ادعت أن فلسطين "أرض ميعاد"، وأن "المملكة العبرية الموحدة" لم تكن سوى فقاعة أسطورية انفجرت تحت ضوء العلم والمنطق؛ فمعاول الحفريات كانت أصدق من النصوص، وعندما حفرت في العمق دحضت الأكاذيب بدلا من إثباتها. لقد أُجريت مئات التنقيبات في القدس،
خصوصاً في منطقة "مدينة داود" المزعومة جنوب المسجد الأقصى، بحثاً عن آثار لهيكل سليمان أو قصر داود أو أسوار يهوذا. لكن تلك البعثات، ومنها بعثات إسرائيلية رسمية، لم تتمكن من العثور على أية أدلة قاطعة تثبت وجود "مملكة داود" بالضخامة التي تصورها الرواية التوراتية.
حتى عالمة الآثار الإسرائيلية "إيلات مزار"، التي روجت لاكتشافها "قصر داود"، تعرضت لانتقادات واسعة من زملائها الذين اعتبروا استنتاجاتها تفتقر إلى الحياد العلمي، وأنها اعتمدت التأويلات النصية أكثر من الأدلة المادية.
شكوك محلية وعالمية
لقد بدأت ثقة قطاع كبير من الأكاديميين الإسرائيليين أنفسهم تتزعزع. فمثلاً، "إسرائيل فنكلشتاين"، أحد أبرز علماء الآثار في جامعة تل أبيب، شارك في تأليف كتاب شهير بعنوان "التوراة المُجردة من الأسطورة " (The Bible Unearthed)، خلُص فيه إلى أن مملكتي داود وسليمان لم تكونا سوى كيانات محلية صغيرة، وأن الكثير من الروايات التوراتية كتبت بعد قرون من الأحداث التي تزعم توثيقها. فنكلشتاين قال بوضوح: " لا توجد أدلة أثرية حاسمة على خروج جماعي لبني إسرائيل من مصر، ولا على احتلال عسكري كاسح لأرض كنعان، كما تصف التوراة!".
لهذا السبب فإن المؤسسات الأكاديمية الغربية المعنية بالآثار القديمة، مثل المعاهد البريطانية والفرنسية والألمانية، باتت تتعامل مع الروايات التوراتية كمصادر أدبية لا تاريخية، مؤكدة على ضرورة التمييز بين النصوص المقدسة وبين الوقائع الأثرية، ويظهر هذا التحول في تغير لغة بعض المناهج الجامعية التي كانت تعتمد الرواية التوراتية كأساس للتاريخ القديم لفلسطين.
وعالم الآثار الإسرائيلي "زائيف هرتسوغ" لم يكن طامحاً للجدل أو للشهرة حين قال: "لا وجود لمملكة داود، ولا هجرة من مصر، ولا أثر للهيكل". لكنه كشف المستور: أن الأرض الفلسطينية لا تحتضن دليلاً واحداً يدعم الرواية التوراتية، وأن التاريخ المدون في الكتب المقدسة لا يجد صدى في الصخور أو تحت التراب الذي لا يعرف الكذب كمن يسيرون فوقه.
المزيج العقائدي السياسي
رغم هذا الانهيار في الثقة الأكاديمية محليا وعالميا، لا تزال المؤسسات الصهيونية والدينية المتشددة في إسرائيل تكرر الروايات التوراتية كأداة سياسية لتبرير السيطرة على الأرض، خصوصاً في القدس والضفة الغربية. ولذا، يتم تمويل بعثات أثرية بموازنات ضخمة ضمن ما يسمى "السياحة التوراتية"، رغم علم المسؤولين بأن نتائجها واهية أو مضللة.
يعترف عدد من علماء الآثار الآن في الداخل الإسرائيلي نفسه أن هناك توجهاً ممنهجاً لتسييس الآثار، ومحاولة "فرض الماضي" على الجغرافيا المعاصرة، حتى وإن لم تصمد الروايات أمام منهجية البحث العلم! لسان حالهم يقول: "لو كانت مملكة داود حقيقية، كما تزعم الرواية، لكانت القدس القديمة تضج اليوم بشواهدها وأدلتها". لكن الصمت الأثري كان مدوياً: لم يتم العثور على نقوش، ولا قصور، ولا حتى قبور تشير إلى وجود إمبراطورية عظيمة. بل جاءت المكتشفات لتعزز الحضور الكنعاني المتجذر، ولتكشف أن ما نُسب لداود، لا يعدو أن يكون إعادة تأويل لآثار تعود لحضارات سابقة أو لاحقة.
الحفريات فضحت رواياتهم
الحفريات أثبتت ما هو ضد مزاعمهم المسيّسة..
أن الأرض الفلسطينية عرفت حضارة متصلة، كنعانية الجذور، لم تعرف انقطاعات ولا غزواً عبرانياً شاملاً. لا انهيار مدن، ولا تغير في الطقوس، ولا تحول لغوي يدل على دخول ثقافة غريبة؛ فالحفريات في فلسطين أكدت استمرارية الحضارة الكنعانية، وعدم وجود أي قطيعة ثقافية أو ديموغرافية تشير إلى غزو عبري قديم: اللغة، العمارة، العادات الدينية – كلها كنعانية في جوهرها. حتى أن اسم "إسرائيل" نفسه ورد لأول مرة في نقش مصري (نقش مرنبتاح، 1208 ق.م) كاسم لقبيلة أو جماعة صغيرة، وليس لمملكة عظيمة!
تلك الحالة الجدلية أكدت الرواية الفلسطينية: أن الفلسطينيين هم أحفاد الكنعانيين وغيرهم من الشعوب القديمة التي سكنت الأرض، وهو ما أكدته الدراسات الجينية والثقافية. الأرض تتحدث باسمهم، حتى عندما يتم تزييف التاريخ!
إن الحفريات في فلسطين المحتلة لم تعثر على مملكة داود، لكنها كشفت شيئاً آخر: أن السياسة حين تتحالف مع الأسطورة، تنتج استعماراً. والعلم، رغم كل محاولات تزييفه، يبقى شاهداً على الحق. الأرض لا تكذب. والحجارة، إذا ما أتيح لها الكلام، تقول لفلسطين: أنت الجذور، وأنت المستقبل.
الأسطورة كذريعة للغزو
الرواية التوراتية لم تعد خطاباً دينياً، بل خارطة أيديولوجية؛ فكل حجر يُزعم أنه من "الهيكل"، وكل موقع يُعلن أنه مرقد نبي توراتي، يُستخدم في خدمة التوسع وشرعنة السطو على الأرض. الدين يُمسخ إلى مشروع جغرافي، والأسطورة تُسخّر لصياغة جغرافيا سياسية قسرية.
إسرائيل لا تمتلك شرعية ديموغرافية، فحين أُنشئت، كانت فلسطين مأهولة بسكانها العرب. لذلك لجأت إلى "الشرعية الرمزية"، المستمدة من أساطير دينية. لكنها شرعية قابلة للكسر. الدليل: التعليم الإسرائيلي يُغذي الأطفال بأن الهيكل تحت المسجد الأقصى، رغم غياب أي دليل أثري يؤكد ذلك.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا تواصل إسرائيل التشبث برواية سقطت علمياً؟ لأن البديل مخيف. إن زوال "الوعد الإلهي" و"الهيكل المفقود" يسقطان عن الدولة الصهيونية ادعاء الشرعية التاريخية. فتغدو، كما هي فعلاً، مشروعاً استعمارياً حديثاً لا يختلف عن أي استعمار استيطاني عرفه التاريخ.
من زيف التاريخ إلى سؤال الوجود
لم يعد الانقسام داخل علم الآثار الإسرائيلي سراً. المعسكر التقليدي، المتمسك بالرواية التوراتية، بات معزولاً. أما المشككون، كـ"إسرائيل فنكلشتاين" و"زائيف هرتسوغ"، فقد قدموا تحليلات علمية تثبت أن "مملكة داود" لم تكن إلا مشيخة محلية، لا تشبه في شيء المملكة الموصوفة في سفر الملوك.
إن التوراتيين يقرؤون تلمودهم بوصفه لاهوتاً، لا كوثيقة تاريخية. كتبت في سياقات سياسية لاحقة للأحداث، وربما بعد قرون منها. لكنها، بعكس ملحمة جلجامش أو الأساطير الإغريقية، تحولت إلى أساس لدولة. هنا يكمن الخطر: حين يُستبدل التاريخ بالأسطورة، وتصبح القصص المقدسة حجة للسلب والطرد. وحينما لم تأتِ الحفريات بما يرضي المشروع الصهيوني الاستعماري، انكشفت حقيقة أبعد أثراً: أن الحقيقة لا تُدفن طويلاً، وأن الأرض أصدق من كل النصوص. كل نقش كنعاني، وكل قطعة فخار من العصر البرونزي، تصرخ في وجه الأسطورة: هنا لم تكن مملكة داود.
رغم كل هذا فإن تفنيد الأسطورة لا يعني زوال الدولة، وإن كان يزعزع سرديتها أمام ذاتها والعالم. فجيل جديد من الإسرائيليين بات يشكك في القصة الرسمية، بينما يتراجع الدعم الغربي المبني على "الرواية التوراتية"، وتتقدم الرواية الفلسطينية كصوت أصيل لحضارة حية لا تقبل الطمس.
الشرعية لا تولد من الأساطير
التاريخ ليس ملكاً لأحد. وفلسطين لا تحتاج إلى روايات غيبية لتثبت ذاتها، فهي حاضرة في الجينات، في الذاكرة، وفي حجارة المدن القديمة. أما إسرائيل، فستظل تواجه معضلة وجودية: كيف تؤسس شرعيتها على قصص لا يصدقها حتى علماؤها؟ الجواب واضح: لا شرعية بلا عدل، ولا وطن يُبنى على الأساطير.
إن فلسطين أرض مسكونة منذ القدم بالشعب العربي الفلسطيني ، لكنها صارت، بقوة السلاح والرواية المزورة، "أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض". الرواية التوراتية، التي تحولت إلى سند سياسي لدولة الاحتلال، تهاوت اليوم تحت مجاهر الآثاريين أنفسهم. والغريب أن الإسرائيليين، وهم يحفرون الأرض ، كانوا يحفرون أيضاً في أساسات روايتهم التاريخية. وبدلاً من اعترافهم بالحقيقة، واصلوا دفنها تحت طبقات من التضليل. فالعلم يقول شيئاً، والسياسة تقول نقيضه. والنتيجة؟ شعب يعيش في وهم تاريخي، ودولة تبرر وجودها بأساطير لا تصمد أمام الحفريات.
إن حفريات الأرض كشفت أكثر مما تم إخفاؤه. ليس عن داود وسليمان، بل عن كذبة استمرت قرناً. الرواية الصهيونية تنهار من الداخل، تحت مجاهر العلم، ووعي الأجيال، وصرخة التاريخ. وفلسطين، الجذر والفرع، ستبقى، لأن الأرض شهدت بالحق، إذ هي لا تعرف المداهنة.