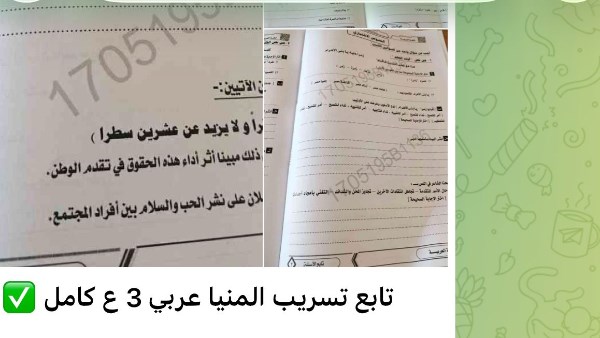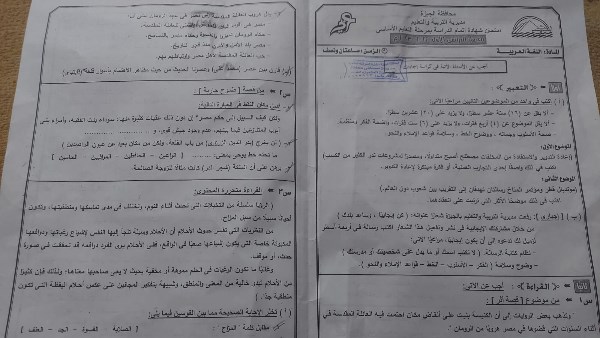لم يعد الحديث عن تراجع الأخلاق مجرد رأي متشائم أو نظرة سوداوية للمستقبل، بل أصبح واقعاً يلمسه كل من يتعامل بشكل يومي مع وسائل التواصل الإجتماعي ويتابع ما تبثه من قيم وسلوكيات غريبة عن منظومتنا الثقافية العربية. لم يعد الشباب يتلقّون أفكارهم من الأسرة أو المدرسة أو حتى من الخبرات المباشرة مع الحياة، بل باتت منصات مثل فيس بوك وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب هي المعلم الأول، والمربي الأكثر تأثيراً، والموجّه الذي يحدد ما هو طبيعي وما هو مثير للإعجاب وما هو مختلف. وللأسف، فإن كثيراً من المحتوى المنتشر اليوم لا يحمل سوى دعوات واضحة للسلوكيات المستفزة أو الغريبة، التي لا تمت لقيمنا بصلة، ولا تحترم خصوصية المجتمع ولا خصوصية الأفراد.
إن التكنولوجيا، رغم كونها أداة عظيمة للمعرفة والتواصل، تحولت في السنوات الأخيرة إلى سيف ذو حدين، بل وربما أصبح الحد السلبي هو الأشد بروزاً لدى فئة كبيرة من الشباب. لقد سمحت منصات التواصل الإجتماعي لأي شخص بأن يصبح مؤثراً بمجرد تحقيق عدد من المشاهدات، بغض النظر عن جودة ما يقدمه أو قيمته أو أثره. وبهذا، تم تحويل الشهرة إلى هدفاً في حد ذاتها، وأضحى لفت الأنظار وسيلة لتحقيقها حتى وإن كان ذلك على حساب الذوق العام، أو الإحترام و الأخلاق.
من الملاحظ اليوم أن كثيراً من الشباب يسعون لتقليد محتوى يعتمد على السخرية، التفاهة، التحديات الخطيرة، أو السلوكيات المتحررة التي لا تتماشى مع البيئة العربية المحافظة. لقد أصبحت التريندات هي البوصلة الجديدة، فهي التى تحدد ما سيقوله الناس وكيف يفكرون وكيف يتصرفون. وما إن تظهر عادة جديدة حتى تُقلّد بلا وعي، ودون التفكير في آثارها الإجتماعية أو الأخلاقية.
إن الخطر الحقيقي يكمن في أن التأثير لم يعد سطحياً كما كان في السابق. فمع الوقت، تتطبع السلوكيات وتصبح جزءاً من الهوية الفردية. فالشاب الذي كان في الماضي يخجل من القيام بتصرف غير لائق بات اليوم يراه عادياً، بل وربما يعتبره دليلاً على الجرأة والحداثة. وهذا التحول في المعايير القيمية يُنذر بتداعيات خطيرة على المجتمع ككل، لأنه يخلق جيلاً يفتقد القدرة على التمييز بين الحرية والفوضى، وبين التعبير عن الذات والإساءة للآخرين، وبين الإبداع والإبتذال.
لقد أدت هذه الفوضى الرقمية إلى تراجع دور الأسرة في التربية، وتراجع تأثير المدرسة، وغياب القدوة الإيجابية. فالطفل أو المراهق اليوم يقضي ساعات طويلة أمام المحتوى المرئي، بينما يقضي وقتاً أقل بكثير في التفاعل مع أسرته أو ممارسة النشاطات الحقيقية التي تنمي مهاراته وقيمه. والأخطر من ذلك أن هذا المحتوى يقدم نماذج لامعة تبدو ناجحة وسعيدة، ما يدفع الشباب للإعتقاد بأن السلوكيات الغريبة أو اللا أخلاقية هي الطريق الأسرع لتحقيق القبول الإجتماعي.
إن الإستخدام السلبي للتكنولوجيا هو المسؤول الأكبر عن هذا التدهور القيمي. فالإنفتاح المفاجئ على ثقافات مختلفة دون وجود وعي أو أدوات نقدية جعل الشباب يتلقّون الرسائل دون غربلة. كما أن إنتشار الإعلانات والمحتوى المدفوع جعل الكثير من المؤثرين يروّجون لأنماط حياة لا تتناسب مع واقع الشباب العربي، فخلق ذلك فجوة بين ما يراه الشباب وما يستطيعون تحقيقه، مما يؤدي بدوره إلى الإحباط أو السعي وراء أي وسيلة لجذب الإنتباه.
لكن رغم كل هذه التحديات، لا يزال بالإمكان إصلاح الوضع إذا توفرت الإرادة. فالمنصات نفسها التي نشرت السلوكيات السلبية يمكن أن تصبح أدوات فعالة لنشر الوعي والأخلاق والقيم الإيجابية. نحن بحاجة إلى حملات إعلامية واعية، إلى مؤثرين يقدّمون محتوى يحترم العقول، وإلى تعزيز دور الأسرة والمدرسة في التوجيه والتوعية. كما نحتاج إلى تشجيع الشباب على التفكير النقدي وعدم تقليد ما يرونه دون فهم أو تحليل.
إن أخلاق المجتمع هي رصيده الحقيقي. وإذا سمحنا لهذا الرصيد أن يتراجع دون مقاومة، فلن يكون المستقبل أفضل مما نراه اليوم. لذلك، فإن الوعي هو خط الدفاع الأول، والتربية هي خط الدفاع الأخير. وبين هذين الخطين، علينا جميعاً - أفراداً ومؤسسات - أن نقف وقفة جادة كي نعيد الأخلاق إلى مقدمة المشهد، قبل أن نصحو على جيل كامل فقد البوصلة تماماً.
لنعد خطوة إلى الوراء، ونسأل أنفسنا: هل ما يحدث هو تقدم أم تراجع؟ هل التكنولوجيا قربت الناس أم فرّقتهم؟ هل المحتوى الذي نستهلكه يضيف إلينا أم ينال منا ويُشوّه وعينا؟ الإجابة واضحة، والخطر واضح، ويبقى أن ننتبه… قبل فوات الأوان.
د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف