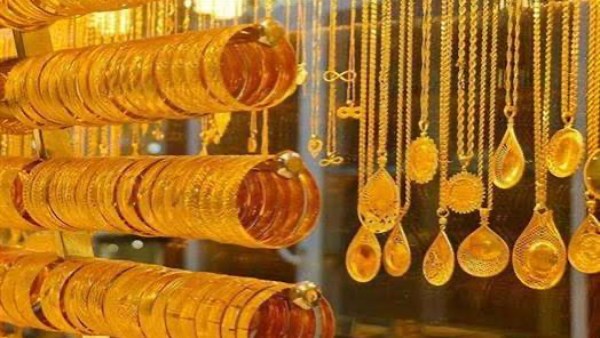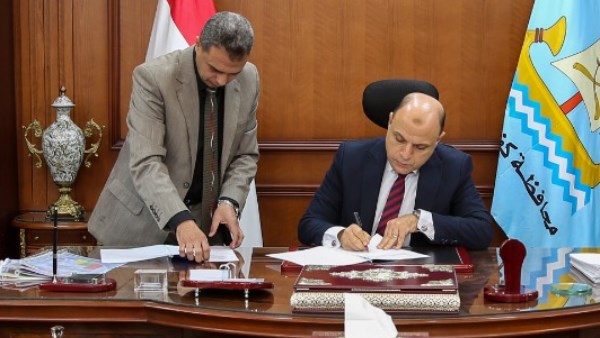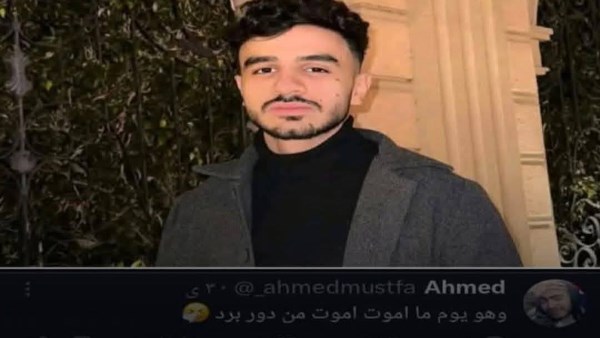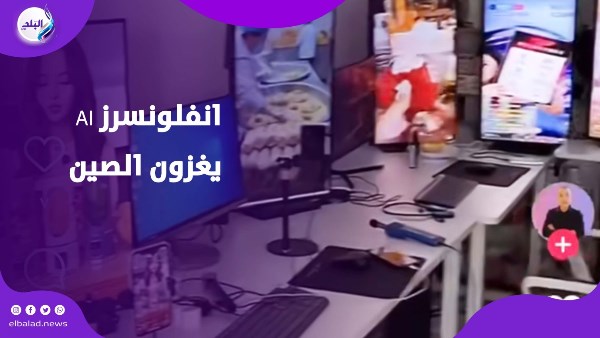ما زلت أذكر اللحظة التي سقط فيها كتاب "الأيام" بين يدي لأول مرة، كأنه شهاب قادم من عالم آخر. لم أكن أعرف وقتها أن هذه الصفحات ستحفر في وعيي أخدوداً لا يندمل، وأن طفلاً كفيفاً من صعيد مصر سيصير رفيقاً لمسيرتي، وشاهداً على تحولاتي.
كنت أقرأ وأنا أشعر أن الظلمة التي يصفها ليست ظلمة عينيه، بل هي ظلمة الوجود الإنساني في مواجهة القهر والجهل والفقر. كان طه حسين يكتب سيرته، لكنه كان يكتب سيرة كل من حكم عليه بأن يرى بعقله قبل عينيه، وأن يشق طريقه بصوته قبل قدميه.
لكن الأيام لم تكن سوى الباب الأول.. الباب الذي فتح لعالم أكثر تعقيداً وإشكالية. عالم طه حسين المفكر، طه الثائر على التراث، طه المتأورب، طه الفرعوني، طه المناصر لعبد الناصر. كيف يجتمع كل هذا في شخصية واحدة؟ كيف يكون صاحب "في الشعر الجاهلي" هو نفسه صاحب "الأيام"؟ كيف يكون ناقد المتنبي اللاذع هو نفسه من دعا إلى وحدة الثقافة العربية؟
هذه المقالة هي رحلة في متاهة طه حسين.. رحلة لا تبحث عن أبطال أو أوثان، بل تبحث عن الحقيقة المتعددة الأوجه لمثقف عربي راهن على العقل فكان أحياناً رهانه رابحاً، وأحياناً أخرى خاسراً. إنها محاولة لفهم كيف يمكن للتنوير أن يحمل بذور تناقضاته، وكيف يمكن للعقل أن يكون أداة تحرير وأداة استلاب في الوقت نفسه.
أنطلق في هذه الرحلة من قناعة واحدة: أن قراءة طه حسين اليوم ليست ترفاً فكرياً، بل هي ضرورة لفهم إشكالياتنا نحن.. إشكاليات الهوية والتراث والحداثة التي ما زالت تلاحقنا مثل ظل طويل.
فهيا بنا نعود إلى "الأيام".. لكن هذه المرة بعيون لا تكتفي بالدمعة والإعجاب، بل تتساءل وتشكك وتحاكم. لأن طه حسين نفسه لم يكن ليرضى عنا أقل من ذلك.
لا أعرف تحديدًا متى التقيت بـ "الأيام" لطه حسين، لكني أعرف أن ذلك اللقاء كان أشبه بزلزال صغير في وعي طفل كان يظن أن العالم ينتهي عند أسوار قريته. كانت "الأيام" نفقًا مظلمًا أدخلني في دهاليز طفولة كفيفة، جعلتني ألمس الظلمة بأطراف أصابعي، وأسمع صوت الخوف يدق في أذني. هناك، في ذلك العالم الضيق، كان طه حسين الأول: السارد الحالم، الذي يحول الألم إلى نغم، والحرمان إلى شعر.
لكن الطريق من "الأيام" إلى "مستقبل الثقافة في مصر" كان مفاجئًا. ففي الجامعة، اكتشفت طه آخر: المفكر الجريء الذي يضع التراث على منضدة التشريح، ويقوده عقله المتقد إلى اقتراح مشروع ثقافي عقلاني لمصر. هنا، تحول الأديب إلى فيلسوف، والسارد إلى محارب. كان ينزع القداسة عن الموروث، ويدعو إلى انفتاح على أوروبا، لكنه كان يفعل ذلك بحماسة فرانكفونية جعلتني أتساءل: أي عقل هذا الذي يدعو إلى التنوير بلغة المستعمر؟
ثم جاءت كتبه الإشكالية، فتجنبت قراءة ما كتبه عن الفتنة الكبرى.
لماذا؟ لأن نبرته فيها كانت أقرب إلى نبرة المستشرقين، الذين ينظرون إلى التراث العربي من برج عاجي، وكأنه حفريات ميتة. أما كتابه عن المتنبي، فبدا لي خصومة شخصية أكثر منه دراسة نقدية.
كأن طه كان ينتقم من المتنبي انتقامًا لمصر وكافور، لا للحقيقة وحدها. وهو موقف قد يكون مفهومًا في سياق معارك المثقفين المصريين آنذاك، لكنه لا يتسق مع صورة المفكر التنويري الذي رفع شعار العقل.
ولعل ما أفسد علاقتي بطه حسين هو ذلك "النزوع الفرعوني" الذي طغى على فكره في مراحله المتأخرة، ثم انسجامه مع المد القومي في عهد عبد الناصر. كيف لرائد التنوير أن يقفز إلى شرفة "حبيب الملايين" دون أن يرى التناقض بين دعوته إلى العقلانية وانتقاله نحو الخطاب الشعبوي؟ وكيف استطاع أن يجمع بين مصر المتوسطية الأوروبية ومصر الفرعونية ومصر العربية، دون أن يرى التعارض بين هذه التصورات؟
طه حسين، إذن، ليس صورة واحدة، بل هو شخصيات متعددة: هو الطفل الكفيف في قريته القاسية، وهو المثقف الثائر على التقليد، وهو الأديب الذي يكتب بانفعال أحيانًا. وهو، فوق كل هذا، مفكر كبير صنعته ظروف عصره، وحمولاته الثقافية، وتناقضات مجتمعه.
أما لقب "عميد الأدب العربي"، فهو لقب يحتاج إلى إعادة نظر. فكيف يكون عميدًا لأدب ضخم ممتد من المحيط إلى الخليج، وهو الذي كتب عن تراثه بمنهجية المستشرقين، وتحدث عن الشعر الجاهلي بشكوكية مفرطة، وانتقد المتنبي بتحيز واضح؟ أليس في هذا اللقب شيء من المبالغة، وشيء من المركزية الثقافية المصرية التي كانت بأسم الذي لا يسأل عما يفعل.. وهم يسألون!
أكتب اليوم عن طه حسين وأنا أتذكر مقولة الجاحظ: "الكتاب وعاءٌ ملئ علمًا، وإناءٌ ملئ ظرفًا". ولكن أي وعاء هذا الذي يحمل بين دفتيه كل هذه التناقضات؟ وأي إناء هذا الذي يتسع لأطياف متصارعة من الفكر والأدب؟
"عميد الأدب العربي".. ذلك اللقب يحتاج اليوم إلى مساءلة جذرية. فما الذي يجعل كاتباً مصرياً يتناول التراث العربي بمنهجية استشراقية أن يكون "عميداً" له؟ أليس في هذه التسمية مفارقة تاريخية تحتاج إلى تفكيك؟
لنبدأ من المشروع النقدي لطه حسين.. ذلك المشروع الذي قام على ثلاثة أركان:
1. الشك المنهجي الديكارتي الذي تعلمه في السوربون.
2. النزعة العقلانية التي حولت التراث إلى مادة للتشريح.
3. الرؤية التحديثية التي كانت تنظر إلى أوروبا كمرجعية نهائية.
هذا المشروع كان يعاني من ازدواجية عميقة.. ففي الوقت الذي كان يدعو فيه إلى تحرير العقل من سلطة النقل، كان يقع هو نفسه تحت سلطة مرجعية أخرى: سلطة المركزية الأوروبية. وهو تناقض لم يستطع التحرر منه تماماً.
خذ على سبيل المثال كتابه "في الشعر الجاهلي".. الذي قدم فيه قراءة جريئة شككت في صحة كثير من الشعر الجاهلي، لكنه فعل ذلك باستخدام أدوات المستشرقين ومناهجهم. والسؤال: أليس النقد الذي وجهه لرواة الشعر الجاهلي يمكن أن يوجه إليه هو نفسه؟ ألم يكن هو أيضاً ناقلاً للشكوك الاستشراقية؟
ثم جاءت كتبه عن الخلفاء الراشدين والفتنة الكبرى.. والتي بدت للكثيرين وكأنها امتدادٌ للمدرسة الاستشراقية التي نظرت إلى التاريخ الإسلامي من خلال عدسة الصراع على السلطة، متجاهلة البعد العقدي والأخلاقي في تلك الأحداث.
وهنا نصل إلى إشكالية الهوية عند طه حسين.. تلك الإشكالية التي جعلته يتنقل بين ثلاثة أبعاد:
1. البعد العربي الإسلامي (الذي كان يتعامل معه بنوع من النقد الجذري)
2. البعد الفرعوني (الذي بالغ في التأكيد عليه في مراحله المتأخرة)
3. البعد المتوسطي الأوروبي (الذي رآه مدخلاً للتحديث)
لكن السؤال: كيف يمكن لمثقف أن يجمع بين هذه الأبعاد المتناقضة؟ وأي مشروع ثقافي يمكن أن يبنى على هوية ممزقة بين فرعونية وأوروبية وعربية؟
لقد نجح طه حسين في تشريح التراث، لكنه فشل في تقديم مشروع متجانس للهوية. وكانت النتيجة أن أصبحت مصر عنده كياناً هجيناً.. لا هو عربي خالص، ولا هو فرعوني خالص، ولا هو أوروبي خالص.
ثم جاءت مرحلة القومية العربية في عهد عبد الناصر.. فوجد طه حسين نفسه منسجماً مع هذا المد القومي. لكن كيف لصاحب المشروع الفرعوني المتوسطي أن ينسجم مع المد القومي العربي؟ أليس هذا تناقضاً آخر؟
الحقيقة أن طه حسين كان ابن مرحلته التاريخية.. مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث كانت النخبة المصرية تحاول البحث عن هوية بين التراث والحداثة، بين الأصالة والمعاصرة، بين العروبة والفرعونية.
أما عن لقب "عميد الأدب العربي".. فأظن أن الوقت قد حان لإعادة النظر فيه. ليس لأن طه حسين لم يكن أديباً كبيراً، بل لأن التسمية نفسها تحمل إشكالات كثيرة:
1. إشكالية المركزية المصرية في الثقافة العربية
2. إشكالية احتكار تمثيل الأدب العربي
3. إشكالية معايير العمادة وأهلها
فالأدب العربي يمتد من المحيط إلى الخليج، وهو إرث مشترك لأمة بأكملها. وتسمية كاتب مصري "عميداً" لهذا الأدب فيه تجاهل لأدباء كبار من سوريا والعراق ولبنان والمغرب والجزائر واليمن والسعودية وغيرها.
ختاماً.. يبقى طه حسين ظاهرة ثقافية فريدة، استطاعت أن تهز الثوابت، وتفتح الأسئلة، وتثير الجدل. لكن قراءته اليوم تحتاج إلى نقد جذري يضع مشروعه في سياقه التاريخي، ويكشف تناقضاته، ويميز بين إنجازاته وإخفاقاته. فالعمادة الحقيقية في القدرة على إثارة الأسئلة التي لا تتوقف، والتحديات التي لا تنتهي. وطه حسين، بكل تناقضاته، كان سيداً في هذا الفن في ذلك الوقت؟
تظل قراءة طه حسين درسًا بليغًا في فهم المثقف في سياقه التاريخي والاجتماعي، لا كتمثال منزه عن النقد. فهو، مثل كل العظماء، كان إنسانًا يحمل تناقضات عصره، ويعكس إشكاليات مجتمعه. وكان، فوق كل شيء، كاتبًا بارعًا استطاع أن يخلد معاناة طفل في قرية صغيرة، وأن يفتح أبوابًا ثقافيةً ما زلنا ندخل منها ونخرج حتى اليوم.