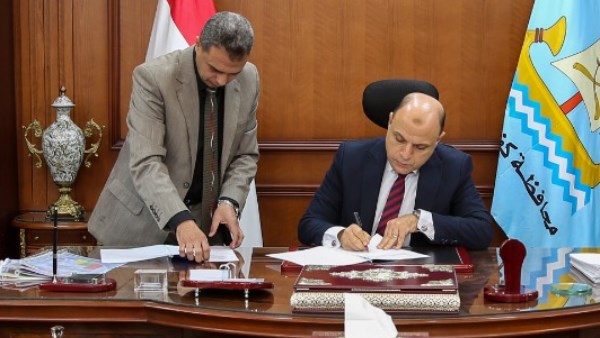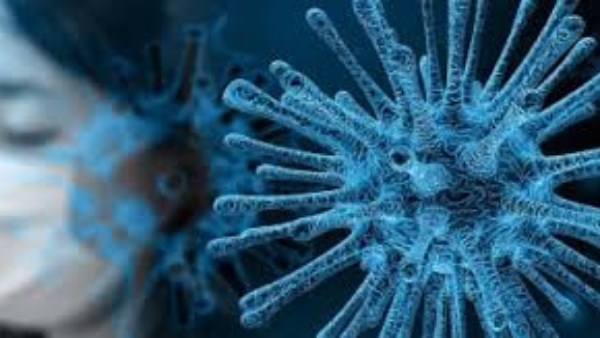في سياق الحياة الدينية المعاصرة، يبرز التصوف باعتباره أحد المداخل الكبرى إلى الروحانية التي تُعيد للإنسان اتزانه في عالم يزداد اضطرابًا بالمفاهيم وتفككًا بالقيم. وقد أثارت التوصية الأخيرة التي أصدرها الشيخ العلامة علي جمعة باختيار الدكتور مجدي عاشور وكيلاً عامًا للطريقة الصديقية المشيشية وشيخًا لها من بعده، الكثير من التأملات حول مستقبل الطرق الصوفية، وكيف ينبغي أن يتم انتقال المشيخات بسلاسة وهدوء بعيدًا عن التنافس والصخب الإعلامي.
إن هذه الخطوة تحمل دلالات علمية وروحية عميقة، فهي تعكس رغبةً في إعادة الاعتبار للتصوف كعلم للتربية الروحية وأداة لحماية المجتمع من الانقسامات والادعاءات، وتؤكد على أن المشيخة مسؤولية تربوية لا مجرد امتياز اجتماعي أو سلطة رمزية.
الدلالة الأولى التي يمكن استنباطها من هذا الاختيار هي أنّ التصوف الحق ليس وراثة نسبية، وإنما هو أهلية علمية وأخلاقية. اختيار علي جمعة لمجدي عاشور لم يكن امتدادًا للعائلة أو حرصًا على بقاء المشيخة في إطار دموي مغلق، بل هو تجسيد لمبدأ الكفاءة والاستحقاق، حيث يتم تسليم الأمانة لمن أثبت بالعلم والعمل والتجربة التربوية قدرته على الاستمرار في خدمة الطريقة ومريديها. هذا التوجه يقطع الطريق على ما يمكن أن يسيء إلى سمعة التصوف إذا تحوّل إلى أشكال شكلية من التوريث أو صراعات على القيادة.
الدلالة الثانية هي أن هذه الخطوة تقدم نموذجًا ينبغي أن تسير عليه بقية الطرق الصوفية. فالمطلوب في زمن الأزمات الفكرية والسياسية هو أن تضمن الطرق الصوفية انتقال القيادة فيها بانتظام وهدوء، وأن تجعل من المشيخة وسيلة لتجديد العهد مع قيم الزهد والتجرد والذكر، لا فرصة لتكريس الانقسام أو الاستعراض.
حين يتم الانتقال بسلاسة وبمعايير علمية وأخلاقية، فإن الطرق الصوفية تصبح قادرة على أداء دورها في المجتمع بوصفها خزّانًا للقيم الروحية ومصدراً للسكينة والاستقرار.
إنّ العالم المعاصر يعيش حالة من التيه: جشع مادي يلتهم إنسانية الإنسان، وحيرة مفاهيمية تجعله يفقد البوصلة بين الحقائق والزيف، وتدفق هائل للصور يتركه في فراغ داخلي متزايد. هنا يبرز دور التصوف باعتباره مدرسةً في التربية الروحية وفضاءً لتزكية النفس، حيث يجد الإنسان من خلال الذكر والمجاهدة طريقًا إلى الصفاء الداخلي وإلى التوازن بين الروح والجسد. التصوف ليس انسحابًا من المجتمع ولا انعزالًا عن الدولة، بل هو إسهام في صيانة المعنى داخل الفضاء العمومي، عبر تخريج أفراد أكثر التزامًا بالقيم، وأكثر قدرة على مواجهة نزعات الأنانية والعنف.
إن التحدي الأكبر أمام التصوف اليوم هو أن يحافظ على صدقيته أمام موجة من الممارسات التي حوّلته عند البعض إلى عروض بهلوانية أو إلى وسائل للاستعراض على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الممارسات جعلت كثيرًا من الناس ينفرون من التصوف، لأنه لم يعد في نظرهم طريقًا للتزكية بل أداة للتربح أو للشهرة. ومن هنا تأتي أهمية النموذج الذي قدمه علي جمعة بتسليم القيادة لمن رآه أهلًا لها بالمعرفة والخبرة، ليكون التصوف أداةً لإعادة بناء الثقة في الروحانية الإسلامية وإبرازها كمسار أصيل يخدم الدين والوطن.
التصوف في جوهره ليس بيعةً مطلقة لشيخ أو انقيادًا لشخص، بل هو التزام بالمقاصد الكبرى للشريعة من تزكية وإحسان. والولاء السياسي في الإسلام لا يوزّع على مشايخ الطرق، وإنما يُعقد لولي الأمر باعتباره الضامن لوحدة الأمة واستقرارها. وهنا تلتقي الوظيفة الروحية للتصوف مع الوظيفة السياسية للدولة في تكامل يحمي المجتمع من التشرذم، ويجعل من السلوك الصوفي مسارًا للتهذيب الداخلي يدعم قيم المواطنة والتعايش.
ولعل ما يحتاجه العالم في لحظته الراهنة هو هذه الروحانية العملية التي يقدمها التصوف: أدب الحلس والسكينة، رطوبة القلب بذكر الله، استبدال الصخب الخارجي بحوار داخلي يعيد بناء المعنى. فالإنسان المعاصر يفتش عن مساحة يتنفس فيها بعيدًا عن ضغط الاستهلاك وضجيج الإعلام، ولن يجدها إلا في التربية الروحية التي تُعيده إلى ذاته من خلال الصدق مع الله والرحمة بالخلق. التصوف بهذا المعنى ليس ترفًا فكريًا ولا زينة لفظية، بل ضرورة وجودية تحمي الإنسان من الانهيار أمام طغيان المادة.
إن توصية علي جمعة وما تحمله من دلالات تمثل دعوة لإعادة النظر في وظيفة التصوف: أن يكون مدرسة للتزكية ومجالًا لتهذيب النفس، وأن يتم الانتقال فيه بهدوء وتوازن يقي الطرق من الانقسام. وحين تُعاد صياغة المشيخة على أساس الكفاءة والتجرد، يتحول التصوف إلى رافعة للاستقرار الروحي والاجتماعي، وإلى جواب عملي عن قلق الإنسان في زمن الاضطرابات المفاهيمية والجشع المادي.
بهذا فقط يمكن أن يستعيد التصوف مكانته الأصلية كجناح الروح في الإسلام، وكمجال لإعادة إحياء السكينة في حياةٍ ينهشها الضجيج.