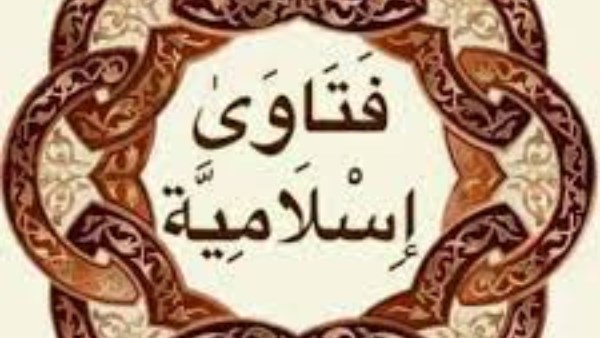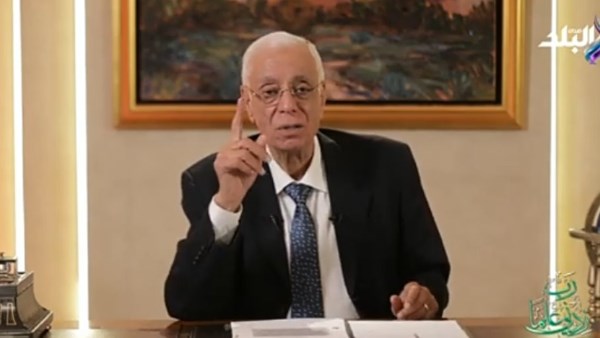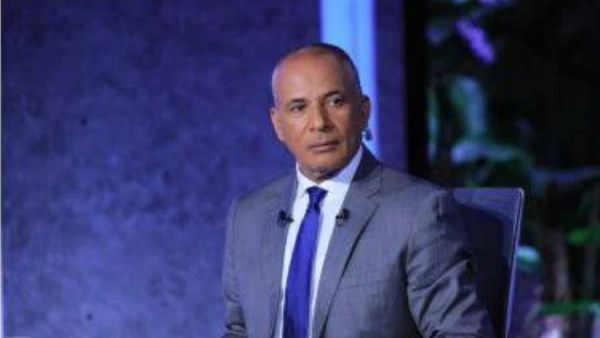فتاوى
هل يوجد شخص وشه نحس على من حوله؟
ما حكم اشتراط الزيادة في رد القرض بين الأشخاص؟
الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يوجد شخص وشه نحس على من حوله؟
لعله ينبغي الوقوف على حقيقة هل يوجد شخص نحس أو بالمعنى الدارج “ وش نحس” ؟، باعتباره من الاعتقادات الشائعة بين الكثير من الناس، حيث إن إجابة استفهام هل يوجد شخص وش نحس ؟ بالإيجاب، وهو ما يجعل النحس تهمة توجه كثيرًا وعادة لأي شخص حل بمكان فوقعت به المصائب حتى إن لم يكن له يد بها ، أو أغلقت الأبواب في وجهه في المسعى الذي يريده ، كما يعتقد البعض، ومن هنا ولتبرئة أولئك المتهمين بالشؤم والحظ السيء ينبغي الوقوف على حقيقة هل يوجد شخص نحس على من حوله؟.
هل يوجد شخص نحس
ورد عن هل يوجد شخص وش نحس ؟ أن هذا يعد من التشاؤم والتطير، فقال ابن حجر: ولا يجوز أن ينسب إلى المرء ما يقع من الشر مما ليس منه ولا له فيه مدخل وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس منه... انتهى منه بتصرف، فلا يجوز لأحد أن يتشاءم بغيره .
وقد قص الله علينا في سورة يس أن أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون قالوا: (قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) {يس:18}، قال الطبري يعنون: إنا تشاءمنا بكم فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم.. يقول تعالى: قالت الرسل لأصحاب القرية: طائركم معكم. أي أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم ذلك كله في أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فبما كتب عليكم وسبق لكم من الله.
وقال ابن حجر: قال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال، فلا يجوز للمرء أن يسيء الظن بالله تعالى ويتشاءم بالآخرين .
كما لا يجوز له أن يحكم على مستقبل غيره بالنجاح أو الخسارة لأن ذلك من علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وقد قال في محكم كتابه: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا) الآية 34 من سورة لقمان ، فعليه أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه مما وقع فيه ويكف لسانه عن المسلمين وعن الإساءة إليهم وسوء الظن بهم.
حكم وصف الغير وش نحس
لعل لفظة " وجه نحس" هي اتهام عادة ما يرافق الشخص الذي إن حل بمكان وقعت به المصائب حتى إن لم يكن له يد بها ، أو الذي تغلق الأبواب دائمًا في وجهه في المسعى الذي يريده ، كما يعتقد البعض ، وقول شخص عن آخر أنه يجلب النحس ، أو أن قدومه نحس وما نحوها من العبارات التي تنسب إلى المرء ما يقع من الشر ، يدخل في باب التشاؤم والتطير المنهي عنهما في الإسلام، لما فيهما من سوء الظن بالله تعالى .
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )، ووجه إساءة الظن بالله عز وجل عند المتشائم والمتطير اعتقاده أن ما حدث له إنما هو بسبب هذا الشخص دون إضافة تدبير الأمر إلى الله جل وعلا يعتبر سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وهذا لا يجوز .
وورد أنه لا يجوز نسبة الشر أو النحس كما يقول الناس إلى الأشخاص ، كما أن من يفعل ذلك يقع في الإثم إذا كان يعتقد ما يقوله، وقد بين القرآن الكريم عدم نسبة الشر إلى الآخرين في قوله تعالى بسورة يس : ( قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (19 ) .
وقد نسب الكافرون الشر إلى الرسل بقولهم لهم إنا تشاءمنا منكم ، فرد عليهم الرسل إن شؤمكم معكم بمعنى حظكم من الخير والشر معكم ولازم في أعناقكم وليس من شؤمنا .
وقد حث الإسلام على الفأل الصالح ، فقال -صلى الله عليه وسلم- : ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ، الكلمة الحسنة)، فقد كان يعجب الرسول -صلى الله عليه وسلم- الفأل الصالح لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بالله تعالى والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال .
وخلاصة الأمر أنه لا يجوز أن ينسب شخص إلى آخر ما يقع من الشر مما ليس منه ، ولا فيه مدخل ، وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر ، فتنفر النفس منه، ومن ينسب الشر إلى شخص آخر فإنه آثم .
ولا يصح ذلك منه، لأنه بفعله هذا يشوه صورة هذا الشخص ، ويجعل الناس يبتعدون عنه ، وقد يؤدي ذلك إلى حالة نفسية صعبة تلازمه ، وهو ضرر لا يجوز إلحاقه بالآخرين.
هل يوجد نحس
ورد أنه لا يوجد في الإسلام نحس وحظ سيء، بل هذا من خرافات وعادات الجاهلية، ويسمى شرعا التشاؤم والتطير، وقد ورد النهي عنه والتحذير من اعتقاده، لأنه من عقائد أهل الشرك وأعداء الرسل.
وقد قص الله علينا في سورة يس أن أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون:﴿ قالوا إِنّا تَطَيَّرنا بِكُم لَئِن لَم تَنتَهوا لَنَرجُمَنَّكُم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنّا عَذابٌ أَليمٌ * قالوا طائِرُكُم مَعَكُم أَئِن ذُكِّرتُم بَل أَنتُم قَومٌ مُسرِفونَ﴾ ومعنى الآية: إنا تشاءمنا بكم، فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم، قالت الرسل لأصحاب القرية: طائركم معكم، أي أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم، ذلك كله في أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا، إن أصابكم سوء فبما كتب عليكم وسبق من قدر الله لكم.
ولذا قال أهل العلم: لا يجوز شرعا أن ينسب إلى المرء ما يقع من الشر مما ليس منه، ولا له فيه مدخل، وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر، فتنفر النفس منه، وهذا هو التشاؤم المنهي عنه.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، ويكره التشاؤم، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحس الظن بالله تعالى على كل حال، وعليه فلا يجوز لك أن تتشاءم من ابن عمك، وتجعله سببا في بطلان كل عمل تريد تحقيقه، بل ابحث عن السبب الحقيقي لتخلف العمل، وقد يكون الله أراد لك خيرا بذلك؛ لأن الله يعلم وأنت لا تعلم.
كيفية التخلص من النحس
جاء أنه لدفع العين والحسد عن نفسك عليك بالتحصن بالأذكار، وخاصة أذكار الصباح والمساء، والثقة بالله، وكمال التوكل عليه، فإنه من اعتصم الله فلا يضره شيء، وعليك بالابتعاد عن الخواطر والأفكار السلبية والتخوف من الآخرين و نظراتهم إليك، حتى لا يؤثر ذلك على نفسيتك، ويجعلها تعيش في حالة شك واضطراب.
ومن ذلك عليك ببناء الثقة بنفسك وتدريبها على النجاح، ومصاحبة الناجحين، والابتعاد عن الفاشلين والمحبطين، وعدم الاستماع لكلامهم أو الاستسلام لتثبيطهم لك، بل اجعل من كلامهم دافعا لك لمزيد من الجد والاجتهاد، وحدث نفسك بالنجاح، وفكر فيه كثيرا، وخذ بأسبابه، ومنها الدعاء وحسن الظن بالله سبحانه، و-إن شاء الله- تحقق أمنياتك المباحة، وتكون من الناجحين.
هل النحس مذكور في القرآن
وأفاد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، بأن النحس مذكور في القرآن، مستشهدًا بقوله تعالى: "كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ " فقد ذكرت مرتين فى سورة الأنفال.
وقد قال الزمخشري -رحمه الله-: لما طغى آل فرعون أنتقم الله منهم ولو لم يطغوا لأجل حسابهم إلى يوم القيامة، وينبغي توخى الحذر فمن يقول لك ذُكر فى القرآن فاسأل كيف ذُكر .
وجاءت كلمة نَحْسٍ﴿ الآية ١٩ من سورة القمر﴾ شؤم، يَوْم نحْس﴿١٩ القمر﴾ شؤْم عليهم، ونحس قوله تعالى: ﴿يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس﴾ [الرحمن/35] فالنحاس: اللهيب بلا دخان، وذلك تشبيه في اللون بالنحاس، والنحس: ضد السعد، قال الله تعالى: ﴿في يوم نحس مستمر﴾ [القمر/19]، ﴿فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات﴾ [فصلت/16] وقرئ (نحسات) (وهي قراءة شاذة) بالفتح.
و قيل: مشؤومات (وهذا قول الضحاك، حكاه عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 3/33، وكذا قال به قتادة ومجاهد. انظر: الدر المنثور 7/317)، وقيل: شديدات البرد (وهذا القول حكاه النقاش. انظر: تفسير القرطبي 15/348). وأصل النحس أن يحمر الأفق فيصير كالنحاس. أي: لهب بلا دخان، فصار ذلك مثلا للشؤم.
وفي تفسير الجلالين، لقوله تعالى : ﴿إنا أرسلنا عليهم ريحا صرْصرا﴾ أي شديدة الصوت ، ﴿في يوم نحس﴾ شؤم، ﴿مستمر﴾ دائم الشؤم أو قويه وكان يوم الأربعاء آخر الشهر، وفي تفسير الميسر إنَّا أرسلنا عليهم ريحًا شديدة البرد، في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك، تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم، ويفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله.
ما حكم اشتراط الزيادة في رد القرض بين الأشخاص؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراط الزيادة في رد القرض بين الأشخاص؟ حيث يريد أحد الأشخاص أن يستلف منّي مبلغًا من المال، وأرغب في أن أشترط عليه ردّ المبلغ بزيادة كما يحدث في البنوك. فهل هذا جائز شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تسليف المحتاج مندوبٌ إليه شرعًا للقادر عليه، وما ترغب فيه مِن اشتراط ردّ المبلغ المالي بزيادةٍ على أصله هو أمرٌ محرمٌ شرعًا؛ لأنَّ الزيادة لم يقابلها عوض فأشبهت الربا؛ إذ القرض بين الأشخاص مِن عقود الإرفاق والقربات، لا مِن عقود التربح والمعاوضات، فإذا اشتُرِطَ فيهِ منفعةٌ بزيادةٍ أو نحوها خرج عن موضوعه.
وأما مساواة المعاملة المسؤول عنها بمعاملة البنوك: فغير سديد، وقياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ البنوك من الشخصيات الاعتبارية التي لها مِن الأحكام ما يختلف عن أحكام الأفراد، والبنك جهةٌ ربحيةٌ استثماريَّة، بخلاف الأفراد؛ فإنَّ أساس معاملاتهم في الإقراض مبناها على الرفق والإرفاق؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280].
حكم اشتراط الزيادة في رد القرض بين الأشخاص
إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية): [وأما الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو ألا يكون فيه جَرُّ منفعةٍ، فإنْ كانَ لمْ يَجُزْ، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أنْ يَرُدَّ عليه صحاحًا، أو أقرضَهُ وشرط شرطًا لهُ فيه منفعة؛ لما رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه «نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا»؛ ولأنَّ الزيادة المشروطة تُشبه الرِّبا؛ لأنَّها فضلٌ لا يقابله عوض] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 166، ط. دار الفكر): [(قوله: كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا حرامٌ) أي: إذا كان مشروطًا كما عُلم ممَّا نقله عن "البحر"] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (5/ 289، ط. دار الغرب الإسلامي): [شرطه: ألَّا يَجُرَّ منفعةً للمقرِضِ، فإنْ شَرَطَ زيادةً قدرًا أو صفةً: فسدَ، ووجبَ الردُّ إن كان قائمًا، وإلَّا ضَمِنَ بالقيمةِ وبالمثلِ على المنصوص] اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 89، ط. دار الفكر): [(ولا يجوز) أي يحرم (سلفٌ يجرُّ نفعًا) لغير المقتَرِض؛ بأنْ يَجُرَّ للمقرِض -بكسر الراء- أو لأجنبيٍّ مِن ناحية المقترض؛ لأنَّ السلف لا يكون إلا لله؛ فلا يقع جائزًا إلا إذا تَمَحَّضَ النفعُ للمقترِض] اهـ.
وقال أيضًا (2/ 91): [(وَمَنْ رَدَّ في القرضِ) الذي عليهِ (أكثرَ عددًا في مجلسِ القضاءِ) المرادُ بعدَ حلولِ الأجلِ؛ لأنَّ المرادَ بمجلسِ القضاءِ حلولُ أجلِ القضاءِ، وذلك إنَّما يكونُ بعدَ فراغِ الأجلِ، (فَقَدِ اختلفَ) العلماءُ (في ذلك) بالجوازِ وعدمهِ، وقَيَّدَ الخلافَ بقوله: (إذا لمْ يكنْ فيهِ شرطٌ ولا وَأْي) أي وَعْدٌ (ولا عَادَةٌ).. كما اتُّفِقَ على حرمةِ الزيادةِ عندَ الشرطِ أو الوعدِ أو العادةِ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (4/ 34، ط. المكتب الإسلامي): [يَحْرُم كُلُّ قرضٍ جَرَّ منفعة؛ كشرط ردِّ الصحيح عن المكسر، أو الجيد عن الرديء، وكشرط ردِّه ببلدٍ آخر، فإنْ شرط زيادةً في القدر؛ حَرُمَ إن كان المال رِبَوِيًّا، وكذا إن كان غير رِبَوِيٍّ على الصحيح] اهـ.
وقال أيضًا في "المجموع شرح المهذب" (13/ 170، ط. دار الفكر): [ولا يجوزُ قرضٌ جرَّ منفعةً؛ مثل: أن يُقرِضَهُ ألفًا على أن يَبِيعَهُ دارَهُ، أو على أن يَرُدَّ عليه أجودَ مِنهُ أو أكْثَرَ مِنْهُ.. ورُوي عنْ أُبَيِّ بن كَعْبٍ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ رضي الله عنهم: أنهم نَهَوا عن قرضٍ جَرَّ منفعةً، ولأنَّهُ عقدُ إرفاقٍ؛ فإذا شُرِطَ فيهِ منفعة خرج عن موضوعه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة): [وكلُّ قرضٍ شُرط فيه أن يزيدَهُ: فهو حرامٌ بغير خلاف.. وقد رُوي عَنْ أُبَيِّ بن كَعب وابن عبَّاس وابن مسعود رضي الله عنهم: أنَّهم نَهَوا عَن قرضٍ جرَّ منفعة، ولأنَّه عقدُ إرفاقٍ وقربة؛ فإذا شُرِطَ فيهِ الزيادةُ أخرجهُ عن موضوعه] اهـ.
الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
لاشك أنك إذا أردت البركة في الرزق، عليك أن تحرص كل الحرص ليكون مالك حلالا ، وهو أمر ليس باليسير لأننا في زمن الفتن التي تحاصرنا من كل صوب وحدب ، حيث إن الدنيا دار ابتلاء ، لذا عليك أن تسلك كل السُبل ليكون مالك حلالا وهنا يحدث الخلط عند البعض ممن يظنون أن المال الحرام هو المسروق فقط، فيما أن هناك تهاون في عدة أفعال تجعل جزاءك كمن أكل أموال الناس بالباطل، فصار الطريق المتبع ليكون مالك حلالا ليس معلوما بدقة، رغم أن الشرع الحنيف بين كل المسائل، إلا أن اللبس عند البعض لازال موجودًا .
ليكون مالك حلالا
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ليكون مالك حلالا عليك بتجنب ثلاثة أفعال شائعة بين كثير من الموظفين ، رغم كثرة نصوص النهي عنها بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة .
وأوضحت «الإفتاء » عن السُبل المتبعة ليكون مالك حلالا ، أن تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس بدون حق أو الإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب يعد أكلاً للمال بالباطل، وذلك حيث إن الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كُلف به وفُوِّض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها.
واستشهدت بما قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري)، منوهة بأَنَّ تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل.
ونبهت إلى أنه قد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} الآية 92 من سورة النساء، مؤكدة أنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس بدون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.
الرزق
يجب على كلّ مسلمٍ أنْ يؤمن ويعتقد اعتقاداً جازماً بأنّ الله -تعالى- قدّر الرزق لجميع المخلوقات، ودليل ذلك قوله: (وَما مِن دابَّةٍ فِي الأَرضِ إِلّا عَلَى اللَّهِ رِزقُها وَيَعلَمُ مُستَقَرَّها وَمُستَودَعَها كُلٌّ في كِتابٍ مُبينٍ).
ويطلق الرزق في اللغة على العطاء، سواءً أكان في الدنيا أم في الآخرة، ومن الجدير بالذكر أنّ الله هو الرازق الوحيد ولا أحداً سواه، حيث إنّه خلق العباد، ورزقهم دون أيّ تعبٍ أو جهدٍ أو كلفةٍ منه، كما أنّه يعطي العباد ما يسألونه منه دون أنْ ينقُص من مُلكه شيئاً.
كما أنّه ورد اسم الرزّاق في القرآن الكريم في أكثر من موضعٍ فالرزّاق يدلّ على أنّ الله -تعالى- يرزق جميع عباده، مرةً بعد مرةً، كما أنّه صاحب قوةٍ؛ أيّ أنّ الرزق لا يُعجزه، إلّا أنّ الواجب على العبد السعي في تحصيل رزقه وكسبه، مع حُسن التوكّل على الله عزّ وجلّ.
ويجب على المسلم أنْ يعلم أنّ كثرة الرزق لا تدلّ على محبة الله -تعالى- لعبده، حتى إنْ وَجد المسلم أنّ أهل الكفر قادرون ومرزوقون بشكلٍ أكبر من أهل الإيمان والإحسان، ومن الواجب على المسلم أيضاً أنْ يصبر ويحتسب أمره إلى الله -تعالى- في رزقه، والنظر إلى من دونه في الرزق؛ ليكون
أسباب نزع البركة من المال
ورد أنّ لنزع البركة من المال وذهابها أسباباً كثيرة، ومنّها :
الرّبا قال الله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)، والمحق يكون بإذهاب بركة هذا المال الذي حصل بسبب الربا، وممّا يزيد الأمر سوءًا جهل العديد من الناس بأحكام الربا والبيوع وغيرها من المعاملات الماليّة، فيقعون في المحظور من حيث لا يشعرون.
كثرة الحلف على السّلعة عند البيع حذّر من هذا الفعل نبيّنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم، وبيّن أنّه من الأشياء التي تنزع البركة، قال صلّى الله عليه وسلّم: (الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ)، ويزداد محق البركة -وإن كان المال يزداد في ظاهره- إذا كان هذا الحلف على السلعة كاذبًا.
كتمان عيب أو عيوب السّلعة عند البيع بيّن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّ هذا الفعل من الأسباب التي تنزع البركة من المال، فقال صلّى الله عليه وسلّم: (البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أوْ قالَ: حتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما)، فأن يبارك الله للبائع في ثمن سلعته التي سينقص ثمنها عندما يبيّن عيبها، فنقص ثمنها خير له من مالٍ كثيرٍ لا بركة فيه يجمعه بكتمان عيوب سلعته.
عدم شكر النعم وكفرانها يتجلّى ذلك بعدم حمد الله على نعمه، أو إنكار فضل الله على الناس بتفضّله عليهم بنعمه التي لا تعدّ ولا تحصى، قال الله تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)، والعذاب الشديد يعني سلب النعم من جاحدها -والعياذ بالله-.
الذنوب هي عمومًا سببٌ في أغلب ما يصيب الناس من بلاء، ومن البلاء أن ينزع الله عزّ وجلّ من المال بركته، فلا ترجع البركة إلّا برجوع العبد إلى ربّه بالتوبة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ما نزل بلاءً إلا بذنب، ولا رُفِعَ بلاءً إلا بتوبة".
منع الزكاة يكون ذلك بعدم إخراجها إلى مستحقّيها، فمنعُها سببٌ في ذهاب بركة المال، بل يتعدّى بركةَ المال إلى بركاتٍ أخرى؛ كانحباس المطر الذي يرسله الله تعالى ليخرج به من بركات الأرض ما يشاء، قال الله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)، وفي الحديث الصحيح الطويل قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (ولم يَمْنَعُوا زكاةَ أموالِهم إلا مُنِعُوا القَطْرَ من السماءِ).
البخل والإسراف وعدم التوسّط بينهما قال الله تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً)، فالبخيل يحبس بركة ماله، فلا هو ينتفع ببركته ولا ينفع غيره بها، والمسرف يُضيّع بركة ماله سريعا، فالتوسّط في الإنفاق يديم البركة بدوام المال، فلا يحبسه ولا يذهبه سريعا.