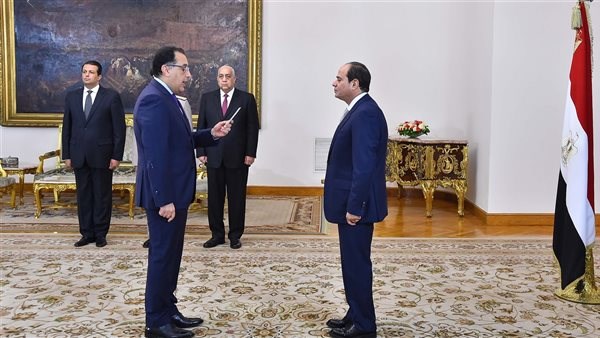ليست الفتوىُ واقعةً لغويةً تُستخرج من بطون الكتب، ولا جوابًا تقنيًا يُلقى في الفراغ، بل هي فعلُ وعيٍ مركّب، يتقاطع فيه النصُّ مع الإنسان، والحكمُ مع أثره، والقولُ مع مآله. وحين تُدرك مؤسسةُ الإفتاء هذا المعنى، فإنها تنتقل من مقام «إدارة السؤال» إلى مقام «حراسة المعنى»، ومن منطق الاستجابة اللحظية إلى أفق الاستشراف المسؤول. في هذا السياق، يتعيّن النظر إلى ما تقوم به دارُ الإفتاءِ المصرية لا بوصفه نشاطًا مؤسساتيًا اعتياديًا، بل باعتباره مسارًا واعيًا لإعادة ترتيب العقل الإفتائي على أساس مقاصدي جامع بين مقتضيات الدين وحاجات الدنيا.
إنّ التحوّل الذي تشهده الفتوى اليوم لا تفرضه كثرة النوازل فحسب، بل يفرضه تغيّر طبيعة العالم ذاته: عالم تتسارع فيه الوقائع، وتتداخل فيه الحدود، وتُستدعى فيه النصوص خارج سياقاتها لتغذية الخوف أو تبرير العنف أو شرعنة الفوضى. في هذا المناخ، تصبح الفتوى ميدانَ صراعٍ على الوعي، لا مجرد خلافٍ فقهي. ومن هنا، فإن تنظيم دار الإفتاء للمؤتمرات والندوات التي تتناول قضايا المسلمين المستقبلية لا ينفصل عن سؤالٍ أعمق: كيف نُعيد للفتوى وظيفتها الأصلية باعتبارها أداةَ ترشيدٍ لا وسيلةَ تعبئة، وضمانَ استقرارٍ لا خطابَ توتير؟
المقاربة المقاصدية التي تنفتح بها هذه المؤتمرات على قضايا الواقع الإنساني لا تُحيل المقاصد إلى شعاراتٍ عامة، بل تُعيدها إلى موقعها الطبيعي: ميزانًا للفهم، وضابطًا للتنزيل، وحارسًا للمآلات. فالفتوى التي لا تنظر في آثارها الاجتماعية، ولا تزن نتائجها السياسية، ولا تستحضر كرامة الإنسان بوصفها مقصدًا كليًا، تُغامر بأن تتحول من خطاب هداية إلى أداة اضطراب. لذلك، كان التركيز على إعداد المفتي القادر على الجمع بين المعرفة النصية، والفهم الواقعي، والوعي الأخلاقي، هو المدخل الطبيعي لأي حديث جاد عن مستقبل الإفتاء.
إنّ أخطر ما تتعرض له الفتوى في عصرنا ليس الاختلاف، بل الاختطاف: اختطافها من قبل جماعات تُفرغها من شروطها العلمية، وتحوّلها إلى لغة تهويل، أو إلى وقودٍ أيديولوجي، أو إلى فتاوى صادمة تُنتج الضجيج بدل الفهم. ومواجهة هذا الاختطاف لا تتمّ بالمنع ولا بالتخويف، بل بإعادة تأسيس الخطاب الإفتائي على قواعد المسؤولية، والتمحيص، وربط الحكم بمقاصده، وربط المقاصد بحفظ الإنسان في دينه ونفسه وعقله ومجتمعه. من هنا، تكتسب مبادرات دار الإفتاء، عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعدًا عالميًا يتجاوز الخصوصية القطرية، ليؤسس لتضامن معرفي بين المؤسسات الإفتائية في مواجهة الفوضى العابرة للحدود.
هذا البعد العالمي لا يعني توحيد الفتاوى ولا صهر الخصوصيات، بل يعني توحيد المعايير الكبرى: معيار ضبط الفتوى، ومعيار وعي المفتي بواقعه، ومعيار تقديم السلم الأهلي على منطق الإثارة، ومعيار جعل الكرامة الإنسانية أصلًا لا تابعًا. فالفتوى التي تُبنى على هذا الأساس لا تُخاصم الدولة، ولا تُبرر الاستبداد، بل تُسهم في بناء علاقة راشدة بين الدين والمجتمع، قوامها الثقة لا الصدام، والمسؤولية لا الادّعاء.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور العلمي والمؤسسي لمفتي جمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور نظير محمد عيّاد، بوصفه حاملًا لهذا التصور الجامع: تصورٍ يرى في الإفتاء وظيفةً عمومية ذات أثرٍ مباشر في الأمن الفكري والسلم المجتمعي. ليس من حيث السلطة، بل من حيث القدرة على جمع العلماء، وتوجيه النقاش، ووضع القضايا الكبرى على طاولة البحث الرصين، بعيدًا عن التبسيط المخل أو الخطاب الانفعالي. إنّ حضور المفتي في هذا السياق ليس حضور شخص، بل حضور منهجٍ يُعيد الاعتبار للعقل الإفتائي المتزن، القادر على قول «لا» حين تقتضيها المقاصد، وعلى قول «نعم» حين يخدم ذلك الإنسان والمجتمع.
إنّ الحديث عن الأمن والسلم في خطاب الفتوى، كما تطرحه هذه المبادرات، لا يُقصد به إسكات الأسئلة ولا تعطيل النقد، بل على العكس: يُقصد به حماية المجال الديني من أن يتحول إلى ساحة صراعٍ مفتوح، تُستباح فيه النصوص وتُستنزف فيه القيم. فالسلم هنا ليس غياب النزاع، بل حضور المعنى، والأمن ليس رقابةً على الفكر، بل طمأنينةً معرفية تُمكّن الإنسان من أن يفهم دينه دون خوف، وأن يختلف دون أن يُخوَّن.
بهذا المعنى، يمكن القول إن دار الإفتاء المصرية تسير في اتجاه إعادة تعريف الفتوى بوصفها «اجتهادًا في المآل» قبل أن تكون حكمًا في الحال، و«مسؤوليةً عن المستقبل» قبل أن تكون جوابًا عن الماضي. إنها محاولة واعية لنقل الفتوى من منطق الاستهلاك السريع إلى منطق البناء الطويل، ومن ردود الأفعال إلى تأسيس رؤية، تجعل من الدين قوةَ استقرارٍ أخلاقي، ومن العقل شريكًا أصيلًا في فهمه وتنزيله. وفي هذا العبور الهادئ، تتشكل ملامح عقلٍ إفتائيٍّ جديد، لا يخاصم عصره، ولا يتنازل عن أصوله، بل يسعى إلى أن يكون شاهدًا على الإنسان، لا شاهدًا عليه.