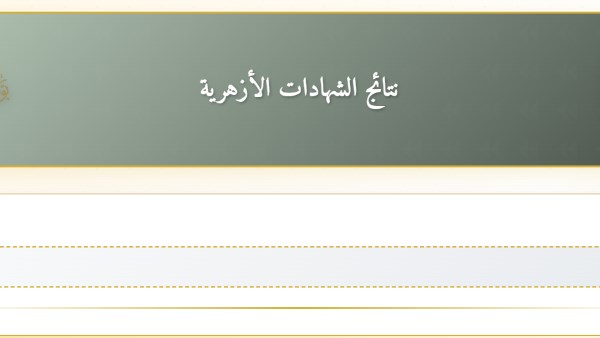الذكاء الاصطناعي أيقظ الوعي العام لأخطار تكنولوجيا تبدو عصية على فهم صانعيها وكيفية تحكمهم فيها إذا تمادت واستشرت وتفوقت على العقل البشري. لكنها يقظة واهمة لأنها تعيد نظم القصيدة بنفس البحور والكلمات، أي أنها تستبصر الخطر بمنطق تكنولوجي وتبحث عن وسائل لدرئه تارة بمزيد من التوغل في تقنياته، وتارة بالمناداة بوقف الأبحاث الهادفة لتطويره كلية بلا مجيب.
السؤال الأساسي والأهم لا ينحصر في تأمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الانحراف أو كيفية السيطرة على خطر غامض مجهول، وإنما السؤال هو كيف نوقف تدحرج البشرية نحو مصير تسيطر عليه قوة تكنولوجيا فاسدة الجوهر تراكمت عبر ثلاثة قرون؟ هل يمكن للبشر تفكيك أسس حضارتهم الحديثة وإعادة تشييدها بمنطق أخلاقي ينهض على قيم عالمية يهتدي بها الجميع؟ أم أن هذا مجرد وهم، وكل حضارة - كما يعلمنا التاريخ - تحمل في طياتها حتمية نهايتها؟
التكنولوجيا وتحييد الأخلاق
الحضارة الحديثة نهضت على ثورة في مفهوم العلم وطرق البحث عن الحقيقة. التزم العلم بالتجربة والمشاهدة والاستنتاج وعدم قبول ما لا يمكن البرهنة على صحته بدليل مادي محسوس. باتباع هذا المنهج انحصر فهم الإنسان للطبيعة في ظواهرها المادية وتأثيراتها الحسية، وبه ابتكر أنماط التكنولوجيا المتعددة فاكتسب مقدرة التأثير والتحكم فيما كان يحسبه خارج نطاق إرادته، مما أفاده في صراعه للبقاء والسيطرة على بيئته؛ حينئذ تأكد في وعيه صحة ما يفعله وأنه لا طريق لمعرفة الطبيعة وإخضاعها لمشيئته غير النظر إليها بموضوعية بحتة تتخطى الشعور بجلال الكون والإحساس بجمال صنعته وإتقان تنسيقه، فيرى ألوان الأزهار مجرد ترددات للضوء وينظر لبهاء القمر كانعكاس لأشعة الشمس على سطح صخري. وعلى نفس السياق حيدت موضوعية العلم الجانب الأخلاقي في البحث عن حقائق الطبيعة، فالفضيلة الوحيدة التي يتمسك بها العلم هي البرهان المادي على صحة الاكتشاف.
وحين انتقل البحث العلمي ليستكشف الكيان العضوي والنفسي للإنسان ذاته ثار سؤال حول موضوعيته وحيادية حكمه، وذلك لاختلاط ذات الإنسان بموضوع بحثه. ولم تدم حيرة العلماء في تعريف ماهية جسد الإنسان في ظل التكنولوجيا الطبية الحديثة؛ فهو حشد من الخلايا تحكمها قوانين الكيمياء والفيزياء الحيوية، أو هو مجموع أجزاء يمكن تفكيكها لعظام ووشائج وأنظمة من الأنابيب، أو هو طراز من ماكينة مزودة بمضخة القلب لدفع الدماء في الأوعية ورئتين كنظام للتهوية وكليتين كنظام للتنقية ومخ كنظام للتنظيم والتحكم..؟
ولا شك أن التكنولوجيا غيرت من نظرتنا لأنفسنا والعالم الذي نسكنه. ففي القرن الحادي والعشرين بدأ خلط المكون البيولوجي للإنسان بتكنولوجيا الكومبيوتر، سواء في صنع الروبوتات أو معالجة أدمغة البشر. كما كشف العلم أسرار تكاثر الإنسان وقدمت التكنولوجيا الوسائل لفصل خلق المواليد في رحم أمهاتهم عن حتمية التقاء الذكر بالأنثى جنسيًا للإنجاب الطبيعي.
التكنولوجيا قوة دافعة في ذاتها تهيمن على سكنات وحركات البشر في كل لحظة من اليوم، ليس بمعداتها وآلياتها وحواسبها وروبوتاتها فقط، ولكن بمنطق عملها المادي البحت الذي لا تحده حدود. وأصبح اختيار نمط حياة لا يعتمد على التكنولوجيا ولو جزئيًا معوقًا للحضارة الحديثة. وهذا بطبيعة الحال يقلص من الحرية الحقيقية للإنسان ويغلب خيار التكنولوجيا على إرادته، ويغلف رؤيته الأخلاقية بضباب كثيف من الشك.
هل يمكن إيجاد مخرج من هذه الكارثة يركز انتباهنا على قيمة الحياة الإنسانية بفضائلها وأخلاقها، مخرج لا يعود بالبشرية للعصر الحجري، وإنما يصحح الأسس التي تنهض عليها التكنولوجيا المعاصرة، فلا تقف البشرية عاجزة أمام ماكينات من صنعها ولو اتصفت بأي درجة من الذكاء؟
الأخلاق لم تنقرض بعد
على الرغم من التهديد التكنولوجي لدور الأخلاق في حياة البشر لا يمكن الجزم بتواري هذا الدور واضمحلاله تمامًا، مع أن نظرة سريعة على واقع العالم المضطرب بالحروب والعداءات تبعث على اليأس.
المشاعر الإنسانية لم تخب في النفوس، فلا يزال هناك من تفزعه مصائب الآخرين وينشط لتقديم العون سواء على مستوى الأفراد أو الدول والشعوب، وعلى الرغم من تفشي الظلم والاضطهاد وانتشار العنصرية البغيضة بكل أشكالها في السر والعلن نجد من يخترق أستارها ويكشف وسائلها ويلاحق سدنتها وينقذ من يستطيع من ضحاياها.
الأخلاق ليست معادلة حسابية يمكن دمجها في لوغاريتم ماكينة صماء لا شعور لها، فالإنسان هو القادر على التعاطف مع أخيه الإنسان وكافة الكائنات الحية، وطالما بقيت المشاعر تحرك الضمائر والقلوب فوجود الأخلاق لا شك فيه، وإنما تُلقي التكنولوجيا ظلالًا كثيفة تحجب عن تلك المشاعر مجال تفاعلها واتصالها بالآخر.
لماذا تلتزم الدول بنهج صناعي لتقدمها يماثل النهج الغربي المحيّد للفضائل والأخلاق الإنسانية، الهادف للربح وتراكم الثروة، القائم على المنافسة التجارية الشرسة، ولا تتخذ نهجًا جديدًا يعلي من قيم التعاون والمساندة والمساواة ومحاربة الفقر والجهل؟ هل نسي الإنسان مكونه الروحي فلا يهمه سوى الغنى المادي وبناء القصور وامتلاك الطائرات؟ ما معنى استحواذ فرد واحد على مئات البلايين من الدولارات، والسطوة على حياة الآلاف من بني جنسه في نسق جديد للعبودية والاسترقاق؟ هل نصف ذلك تقدمًا إنسانيًا؟
القيم والفضائل جزء جوهري من الطبيعة الإنسانية لا يرتبط بعصر أو زمن، بدونه يهبط تصنيف الإنسان من أرقى الكائنات الحية لأدناها. ارتباط الضمير بمفهوم الصواب والخطأ لم ينقطع في أحلك اللحظات وأشدها تعقيدًا، ومهما ارتكب المرء من أخطاء أو زلت قدمه إلى مطلق الشر يظل في أعماقه بصيص من هدي الضمير إلا إذا تشوهت طبيعته الإنسانية إلى حد السقم.
إن العتمة الأخلاقية التي تهدد الوجود الإنساني هي نتيجة واضحة لتسليمنا المطلق لمادية العلم الحديث وعدم قبول أي حقيقة لا يثبتها منهجه واتخاذه المصدر الوحيد لفهمنا للواقع وقبوله حكمًا على مكوننا الروحي، وهي نتيجة حتمية لخضوعنا لمغريات التكنولوجيا وتصديقنا لما تعد به من مستقبل ينفذ بنا من أقطار الأرض نتحول فيه إلى كائنات خارقة تقهر محددات الوجود. الظلمة تغشى النفوس حين تبهت معالم الحقيقة وتتحول لوهم وزيف، وهذا من أخطر تداعيات أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوعي الإنساني.
يقول ماركوس جبريل في كتابه "التقدم الأخلاقي في الأوقات المظلمة": نتيجة للتقدم التكنولوجي القائم على العلم أفرز مجتمعنا المعرفي المعاصر أنظمة تعترض تقدمنا الأخلاقي، وذلك بتقويض إيماننا بالحقيقة والمعرفة والواقع والضمير عن طريق الأخبار المزيفة والرقابة الرقمية والدعاية والحروب المعلوماتية. هذا هو لغز عصرنا المحير والتناقض الذي نواجهه، ولهذا من الضروري الإسراع بوضع مفهوم مناسب للوجود الإنساني يكون محوره البصيرة الأخلاقية، لكي نتمكن من تصحيح الخلل.
الإرادة الإنسانية وتكنولوجيا جامحة
إذا كانت الفضائل والقيم الإنسانية لم تندثر، وإنما تحوم في وعي البشر، تستنفرها من الذاكرة الخطوب والجوائح مثل المجاعات والأوبئة، فلماذا إذن يصمت معظم الناس عن عالم يموج بالظلم والاستغلال والعدوان، ماضيًا بثبات نحو تدمير ذاته؟ هل هو جنوح الفرد للمهادنة ابتغاء لحياة مادية هادئة، أم هو تظاهر بانعدام الرؤية والجهل بما يدور حتى لا يصيبه الهلع ويستيقظ ضميره فيحثه على الفعل والمقاومة؟ وإذا كان اكتساح التكنولوجيا بتطبيقاتها المتعددة لحياة الناس لم يترك لهم لحظة في يومهم يتأملون فيها واقعهم وما سيؤول إليه مصيرهم، فأين احتجبت إرادتهم لوقف هذا الزحف ولماذا قنعوا بتحييد أخلاقهم جراء اللهث خلف كل اختراع جديد؟ والأهم من كل ذلك كيف تسترد المجتمعات البشرية جميعها إرادة الفعل لتحفظ عليها مكونها الروحي وطبيعتها الإنسانية؟ وهل هذا ممكن الحدوث؟
إرادة الفرد هي أساس أي تقدم أخلاقي، لأنها تتصدى لطغيان ما اعتاده من خطأ، وتعيد لضميره نبراس القيم، فينتبه للزائف ويرفض الانصياع لمنظومة إعلامية إعلانية جهنمية تتسرب بتأثيرها المدمر في وعي ولاوعي من يستسلم لإغراءاتها. إذا انتبه الفرد لعدم ضرورة اقتناء كل جديد سواء كان سيارة أو تليفون أو دراجة أو غير ذلك، وأنفق ما توفر له من وقت وطاقة ومال في تلبية حاجاته المعرفية وإذكاء نشاطه الروحي، لوجد طريقًا لسلامه مع نفسه والآخرين، وأعطى نموذجًا يحتذيه غيره في فرض الإرادة الإنسانية على جموح التكنولوجيا بكل صورها. وإذا تكرر ذلك في كل مكان قويت إرادة المجموع وتصدت لزحف الماكينة مصطنعة الذكاء وتوغلها في كل أوجه الحياة. التقدم الأخلاقي المنشود تحوجه إرادة الفرد الواعي بما يدور حوله من حركة سالبة لحريته، ومن ثم يرتبط الوعي بالإرادة في حركة الفعل، وهذا لا شأن له بقوة سياسية حاكمة.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن مفهوم الأخلاق في حضارة الإنسان الحديثة لا يستقي جدارته ومصداقيته من الميتافيزيقا ووثائق تنزلت من الغيب كما كان الحال من قبل، وإنما يرتكز على أسس فلسفية ودراسات أنثروبولوجية وما يقدمه علم النفس الحديث من تحليل لأنماط السلوك البشري وما يكتشفه علم الأعصاب من أسرار بيولوجية المخ ومنشأ الوعي والشعور والإرادة. وهذا يجرد الإنسانية من أي سند إلهي لمنظومة قيمها أو يحررها منه، لتنحصر الأخلاق بين منهج العلم الحديث يخضعها لموضوعية بحثه وبراهينه المادية، وبين تطبيقات تكنولوجية جامحة تدفع بالأخلاق في ثنايا الذاكرة.
وبهذا تزداد صعوبة الدور الأخلاقي المنوط بالفرد وتتعقد مسؤوليته الأخلاقية ليجد نفسه بين خيارين؛ إما أن يستنهض إرادته ويشحذ عزيمته للنهوض بدوره وتحمل مسؤوليته مهما كلفه ذلك من معاناة متخذًا مثلًا أعلى لكفاحه عظماء الروح من البشر في كل العصور الذين حاولوا هداية الإنسانية من إضلال المادة، وإما أن يظل مفتونًا كسائر الملايين في كل بقاع الأرض بما تقذف به التكنولوجيا من فيض المخترعات، تقايضه شيئًا من حريته مع كل جديد يهفو لامتلاكه، وهو الاتجاه السائد لأنه الاختيار الأسهل والأرغب للنفس.
هل ما ننتظره من صحوة الضمير الإنساني وتوحيد خطو البشرية نحو جادة الصواب بما ينقذها من تهديد التكنولوجيا بفنائها ممكن الحدوث؟ ربما يرى البعض أن الأوان قد فات، وأن ما يمكن فعله لدرء الخطر غير مجدٍ والنهاية آتية لا مفر منها، والواقع يؤكد رؤيتهم بلا جدال، لكن إذا كان هناك فرصة وإن بدت مستعصية؛ فهل نحجبها عن عقولنا، ولو تطلبت جهدًا واستغرقت وقتًا؟
يمكن إنقاذ الإنسانية!
الخير في الطبيعة البشرية، مهما بدا الواقع محبطًا والشر زاحفًا على إرادة الفعل خانقًا لواعز الضمير. هناك فئة من البشر تتواصل مع العقول والمشاعر في كل أنحاء الأرض ولديها قدرة مؤكدة على تنوير العامة والتأثير في أفكارهم ورؤاهم، فلا ينحصر الوعي بخطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في فقدان الوظائف ولكن يستبين الخطر الأعمق والأكثر تهديدًا من تكنولوجيا غيبت الإرادة الأخلاقية لتسيطر غريزة الاستهلاك على النفوس وتنطلق الرغبة في التملك بلا حدود.
ولكن ثورة للإنسانية ضد العبودية التكنولوجية كالتي ننادي بها، لا يضطلع بها بضع فئات من البشر مع الأهمية القصوى لدورهم، وإنما تتطلب انتفاضة الجموع من الناس في كل مكان. فكل إنسان عليه مسؤولية تجاه حفظ نوعه والارتقاء به، وتعظم هذه المسؤولية في مواجهة خطر الانقراض أو الانحدار. وفي عصرنا الحاضر يهددنا خطر التكنولوجيا بما نعلمه وبما نجهله، فهي لحظة في تاريخنا تستوجب من كل فرد أن يسهم بما يستطيعه من جهد لدرء هذا الخطر. وكما انتبهنا لأخطار تغير المناخ على وجود الحياة فوق سطح الأرض واتخذنا خطوات لتصحيح ما أخطأناه من أفعالنا لنتصدى لتلك الأخطار، يمكننا أن ننتبه من إغفالنا لأهمية الجانب الروحي في كينونتنا، فنلبي احتياجاتنا الأخلاقية التي حيدتها التكنولوجيا ورسّبتها في أعماق الذاكرة، بينما هي جزء جوهري من طبيعتنا الإنسانية لا يمكن إخفاؤه.
في سبيل ذلك يجب أن تتوحد الجهود وتتراكم المعارف ونفكر معًا كجنس بشري واحد لا يتميز فيه فرد بلونه أو جنسه أو عرقه أو نفوذه التكنولوجي، لأن الهدف هو إنقاذ الإنسانية.