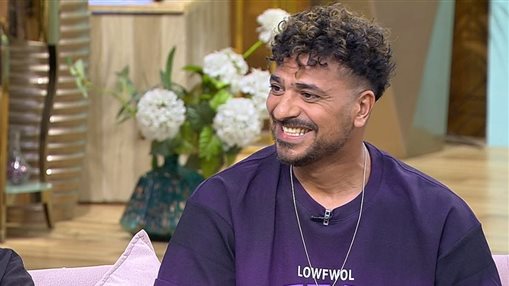حين يلتقي الحجر بالزمن، وتُعاد كتابة التاريخ بلغة الضوء والمعمار، يظهر المتحف المصري الكبير كأعظم شهادة على أن مصر لا تحفظ ماضيها في الذاكرة فقط، بل تُعيد بعثه في الحاضر لتمنحه حياة جديدة.
فكرة هذا الصرح لم تكن قرارًا إداريًا أو مشروعًا سياحيًا، بل كانت حلمًا حضاريًا بدأ في نهاية تسعينيات القرن الماضي، حين أدرك علماء الآثار والمسؤولون أن المتحف المصري العريق بالتحرير، الذي تأسس عام 1902، لم يعد قادرًا على استيعاب كنوز الفراعنة المتزايدة، وأن القاهرة الحديثة تستحق متحفًا يليق بتاريخها الممتد لسبعة آلاف عام.
في عام 1992 بدأت المناقشات الأولى حول إنشاء متحف عالمي على مقربة من أهرامات الجيزة، بحيث يكون بوابة حضارية جديدة تربط بين مصر القديمة ومصر المعاصرة. وفي عام 2002 وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك حجر الأساس للمتحف المصري الكبير، ليبدأ بذلك مشروع القرن الثقافي، بتكلفة تقديرية تجاوزت آنذاك 550 مليون دولار، تم تمويلها من الحكومة المصرية ومنح دولية، على رأسها منحة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) التي ساهمت لاحقًا في دعم التصميم والتنفيذ.
أُقيم المتحف على مساحة شاسعة تبلغ نحو 480 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة مدينة صغيرة، بين طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي وهضبة الأهرامات، بحيث يُمكن للزائر أن يرى الأهرامات من داخل قاعات العرض عبر واجهة زجاجية عملاقة طولها نحو كيلومتر.
فاز بتصميم المتحف المهندس الإيرلندي هينغان ماك مورو، الذي تفوّق على أكثر من 1500 تصميم عالمي في مسابقة معمارية دولية، وجاء تصميمه مستوحى من المثلثات الفرعونية التي تعكس الضوء والظل في تناغم مذهل، حيث تمتد الواجهات الحجرية بزوايا تحاكي أشعة الشمس عند الغروب خلف الأهرامات، وكأن المتحف نفسه يستمد طاقته من تاريخ الأرض التي يقف عليها.
منذ عام 2010 بدأت المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية الضخمة، التي واجهت تحديات فنية واقتصادية وسياسية، خاصة بعد أحداث يناير 2011 التي عطلت بعض مراحل التنفيذ. إلا أن المشروع لم يتوقف، بل استمر بدعم الدولة، وأُعيد تنشيطه بقوة بعد عام 2014 مع انطلاق خطة التنمية الشاملة، ليصبح المتحف أحد رموز الجمهورية الجديدة.
وقد بلغت التكلفة النهائية للمشروع ما يزيد على مليار دولار، منها نحو 800 مليون دولار تمويلًا يابانيًا على هيئة قرض ميسر، ما يعكس حجم التعاون الدولي حول هذا الصرح الثقافي الفريد.
وفي قلب المشروع يقف تمثال الملك رمسيس الثاني، أحد أعظم ملوك مصر القديمة، كأنه الحارس الأبدي لبداية الرحلة. كانت قصة نقل هذا التمثال من ميدان رمسيس إلى موقع المتحف ملحمة في حد ذاتها.
وُجد التمثال في بدايات القرن العشرين بقرية ميت رهينة قرب منف، عاصمة مصر القديمة، وتم نقله عام 1955 إلى ميدان رمسيس أمام محطة القطار ليكون رمزًا للعاصمة الحديثة. ومع مرور نصف قرن، تعرض التمثال لأضرار بسبب التلوث واهتزازات المترو والسيارات، ما دفع علماء الآثار والمهندسين إلى التحذير من خطر بقائه في موقعه القديم.
وفي 25 أغسطس 2006، انطلقت عملية النقل التاريخية للتمثال، في حدث تابعه ملايين المصريين والعالم أجمع.
استخدمت فرق العمل آنذاك شاحنة عملاقة مزودة بمعدات امتصاص للاهتزازات، صُممت خصيصًا لتحمل وزن التمثال الذي بلغ نحو 83 طنًا، بطول 11 متراً.
واستغرقت رحلة نقله من الميدان إلى المتحف، لمسافة تزيد على 30 كيلومترًا، أكثر من 10 ساعات متواصلة، بسرعة لم تتجاوز 8 كيلومترات في الساعة، بمرافقة علمية وهندسية دقيقة شارك فيها أكثر من 150 خبيرًا من وزارات الآثار والنقل والدفاع والبيئة.
وعندما وصل التمثال إلى موقعه أمام بوابة المتحف، بدا المشهد كأنه عودة للملك العظيم إلى عرشه الأبدي في مواجهة الأهرامات، حيث يقف اليوم شامخًا ليستقبل الزوار القادمين من أنحاء العالم.
أما داخل المتحف، فالقصة الأعظم هي قصة الملك الذهبي توت عنخ آمون، الذي حكم مصر في أواخر الأسرة الثامنة عشرة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، واكتُشفت مقبرته الكاملة تقريبًا في وادي الملوك عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، في اكتشاف اعتُبر الأعظم في تاريخ علم المصريات.
ضمت المقبرة أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية مذهلة، من بينها القناع الذهبي الشهير، والعرش الملكي، والعجلات الحربية، والأواني المذهبة، والمجوهرات الدقيقة التي أذهلت العالم بدقتها وفخامتها.
طوال قرن كامل، ظلت هذه الكنوز متناثرة بين المتحف المصري بالتحرير والمخازن الأثرية، وبعضها جاب معارض عالمية في باريس ولندن ونيويورك وطوكيو.
لكن المتحف المصري الكبير جمعها كلها للمرة الأولى في مكان واحد، حيث خُصصت لها قاعة عرض تمتد على مساحة 7500 متر مربع، صُممت لتُحاكي رحلة الملك في الحياة الآخرة، بدءًا من مقتنياته اليومية حتى تابوته الذهبي، في عرض سينوغرافي يجمع بين التكنولوجيا والإضاءة والموسيقى التاريخية.
وقد نُقلت القطع على مدار خمس سنوات، بدأت عام 2016، عبر عشر بعثات أثرية متتالية، وتم ترميم أكثر من 5000 قطعة في معامل المتحف الحديثة، التي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتستخدم تقنيات الموجات فوق الصوتية والليزر للحفاظ على المعادن والذهب والمنسوجات القديمة.
افتتاح المتحف المصري الكبير لم يكن مجرد مناسبة ثقافية، بل حدث وطني ورسالة حضارية إلى العالم.
فقد أُعلن أن المتحف سيستقبل نحو خمسة ملايين زائر سنويًا في مراحله الأولى، مع طاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى ثمانية ملايين زائر.
ويضم بجانب القاعات المتحفية مناطق تعليمية للأطفال، ومكتبة أثرية رقمية، وسينما بانورامية ثلاثية الأبعاد تحكي تطور الحضارة المصرية عبر العصور.
كما يحتوي على مركز ترميم دولي يستقبل بعثات من مختلف الدول لتدريب المتخصصين في علوم حفظ التراث.
إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى للحجر، بل معبد جديد للهوية.
هو الجسر الذي يربط بين طاقة الخلود في الماضي وإرادة النهضة في الحاضر.
ومن يقف أمام تمثال رمسيس أو أمام قناع توت عنخ آمون الذهبي، يدرك أن ما فعله المصري القديم منذ آلاف السنين لا يزال يحكم وجدان المصري الحديث.
فالفراعنة لم يبنوا مجرد مقابر، بل بنوا فلسفة في مواجهة الفناء، والمتحف اليوم يُعيد تأكيد هذه الفلسفة من خلال لغة العلم والفن والتكنولوجيا.
وفي زمن تتعرض فيه الأمم لمحاولات طمس الذاكرة وتشويه الانتماء، يجيء المتحف المصري الكبير كرمز مقاوم للمحو الثقافي، ودليل على أن الوعي بالتراث هو أول سلاح لحماية الهوية.
فحين يعرف المصري من هو، ويستحضر ما أنجزه أجداده في وجه المستحيل، لا يمكن لأي قوة أن تفرغ وطنيته من معناها.
المتحف ليس مجرد مكان تُعرض فيه الآثار، بل مساحة يستعيد فيها المصري وعيه بذاته، ويكتشف أن كل حجر من أحجار الحضارة القديمة ما زال ينطق باسمه ويُعيد تذكيره بما كان وما يجب أن يكون.
ومن هضبة الأهرام، حيث يتقاطع الأفق بين الشمس والذهب والحجر، تهمس مصر للعالم من جديد:
أنا التاريخ الذي لا يشيخ، وأنا الذاكرة التي لا تنطفئ.