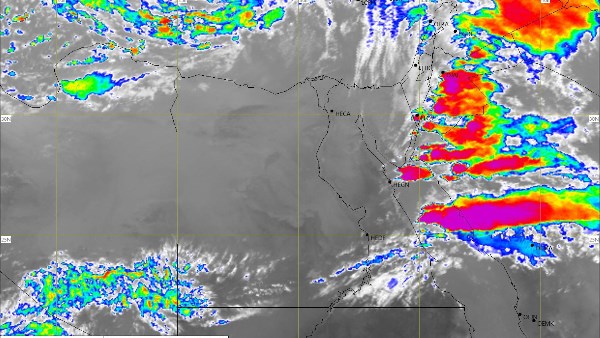محمد ﷺ وخديجة .. علاقة تتسامى عن دنس الجاهلية

لو أنَّ قلمًا منصفًا تتبَّع حياة محمد ﷺ منذ ولادته إلى أن بعثه الله رحمة للعالمين؛ ليضعها في إطار يجمعُ بين ألوانها، ويُوحِّدُ بين أحداثها: لأخرج للحياة صورةً إنسانية فطرية تُمثِّل شخصًا تولَّاه الله تعالى فأدَّبه، وربَّاه فكمَّله، ورعاه فحفظه مما كان يغمُر حياة قومه من وثنيَّة وعادات مسترذَلة؛ حتى غدا أكمل إنسان، لم يستطع أحدٌ أن يَربيَهُ في حياته أو يَصِمَ شبابَه بنقيصة، على كثرة الخصوم والأعداء والمتربِّصين.
وعلى الرغم من أن السِّيَر والتاريخ لا تخضع لمناهج المحدِّثين وطرقهم في النَّقد لمعرفة الصحيح والضعيف؛ إذ لا يترتب عليها شيء من الاعتقاد أو العمل أو معرفة الحلال والحرام، فإن مهرة العلماء النُّقاد قد تلقَّوا ما دوَّنه المؤرخون والرُّواة مما تناهت إليهم به الأحداث والوقائع من سيرته ﷺ؛ فتخيَّروا وحقَّقوا وتثبَّتوا، ودرسوا حياته ﷺ دراسة الناقد الموضوعي الذي لا يبتغي عن المنهج العلمي بديلًا، فجلَّوْا للناس وقائع السِّيرة النبوية ناصعةً عطِرة.
ومع ذلك لا يزال بعض الصُّحُفيين الأغمار، الذين اغتروا بحديث العصرية، وتفاخروا بشعار التجديد، وتظاهروا بحرية الرأي، وهم في الحقيقة أتباع لدعاوى المستشرقين من ذوي الثقافة الفَجَّة، والمعرفة الضَّحلة، يتصيَّدون من غثاء الروايات والأقاصيص ما يُرضي أحقادهم، متمسِّكين بكلِّ ما يَخدِش وجه الحقيقة التاريخية زورًا وبهتانًا، متأوِّلين بأهوائهم وسوء مقاصدهم أحداثًا كانت في السِّيرة المطهَّرة عنوانات الشَّرف والنُّبل، ليقلبوا حقائقها، ويُغيِّروا معالمها، ﴿يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم﴾ [التوبة: 32].
لقد طالعنا أحد الكتاب في إحدى الجرائد المتخصصة في إثارة الشبهات حول الدين الإسلامي بمقال عجيب، استعرض فيه حادثة زواج النبي ﷺ من مولاتنا خديجة، فشَطَّ به قلمه، حتى أبعده عن حكمة العقل، وصواب المنطق، وقواعد العلم، وركب رغبة نفسه، فزلَّت به إلى حضيض السَّفاهة؛ إذ ليست الرغبات النَّفسية بأقلّ شرًّا من الشَّهوات.
راح الكاتب يستشكل في بداية مقاله الاختلافَ الواقع بين الروايات في تحديد من تولى تزويج السيدة خديجة من النبي ﷺ، أهو عمها عمرو، أو أبوها خويلد، أو ابن عمها ورقة، أم أنها زوَّجت نفسها؟
مع أنَّ أثْبَتُ الروايات في ذلك وأوفاها، هي رواية الواقدي ـ وهو حجة في السير والمغازي ـ عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى: 1/132»، وهي صريحة في أن الذي زوَّجها منه ﷺ هو عمُّها: عمرو بن أسد، وأن أباها خويلد مات قبل «حرب الفِجار».
ولإن كان الزُّهْري في «المغازي النبوية: ص42»، وابن إسحاق في «السِّير والمغازي: 1/81» يريان أن الذي زوَّجها هو أبوها خويلد، وهو ما رجَّحه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري: 7/134»؛ اعتمادًا على ما ذكره البلاذري في «أنساب الأشراف: 1/102»، وابن حبيب في «المحبَّر: ص17» من أن خويلد بن أسد كان زعيم قومه في «حرب الفِجار».
فإن ابن سعد في «الطبقات: 1/132» يذكر تعقيب شيخه الواقدي على هذه الروايات بقوله: «هذا كله عندنا غلط ووَهْل ـ أي: وهم وضعف ـ والثبْت عندنا المحفوظ عن أهل العلم: أن أباها خويلد بن أسد مات قبل «الفِجار»، وأن عمَّها عمرو بن أسد زوَّجها رسول الله ﷺ».
لكن الكاتب المحترم يعود ليذكر ما رواه أحمد في «المسند: رقم 2849»، والطبراني في «المعجم الكبير: رقم 12838»، من طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، فيما يحسب حماد، في قصة حاصلها أن السيدة خديجة سقت أباها خمرًا؛ ليوافق على زواجها من رسول الله ﷺ، وأنه لما أفاق من سكره اعترض على زواجهما وسعى في إبطاله، قائلًا: «أنا أزوج يتيم أبي طالب، وقد خطبك أكابر قريش فلم أفعل؟!».
وهي محاولة بائسة من الكاتب أن يوهم القراء بأن رسول الله ﷺ تزوج خديجة رغمًا عن أهلها، وبأسلوب فيه مكر وخديعة لا تليق بالرجال الأحرار، وأنه كان في منزلة أقلَّ من منزلة خديجة، وأن أهله لم يكونوا في درجة أهلها شرفًا ونبلًا. والكاتب في هذا ليس أكثر من بوقٍ يردِّد ما قاله ـ من قبل ـ المستشرق الفرنسي إميل دِر منغمEmile Dermenghem في كتابه The Life of Mahomet.
لكن فاته أن هذا الحديث معلول بثلاث علل: فقد شك حماد في وصل سنده؛ إذ كلُّ من يرويه عنه يقول: «فيما يحسب حماد»، ولم يجزم. ثم تبين أنه قد دلَّسه فأسقط من سنده راويًا؛ فقد رواه البيهقي في «دلائل النبوة: 2/71» عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، فعاد الحديث إلى علي بن زيد، وهو ضعيف. مع ما لعلماء الجرح والتعديل من كلام في حفظ حماد وضبطه؛ فإنه لما كبر ساء حفظه واختلط، ومثل هذه العلل تسقط الحديث عن درجة الاحتجاج عند أهل العلم.
وقد نقلنا نقد الواقدي لجميع الروايات التي أسندت تزويج مولاتنا خديجة إلى أبيها، وهو نقد تاريخي ينسفها نسفًا، ولا يُقيم لها وزنًا، ولو لم ينهض الواقدي به: لنادى بزيفها ما فيها من تدليس وخداع تأباه أخلاق العرب عامة، وتنأى عنه مكارم محمد ﷺ وتساميه عن هذه الأساليب المدلِّسة، التي لم يُعرف عنه في حياته أنه سلك قطُّ سبيلها أو حام حولها.
فلم يبق حينئذ سوى الخلاف في تحديد وليِّها، وهو أمر هيِّن؛ فإن الناظر في الروايات المختلفة يرى أن بعضها يكمِّل بعضًا، وأن الرواة لما اختلفت مصادرهم: اختلفت عباراتهم، وأخذ كلُّ راوٍ بطرَف من القصة، وحكاه كما سمع.
ويمكن التوفيق بين الروايات بأنَّ مولاتنا خديجة لما سمعت بأمانته ﷺ، أرسلت إليه نُفَيسةَ بنتَ أمية تختبر رأيه، فلما وافق وجاء بأهله ليخطبها: تكلَّم عمه أبو طالب، فأجابه على خطبته ابن عمها ورقة، وهو من أشراف قومها وذوي أسنانهم، فلما انتهى أراد أبو طالب أن يتحدَّث عمُّها عمرو زيادة في التوثق وتأكيد الرضا، فأسرع عمها إلى ذلك.
ثم استشكل الكاتب خلاف الروايات في عمر مولاتنا خديجة عند زواجها، ففي حين تذهب رواية الواقدي عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى: 8/17» إلى أنها كانت في الأربعين، يروي الإمام الحاكم في «المستدرك: 3/182» من كلام ابن إسحاق بغير إسناد، أنها كانت في الثامنة والعشرين. في حين ينقل ابن كثير في «البداية والنهاية: 2/295» عن كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي أنها كانت في الخامسة والثلاثين، أو في الخامسة والعشرين، ولكن ما نقله ليس موجودًا في الدلائل؛ فلعله وهم منه رحمه الله.
وأيًّا كان عمرها حين زواجها، فلا أدري ما الذي يترتب على ذلك. لكن الكاتب يستشكل رواية الأربعين، بأن عمر مولاتنا خديجة حين ماتت كان خمسًا وستين سنة، وأنها تركت السيدة فاطمة وعمرها ثلاث سنوات؛ وذلك يقتضي أن تكون مولاتنا خديجة قد ولدت السيدة فاطمة وهي في الثانية والستين من عمرها، وهو ما يستحيل في معرفة أهل الطب.
ولا أدري من أين أتى الكاتب بهذه الخرافات؛ فإن الثابت في مولد السيدة فاطمة أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، فيكون عمر مولاتنا خديجة حين ولادتها خمسين سنة، ويكون عمر فاطمة عند وفاة مولاتنا خديجة خمس عشرة سنة. وفاطمة هي أصغر أبناء رسول الله ﷺ؛ وهو ما يعني أن أبناءه الستة قد ولدوا قبلها، أي ومولاتنا خديجة لم تجاوز الخمسين، والمرأة تبلغ سنَّ اليأس من الإنجاب نحو الخمسين بشهادة الأطباء، وعليه فلا مشكلة ولا تناقض في التواريخ عند من يفهم! ومع ذلك لا نحجر على من يأخذ برواية ابن إسحاق.
ثم يدعي الكاتب في اجتراء عجيب أن مولاتنا خديجة عند زواجها من رسول الله ﷺ كانت بكرًا، وأنها لم تتزوج قبله ولم تنجب، بل يدعي أن زينب ورقية ابنتي رسول الله ﷺ كانتا بنتين لأخت السيدة خديجة من رجل تميمي، وأنهما نسبتا لرسول الله ﷺ على عادة العرب لأنهما تربتا في بيته.
ولعل القارئ الكريم يتساءل: من أين جاء الكاتب بهذه الخرافات التي سوَّد بها كتابه؟ والجواب: من هناك، من (طهران)، فقد أحال الكاتب في مقاله على جملة من المصادر الشيعية، من أمثال «الكافي» للكُلَيْني، و«الصحيح من سيرة النبي الأعظم» لجعفر مرتضى العاملي، و«مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوب، و«الاستغاثة» لأبي القاسم الكوفي، و«الشافي» للشريف المرتضى، و«تلخيص الشافي» للطوسي.
ونحن والحمد لله تعالى لا نعتمد في الرواية على أيٍّ من كتب الشيعة، لا لشيء سوى انعدام أصول الرواية عندهم، فلم يكن لهم في علوم الرواية والنقل قدم ولا ساق، مع انتحالهم لكثير من هذه الكتب التي يدعون أنها أصول مذهبهم، حتى إنَّ غالبها ـ وعلى رأسها «الكافي» ـ لم يظهر قبل القرن السابع الهجري، وأكبر مثال على ذلك ما قام به عالمهم محمد باقر البهبودي، الذي ألَّف «صحيح الكافي»؛ فنسف غالب مروياته حتى لم يبقَ منها إلاَّ ما يبلغ بالكاد قدر مجلد واحد.
فيا أيها الكاتب الذي يجتزئ فقرات فقط من السيرة النبوية، وهو لم يفرغ بعد من التسليم التام بوجود الله تعالى، وبنبوة سيدنا محمد ﷺ، وبأن القرآن كلام الله المنزل عليه، خير لك ألا تغالط نفسك فتطوي مشكلتك الكبرى عن النظر والبحث، وتذهب تتساءل في فرعيات لو ظللت تتساءل عنها مدة حياتك كلها لما أقنعك أي جواب، بل ينبغي أن تعود إلى النظر في وجود الخالق، وفي نبوة سيدنا محمد ﷺ، وفي معجزاته وما يتعلق بها، فإذا انتهيت إلى الإيمان وثبتت لديك أصوله؛ فلن تجد عندئذ في تلك الفرعيات أية مشكلة تحتاج إلى بحث.