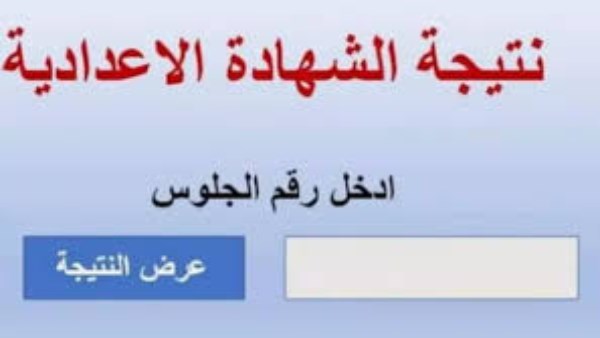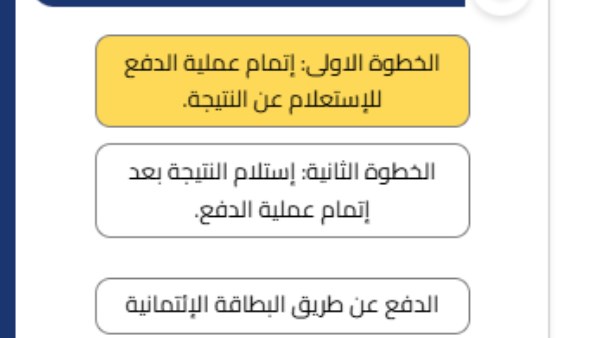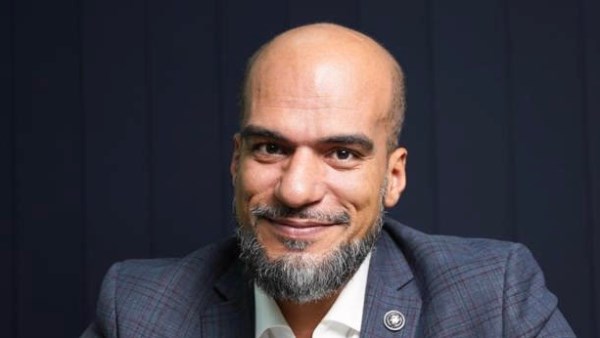قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الذِّكرُ في اللغة يعرف بأنَّه مصدرُ: ذَكَرَ الشيءَ يذكره ذِكرًا وذَكَرًا، وقال الكسائي: الذِّكرُ باللسان ضدّ الإنصات، ذاله مكسورة، وبالقلب ضدّ النسيان، وذاله مضمومة، وقال غيره: بل هما لغتان.
وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يُستعمَل في اللغة بعدة معانٍ؛ منها: جريانُ الشيء على اللسان إذا نُطِقَ باسمه وتُحُدِّثَ عنه؛ قال تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15]. ومنها: استحضارُ الشيء في القلب؛ قال تعالى: {وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} [الكهف: 63].
نقل صاحبُ «القاموس» في «بصائرِه» عن الراغب الأصفهاني قولَه: «الذِّكرُ تارةً يُراد به هيئةٌ للنفسِ بها يمكنُ الإنسانَ أن يحفظَ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظِ، إلَّا أن الحفظَ يُقال اعتبارًا بإحرازِه، والذِّكرُ يُقال باعتبار استحضارِه، وتارةً يُقال لحضورِ الشيءِ القلبَ أو القول. ولذلك قيل: الذكرُ ذكران: ذكرٌ بالقلب، وذكرٌ باللسان، وكلّ واحدٍ منهما ضربان: ذكرٌ عن نسيان، وذكرٌ لا عن نسيان، بل عن إدامةِ حفظ. وكلُّ قولٍ يُقال له ذكر. ومن الذكرِ بالقلبِ واللسانِ معًا قولُه تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا}» [البقرة: 200].
أمَّا في الاصطلاح فللذِّكرِ معنَيان: الأوّل عامٌّ، وهو يشمل كلَّ أصنافِ العبادات؛ حيث إنَّها تشتملُ على ذكرِ الله، سواءٌ كان ذلك الذكرُ بالإخبارِ المجرَّد عن ذاتِه، أو صفاتِه، أو أفعالِه، أو أحكامِه، أو بتلاوةِ كتابِه، أو بمسألتِه ودعائِه، أو بإنشاءِ الثناءِ عليه بتقديسِه وتمجيدِه وتوحيدِه وحمدِه وشكرِه وتعظيمِه. وعليه فتسمَّى الصلاةُ ذِكرًا، وتلاوةُ القرآنِ ذِكرًا، والحجُّ ذِكرًا، وكلُّ أصنافِ العبادات.
ويكون بمعنًى أخصَّ، وهو إنشاءُ الثناءِ بما تقدَّم دونَ سائرِ المعاني الأخرى المذكورة. ويشيرُ إلى الاستعمالِ بهذا المعنى الأخصِّ قولُه تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت: 45]؛ فرغم أن الصلاةَ ذكرٌ بالمعنى الأعمّ، إلَّا أن المرادَ هنا هو المعنى الأخصّ، حيث فرَّق اللهُ بين الصلاةِ والذِّكر. وكذلك قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِّ العزة: «مَن شغله القرآنُ وذِكري عن مسألتي أعطيتُه أفضلَ ما أُعطي السائلين» [رواه الترمذي]؛ وكذلك على الرغم من أن القرآنَ ذكرٌ بالمعنى الأعم إلَّا أن المرادَ في الحديثِ من الذِّكرِ المعنى الأخصُّ حيث فرَّق بينهما.