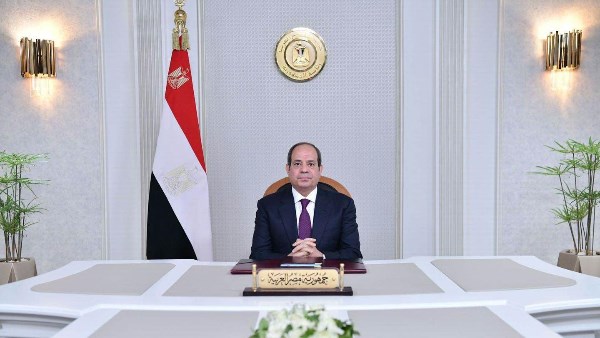في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام، كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل مأساوية حول مقتل طالب بالصف الثالث الثانوي، في واقعة بدأت بدعوى الصداقة وانتهت بجريمة قتل بشعة. التحقيقات الأولية أكدت أن المجني عليه، محمد ياسر، البالغ من العمر 17 عامًا، تم استدراجه في ساعة متأخرة من الليل إلى منزل تحت الإنشاء، حيث تعرض لاعتداء قاتل باستخدام سلاح أبيض، عُثر عليه بجوار الجثمان لاحقًا.
البلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لتتحرك على الفور قوة من مباحث مركز شرطة بنها إلى موقع الحادث بقرية الرملة، وتبدأ فصول التحقيق في واقعة سرعان ما تحولت من بلاغ غامض إلى جريمة قتل مكتملة الأركان.
هذا التقرير يرصد رواية الأب، ياسر نجيب، كما خرجت من قلبٍ موجوع، لا يدافع ولا يتهم، بل يحكي… يحكي عن ابنه محمد، وعن صديقٍ دخل حياته بهدوء، وعن ليلة بدأت بدموع وانتهت بأسئلة بلا إجابات.
محمد… طالب متفوق وحلم طبيب مؤجل
يبدأ ياسر نجيب حديثه لـ “صدي البلد” بنبرة فخر لا تخطئها الأذن. محمد، ابنه، طالب بالصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم، متفوق بشهادة الجميع. شهادات تقدير، نتائج اختبارات شهرية، معامل علمية بنتائج مبشرة، وإشادات متكررة من المدرسين. لم يكن تفوقه مجرد أرقام على ورق، بل سلوكًا يوميًا يعكس الجدية والانضباط.
يقول الأب: «كنت بزرع فيه حلم الطب من زمان، نفسي أشوفه دكتور، وكان هو كمان واعدني». لم يكن الحلم مفروضًا، بل مشتركًا، نما بين الأب والابن مع الوقت، وسط دعم وتشجيع وثقة متبادلة.
أب وصديق.. علاقة غير تقليدية
ما يميز هذه الأسرة ليس التفوق الدراسي فقط، بل طبيعة العلاقة داخلها. يؤكد ياسر نجيب أن محمد لم يكن مجرد ابن، بل صديق حقيقي. حديث مفتوح، بلا خطوط حمراء، ولا أسرار محرمة. كل ما يمكن أن يواجه شابًا في سن المراهقة، كان يُناقش داخل البيت، بوضوح وصدق.
«كنت أفضل إن ابني يعرف أي حاجة مني أنا، وأوجهه للطريق الصح، بدل ما يسمعها من حد في سنه أو يجره لحاجة تغضب ربنا»، هكذا يلخص الأب فلسفته في التربية.
البيت، بحسب روايته، كان مفتوحًا لأصدقاء محمد، مليئًا بالبهجة والألفة. لم يكن مكانًا للمنع أو التضييق، بل مساحة آمنة، يشهد عليها كل من عرف الأسرة عن قرب.
يوسف السنوسي… صديق الدراسة الذي عاد فجأة
وسط هذه الأجواء، يظهر اسم يوسف السنوسي. زميل دراسة قديم، رافق محمد في مراحل التعليم المختلفة: ابتدائي، إعدادي، وثانوي. العلاقة في بدايتها كانت عادية، لا تتجاوز حدود الزمالة.
لكن مع دخول المرحلة الثانوية، بدأ يوسف بحسب رواية الأب يحاول التقرب من محمد بشكل لافت. تودد زائد، محاولات مستمرة للالتصاق به، وهو ما قوبل في البداية برفض من محمد.
«ابني كان دايمًا رافض، لكن من حوالي سنة، يوسف بدأ يعيط، ومحمد رقّ له»، يقول الأب.
لم يقل محمد إن يوسف “دمه خفيف” أو قريب إلى قلبه، لكنه قال كلمة واحدة: «صعبان عليا يا بابا».
تردد الأب وحدود القبول
لم يكن الأب غافلًا. حاول أن يضع حدودًا واضحة. اختلاف الشُعب الدراسية (علمي وأدبي)، وعدم وجود لقاءات طبيعية بينهما في الدروس أو المدرسة، كلها علامات أثارت تساؤلاته.
كان يسأل ابنه باستمرار: «لازمته إيه؟ ما بتتقابلوش لا في دروس ولا في امتحانات». لكن محمد كان يكرر دفاعه: «محترم، وبيتخانق مع أهله، وبيصعب عليا».
وافق الأب على مضض، لكنه اشترط أن تكون العلاقة “على خفيف”، دون تعمق أو تأثير.
محمد… التدين الصامت والعمل الخفي
من أكثر ما يلفت في رواية الأب حديثه عن التزام ابنه الديني. محمد لم يكن متدينًا استعراضيًا، بل شابًا يعمل في صمت. قريب من المسجد، يساعد في تنظيفه، وغسل السجاد، وترتيب الأمور، دون أن يخبر والده.
حتى صيامه، كان طوعيًا. يصوم ثلاثة أيام، ويحرص على الاثنين والخميس. «كان عايز يتاجر مع ربنا»، يقول الأب بحرقة، مضيفًا: «ابن مات وأنا ما أعرفش عنه كل ده».
ليلة الجمعة.. حين دق الباب في البرد القارس
نصل إلى ليلة الواقعة. ليلة شتوية شديدة البرودة. الساعة تشير إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل. محمد كان صائمًا ذلك اليوم، وتسحر استعدادًا لصيام اليوم التالي.
الأم أدت طقوسها المعتادة، غطت أبناءها جيدًا، قبل أن يودعها محمد بقبلة على يدها، ويقول: «تصبحي على خير».
المنزل مكون من طابقين، الأب والأم ينامان في الأعلى، والأبناء في الأسفل. البيت مؤمن، الأبواب مغلقة بإحكام، تحسبًا للبرد أو أي طارئ.
وفجأة… طرق على الباب.
اللحظة الحرجة… ومن فتح الباب؟
يقول الأب إنه سمع الطرق وهو على السلم، نازلًا ليفتح بنفسه، خوفًا على ابنه من البرد. لكنه فوجئ بأن محمد سبقه وفتح الباب.
«قلت له فيه مين؟ قال لي ده واحد صاحبي… يوسف السنوسي».
الدهشة كانت حاضرة. «دلوقتي؟ في التلج ده؟»، يتساءل الأب.
محمد أشار له بهدوء ألا يرفع صوته، وخرج ليكلمه دقائق، ثم عاد ليخبره أن يوسف متخانق مع والده، وربما طُرد من البيت.
قرار الأب… الرحمة قبل أي شيء
لم يكن الأب قاسيًا. رغم تحفظه، وافق على أن يحاول محمد إقناع يوسف بالعودة إلى بيته وتهدئة الأمور، بشرط ألا يتأخر، خاصة أن محمد لديه درس أحياء في السادسة والنصف صباحًا.
«قلت له خلصه وخليه يمشي ويروح بيته».
محمد طمأنه: دقائق قليلة ويعود.
انتظار قلق… ونهاية مفتوحة
الأب والأم جلسا في الداخل، يحاولان التخفيف من التوتر بمشاهدة التلفاز. الأب فتح الشباك، رآهما جالسين أمام البيت. لا شيء مريب.
بعد قليل، طلب من شقيق محمد أن ينادي عليه. تحدث معه مجددًا، عرض عليه أن يأخذ عباءة ليتدفأ، لكنه رفض، مطمئنًا والده: «خمس دقايق وداخل».
الأب، رغم قلقه، صعد لينام، مستعدًا ليوم عمل جديد.
لكن الزمن مر… ومحمد لم يعد.
تنتهي رواية الأب هنا، عند لحظة الانتظار التي تحولت إلى قلق، ثم إلى فاجعة. لا اتهام مباشر، ولا استنتاجات حاسمة، فقط سرد إنساني صادق، يفيض بالألم والأسى.
حكاية محمد ليست مجرد واقعة، بل مرآة لعلاقة إنسانية نادرة بين أب وابنه، ولشابٍ عاش نظيف القلب، حسن النية، ربما أكثر مما يحتمل هذا العالم.