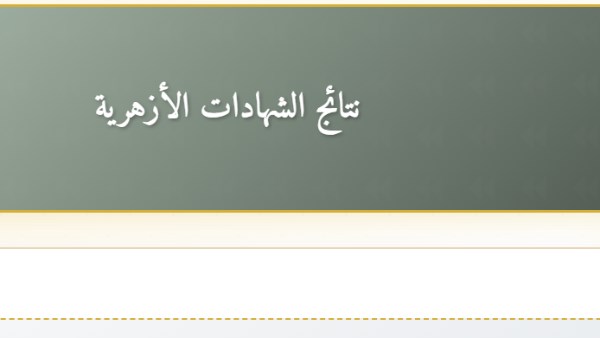لم تعد الدراما في المجتمعات الحديثة مجرد وسيلة للتسلية أو الاسترخاء بعد يوم طويل، بل تحولت تدريجيًا إلى أحد أخطر وأعمق أدوات تشكيل الوعي الجمعي، وصياغة المزاج العام، وإعادة ترتيب منظومة القيم والأفكار داخل المجتمع. فالفن الدرامي، بحكم قدرته على مخاطبة العاطفة قبل العقل، وبفضل انتشاره الواسع وسهولة استهلاكه، بات أكثر تأثيرًا من أي خطاب سياسي مباشر أو نقاش فكري نخبوي، وأقدر على النفاذ إلى العقول دون مقاومة أو تشكيك.
إن الإنسان بطبيعته كائن قصصي، يتفاعل مع الحكاية أكثر مما يتفاعل مع الأرقام أو التحليلات المجردة. ومن هنا، تصبح الدراما أداة فعالة لتوجيه الرأي العام، لا لأنها تفرض رأيًا صريحًا، بل لأنها تزرع الفكرة داخل سياق إنساني يجعلها تبدو طبيعية، بل ومنطقية. فالمشاهد لا يشعر أنه يُلقَّن، ولا يدرك أنه يتعرض لعملية توجيه، بل يظن أنه فقط يتعاطف مع بطل، أو يتأثر بمشهد، أو يتابع تطور أحداث مشوقة.
وتكمن خطورة الدراما في قدرتها على إعادة تعريف المفاهيم دون إعلان ذلك صراحة. فما يُعرض باستمرار بوصفه مألوفًا، يتحول مع الوقت إلى مقبول، ثم إلى طبيعي. وما يُقدَّم في صورة البطل، يُكتسب شرعية وجدانية، حتى وإن كان سلوكه أو فكره محل خلاف أخلاقي أو اجتماعي. وعلى الجانب الآخر، يمكن تشويه صورة قيم أو مؤسسات أو أفكار، لا عبر مهاجمتها بشكل مباشر، بل عبر إظهارها دائمًا في سياق سلبي، أو ربطها بالفساد والقهر والجمود.
وعبر التكرار، لا تعود الرسالة مجرد فكرة عابرة، بل تتحول إلى قناعة راسخة. فالعقل البشري يتعامل مع التكرار بوصفه دليلًا على الصحة أو الشيوع، ومع الزمن، يصبح من الصعب على الفرد أن يميز بين ما استخلصه من تجربة شخصية، وما زُرع فيه عبر الشاشة. وهنا، تنتقل الدراما من كونها انعكاسًا للواقع، إلى كونها أداة لإعادة تشكيل هذا الواقع داخل الوعي الجمعي.
ولا يمكن فصل الدراما عن السياق الاجتماعي والسياسي الذي تُنتَج فيه. فكل عمل درامي هو بالضرورة نتاج رؤية ما، واختيار ما، وانتقاء واعٍ أو غير واعٍ لعناصر بعينها. أي قصة تُروى؟ ومن يُمنح مساحة البطولة؟ وأي زاوية تُسلَّط عليها الكاميرا؟ وما الذي يُترك خارج الإطار؟ كلها أسئلة تعكس موقفًا فكريًا، حتى وإن اختبأ خلف ادعاء الحياد الفني.
ومن يملك أدوات الإنتاج الدرامي، يملك قدرًا معتبرًا من القدرة على التحكم في السردية العامة. فالسردية ليست مجرد حكاية تُروى، بل هي الطريقة التي يرى بها المجتمع نفسه، ويفهم بها تاريخه، ويتخيل بها مستقبله. وعندما تتكرر سردية واحدة عبر أعمال متعددة، وبأشكال مختلفة، تتحول إلى ما يشبه الإجماع غير المعلن، ويصبح الخروج عليها فعلًا شاذًا أو متهمًا بالرجعية أو الانفصال عن الواقع.
ولم يكن استخدام الدراما كأداة للتوجيه والحشد أمرًا جديدًا أو طارئًا. فعبر التاريخ، استُخدمت الأعمال الفنية في أوقات الحروب لتكريس صورة العدو، وفي فترات التحولات الكبرى لإعادة كتابة التاريخ، وفي لحظات الانكسار لتبرير الهزيمة أو إعادة توزيع اللوم داخل المجتمع. لكن الفارق اليوم أن التأثير بات أوسع وأسرع، بفعل الانتشار الكاسح للمنصات، وتراجع دور القراءة، وسيطرة الصورة على المشهد الثقافي.
وتبلغ هذه الظاهرة ذروتها في شهر رمضان، الذي يحتل مكانة خاصة في الوجدان المصري والعربي. ففي هذا الشهر، لا تقتصر المشاهدة على أفراد متفرقين، بل تجتمع الأسرة بأجيالها المختلفة حول شاشة واحدة، في لحظة نادرة من التلقي الجماعي. هنا، لا تُخاطَب فئة بعينها، بل يُخاطَب الوعي الأسري المشترك، بكل ما يحمله من قيم متوارثة وحساسيات أخلاقية.
وفي هذا السياق الرمضاني، تبرز محاولات بعض المنتجين والمؤلفين وكتّاب السيناريو استغلال هذا التجمع الأسري لتمرير أفكار ورسائل بعينها، عبر أسلوب ناعم لا يصطدم بالمشاهد، بل ينساب إليه بهدوء. تُغلف الرسائل الإشكالية بحبكات جذابة، وتُمرر عبر أبطال محبوبين، وتُطرح داخل سياقات إنسانية تجعل الاعتراض عليها يبدو قسوة أو جمودًا. وهنا يتحقق ما يمكن وصفه بدس السم في العسل، حيث تختلط المتعة بالتوجيه، والترفيه بإعادة تشكيل المفاهيم.
الخطورة في هذا الأسلوب لا تكمن في الطرح المباشر، بل في التدرج المحسوب. فالفكرة لا تُلقى دفعة واحدة، بل تُقدَّم على مراحل، وتُعاد صياغتها في كل مرة بصورة أكثر ليونة، حتى تفقد قدرتها على إثارة الرفض. ومع مرور الوقت، لا يعود المشاهد يتساءل، بل يسلّم، وتتحول الرؤية المطروحة إلى جزء من المشهد الذهني العام.
وتتضاعف هذه الخطورة حين يتعلق الأمر بالأجيال الأصغر سنًا، التي تتلقى الدراما دون امتلاك أدوات نقدية كافية، وتتعامل مع ما يُعرض على الشاشة بوصفه انعكاسًا صادقًا للواقع. ومع التكرار السنوي للمواسم الرمضانية، تتراكم الرسائل، وتتشكل القناعات، ويُعاد تعريف ما هو مقبول ومرفوض داخل الوعي الناشئ.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال الدور الذي تلعبه الصورة الدرامية في إعادة تشكيل الحس الأخلاقي للمجتمع، إذ لا تكتفي بعرض الفعل، بل تُعيد ترتيب مشاعر التعاطف والإدانة داخله. فحين يُقدَّم الخطأ في إطار إنساني مُبرَّر، وتتوارى نتائجه الحقيقية خلف سرد عاطفي جذاب، يصبح الحكم الأخلاقي ملتبسًا، وتضيع الحدود بين ما يستحق الفهم وما يستوجب الرفض.
وتكمن الإشكالية الأكبر في أن هذا التحول لا يحدث دفعة واحدة، ولا يثير ضجيجًا أو مقاومة، بل يتسلل تدريجيًا، عبر مشاهد عابرة وحوارات ذكية وتبريرات نفسية تبدو للوهلة الأولى عميقة وإنسانية. ومع الوقت، يجد المشاهد نفسه وقد غيّر زاوية نظره دون أن يعي لحظة التحول نفسها. وهنا تكمن خطورة الدراما بوصفها أداة تأثير بطيئة المفعول، لكنها شديدة الرسوخ.
كما أن اختزال الصراع الإنساني في بعد واحد، أو تقديم المجتمع دائمًا في صورة القامع، والقيم في صورة العائق، والأسرة في صورة العبء، يخلق وعيًا مشوهًا بالعلاقة بين الفرد ومحيطه. فبدلًا من تقديم صورة مركبة للواقع، بما يحمله من تناقضات ومسؤوليات متبادلة، تُطرح رؤية تبسيطية تُحمِّل البُنى الاجتماعية وحدها مسؤولية الفشل، وتُعفي الفرد من أي مساءلة ذاتية.
ولا يقتصر هذا التأثير على المستوى القيمي فقط، بل يمتد إلى تشكيل التوقعات الاجتماعية ذاتها. فالدراما، حين تُفرط في تصوير أنماط حياة بعينها بوصفها النموذج السائد، تُنتج فجوة بين الواقع والمتخيَّل، وتزرع الإحباط لدى قطاعات واسعة من المجتمع، خصوصًا الشباب، الذين يقيسون حياتهم اليومية على معايير درامية مصطنعة لا تعكس حقيقة الظروف ولا تعقيداتها.
ولا يمكن فصل هذا النقاش عن التحولات الكبرى التي شهدتها صناعة الدراما نفسها، حيث لم تعد خاضعة فقط لاعتبارات فنية أو إبداعية، بل دخلت بقوة في منطق السوق، والسباق على نسب المشاهدة، والانتشار الرقمي، ما جعل الرسالة أحيانًا رهينة الإثارة السريعة لا العمق، والصدمة لا التأمل.
ومع تصاعد تأثير المنصات الرقمية، لم تعد الدراما حدثًا موسميًا ينتهي بانتهاء العرض، بل أصبحت مادة قابلة لإعادة المشاهدة، والانتشار المقطعي، والاقتطاع خارج سياقها الأصلي، وهو ما يمنح الرسائل الدرامية عمرًا أطول وتأثيرًا أوسع.
ولا يمكن إغفال أن أخطر أشكال التأثير الدرامي هي تلك التي تُمارَس باسم الواقعية، حين يُقال للمشاهد إن ما يُعرض عليه هو “الواقع كما هو”، بينما الواقع ذاته بناء انتقائي قابل لإبراز بعض ملامحه وإخفاء أخرى.
أما العلاج، فلا يمكن اختزاله في إجراء واحد أو قرار إداري عابر، لأنه يتعلق ببنية وعي كاملة تشكّلت عبر سنوات من التلقي غير المشروط. فالمواجهة الحقيقية لا تكون بالمنع، ولا بالمطاردة الأخلاقية، بل ببناء منظومة وعي موازية قادرة على الفهم والتفكيك والمساءلة.
أول ملامح هذا العلاج هو استعادة الاعتبار للتعليم النقدي، وثانيها إحياء دور النقد الفني الجاد، وثالثها تحمّل صُنّاع الدراما أنفسهم لمسؤوليتهم الأخلاقية، إلى جانب دور الأسرة، والمؤسسات الثقافية، وكسر وهم براءة الدراما.
فحين يدرك المجتمع أن ما يُعرض عليه ليس محايدًا بالضرورة، ولا شريرًا بالضرورة أيضًا، يصبح قادرًا على إقامة علاقة ناضجة مع الفن، علاقة تقوم على المشاهدة الواعية لا الاستهلاك الأعمى.
وعند هذه النقطة فقط، تستعيد الدراما دورها الأصيل: مرآة للواقع لا قالبًا جاهزًا يُصب فيه الوعي، ومساحة إنسانية للتعبير لا وسيلة لإعادة هندسة العقول.
نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي