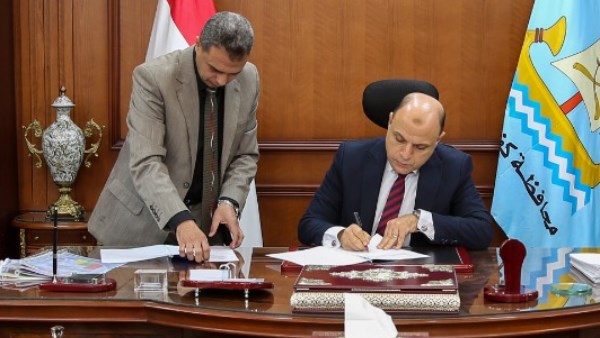ما يجري في عام 2026 ليس تحوّلًا تدريجيًا كما تحب مراكز الأبحاث أن تصفه، ولا مرحلة انتقالية يمكن احتواؤها بتقارير مطمئنة. ما يحدث هو تفكك علني لنظام دولي انتهت صلاحيته التاريخية، بينما يواصل حراسه التظاهر بأنه ما زال صالحًا للإدارة. نحن أمام نظام عالمي يُفكك قطعة قطعة، تحت مسمّى الواقعية السياسية، فيما تُدار الفوضى ببرود قاتل وكأنها الخيار الوحيد المتاح.
النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، وتضخم بعد الحرب الباردة، يقف اليوم عاجزًا عن فرض قواعده أو حماية ركائزه. المؤسسات التي رُوّج لها لعقود كحَكَمٍ محايد، انكشفت كأدوات انتقائية تُفعّل حين تخدم مصالح الكبار، وتُعطَّل حين تُقيّدهم. لم يعد القانون الدولي مظلة، بل تفصيلًا يمكن تجاوزه حين يتعارض مع موازين القوة.
في قلب هذا المشهد، تقف الولايات المتحدة في وضع غير مسبوق: قوة عظمى بلا مشروع عالمي واضح. لم تعد قادرة على القيادة المنفردة، ولا راغبة في الانسحاب الكامل. تُلوّح بالقوة أكثر مما تستخدمها، وتراكم العقوبات بدلًا من حسم الصراعات. هذه ليست هيمنة، بل إدارة خوف من فقدان النفوذ في نظام دولي جديد يتشكّل من دونها أو على حسابها.
أما أوروبا، التي طالما قدّمت نفسها بوصفها ضمير النظام العالمي، فقد اكتشفت أن الخطاب الأخلاقي لا يحمي الحدود، ولا يضمن أمن الطاقة، ولا يمنع الانهيار الاقتصادي. تحوّلت من شريك في صناعة القرار الدولي إلى تابع قَلِق، يعيد ترتيب أولوياته تحت ضغط الخوف. حين تتقدّم الحاجة، تتراجع القيم، وحين يسقط الادعاء الأخلاقي، يصبح كل شيء قابلًا للتبرير باسم “الضرورة”.
في المقابل، لا تصعد قوى جديدة لأنها أكثر عدلًا، بل لأنها أكثر صبرًا وواقعية. الصين لا تنافس الغرب بخطاب أيديولوجي، بل بتغيير بطيء وعميق في قواعد الاعتماد العالمي: اقتصاد، تكنولوجيا، بنية تحتية، ونفوذ صامت يتسلل بلا ضجيج. بكين لا تهدم النظام الدولي القديم، لكنها تفرغه من مضمونه، وتبني داخله نظامًا موازياً ينتظر لحظة التفوق الكامل.
أما روسيا، فقد أتقنت اللعب على حافة الصدام. لا تسعى إلى نصر عسكري تقليدي، بقدر ما تسعى إلى إثبات أن الخطوط الحمراء لم تعد قائمة إلا في الخطاب الغربي. كل تحرك محسوب لإعادة تعريف الردع، لا احترامه. سياسة اختبار الأعصاب أصبحت أداة استراتيجية، حيث يتحول الصمت الدولي إلى جزء من المعركة.
وسط هذا التفكك، تتحرّك القوى الإقليمية ودول الجنوب العالمي بوعي مختلف. لم يعد هناك مكان لدور “الوكيل” المطيع. التحالفات في 2026 أصبحت سائلة، مؤقتة، تحكمها المصالح اللحظية لا الالتزامات الطويلة. الشرق الأوسط، تحديدًا، لم يعد هامشًا في النظام العالمي، بل عقدة مركزية تتقاطع فيها الطاقة مع الجغرافيا، والأمن مع الهوية، ومصالح القوى الكبرى مع حسابات البقاء.
الخطر الحقيقي في النظام العالمي الجديد ليس اندلاع حرب عالمية شاملة، بل تطبيع الانفلات. أن يصبح غياب القواعد هو القاعدة. أن تُدار الأزمات لا بهدف حلّها، بل لاستثمارها. أن يعيش العالم في حالة طوارئ سياسية دائمة تُبرّر القمع، والتدخل، والصمت، وحتى الجرائم، باسم حماية المصالح.
في عام 2026، لم تعد الشرعية تُستمد من المواثيق الدولية، بل من القدرة على فرض الأمر الواقع. من يملك أدوات القوة يكتب القواعد، ومن لا يملكها يُدفع إلى هامش التاريخ، مهما كانت عدالة قضيته أو وضوح مظلمته.
السؤال الحقيقي لم يعد: من سينتصر؟
بل: من سيخرج من هذا العالم الجديد وهو ما زال يملك قراره؟
لأن العالم في 2026 لا يُكافئ الأخلاقيين،
ولا ينتظر المترددين،
ولا يرحم من يظن أن القواعد القديمة ما زالت قادرة على حمايته .