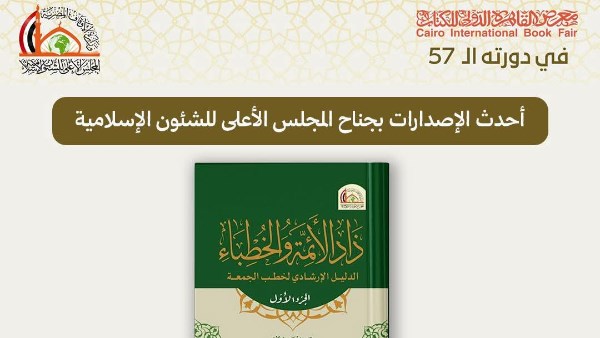العنف ليس مجرد صفعة عابرة أو كلمة جارحة؛ إنه زلزال يهز أساس الحياة، يهدم الطمأنينة في قلب امرأة، ويقتلع الأمان من حضن طفل. وراء الأبواب المغلقة تختبئ مآسٍ لا تراها العيون، صرخات مكتومة لا تصل إلى مسامع أحد، ودموع جفت قبل أن تجد من يمسحها.
هناك، في صمت البيوت، تمارس أقسى صور العنف ضد المرأة والأطفال، وكأن البيت الذي كان يفترض أن يكون حصنًا للحب صار ساحة حرب بلا هوادة.
المرأة في مواجهة هذا العنف ليست مجرد ضحية، بل تتحول في كثير من الأحيان إلى حارس حياة. تدافع بجسدها عن أطفالها، تضع نفسها أمام العاصفة لتخفف عنهم وطأتها. كم من أم نزفت دمها، أو حتى فقدت حياتها، فقط لتمنح أطفالها فرصة النجاة من يد قاسية. لحظة كهذه تختصر معنى الأمومة كله: أن تضع قلبك على كفك في سبيل حياة صغيرة لا تملك إلا البكاء.
العنف ضد المرأة لا يترك أثره على جسدها فحسب، بل يجرح روحها، يكسر صورتها في أعين نفسها، ويجعلها أسيرة خوف دائم. وحين يمتد هذا العنف ليطال الأطفال، فإنه لا يترك لهم مجرد ندوب على الذاكرة، بل يصوغ مستقبلهم بطريقة مشوهة. فالطفل الذي يكبر في بيت يسكنه العنف، يتعلم أن الصراخ لغة، وأن الضرب وسيلة، وأن الخوف رفيق دائم. كيف نطلب من هذا الطفل أن يبني غدًا مختلفًا، وهو لم يعرف سوى الجدران التي ترتجف تحت صوت الغضب؟
العنف الأسري يخلق أجيالًا محطمة، رجالًا يكررون ما عاشوه دون وعي، ونساءً يعتقدن أن القسوة قدر لا مفر منه. إنه دائرة مغلقة، كلما اتسعت، ابتلعت معها مزيدًا من الأرواح والأحلام. في مجتمعاتنا، كثيرًا ما تُلقى المسؤولية على المرأة لتتحمل وتصبر، بينما يُترك الرجل في معزل عن المحاسبة، وكأن قسوته أمر مقبول أو حتى مبرر. لكن الحقيقة أن أي تبرير للعنف هو خيانة للحياة نفسها، خيانة لكل أمومة تحلم بالسلام، ولكل طفولة تستحق أن تكبر في أمان.
المشكلة أن العنف لا يُرى دائمًا في شكله الجسدي فقط، بل يتسلل في صمت عبر الكلمات الجارحة، الإهمال، الحرمان من الحب، وحتى عبر الصمت الطويل الذي يحول البيت إلى فراغ خانق. هذا النوع من العنف قد يكون أكثر فتكًا، لأنه يقتل الروح ببطء، ويترك الإنسان حيًا جسدًا لكنه ميت داخليًا.
حين نتحدث عن العنف، لا نتحدث فقط عن مأساة فردية، بل عن قضية اجتماعية تهدد بنيان المجتمع كله. فالمرأة المعنفة لا تستطيع أن تربي أطفالًا أصحاء عاطفيًا، والطفل المعنف يكبر وهو يحمل داخله بذور قسوة جديدة. هكذا تتوارث الأجيال العنف كما يتوارثون الملامح، وتستمر الدائرة إلى ما لا نهاية، ما لم يقف المجتمع وقفة حقيقية أمام نفسه.
الأم التي تفقد حياتها دفاعًا عن طفلها ليست قصة فردية، بل هي رمز لواقع يعيشه آلاف غيرها. في لحظة المواجهة، تتحول الأم إلى درع بشري يحرس براءة أطفالها بدمها، وكأنها تقول للعالم: "خذوا حياتي، لكن دعوا لهم غدًا أفضل". إنها البطولة الأكثر وجعًا، بطولة لا تُحتفل بها في الأخبار إلا كحادثة عابرة، بينما حقيقتها أعمق بكثير من مجرد عنوان.
لقد آن الأوان لأن نكف عن التعامل مع العنف كقضية ثانوية. لا يكفي أن نكتفي بالتعاطف مع الضحايا، بل علينا أن نخلق بيئة حماية حقيقية، قوانين رادعة، ومؤسسات فاعلة، وأهم من ذلك وعي مجتمعي يرفض أي شكل من أشكال العنف. الصمت لم يعد خيارًا، لأن كل صمت يساوي حياة مهددة جديدة.
العنف ليس قدراً، ولا يجب أن يكون سمة في بيوتنا. البيت الذي تُزهق فيه روح امرأة أو تُطفأ فيه طفولة طفل ليس بيتًا، بل قبرًا مفتوحًا. والمرأة التي تُضرب أو تُهان ليست مطالبة بالصبر، بل تستحق الحماية والكرامة. والأطفال الذين يختبئون في زوايا الغرف خوفًا من صراخ أب، يستحقون أن يعرفوا أن الحياة أوسع من جدران الرعب، وأنهم خُلقوا ليضحكوا لا ليبكوا.
دم الأم الذي يسيل دفاعًا عن طفلها ليس دمًا عابرًا، بل هو شاهد على عجزنا كمجتمع عن حماية أضعفنا. كل نقطة دم هي صرخة تقول: كفى. كل صرخة مكتومة في بيت مغلق هي دعوة للوعي والمسؤولية. وكل طفل ينام وفي قلبه خوف هو جرح في جسد المجتمع بأسره.
إن أرواح النساء والأطفال ليست أرقامًا في تقارير، بل هي حياة تستحق أن تُعاش بكرامة. وإذا لم نقف اليوم ضد العنف بكل أشكاله، فغدًا سنجد أنفسنا في مجتمع بلا حب، بلا رحمة، وبلا أمان. وحينها لن ينفع الندم، لأننا سمحنا للبيت أن يتحول من حضن إلى ساحة حرب، وللأم أن تموت وهي تحرس براءة طفل كان يستحق أن يكبر بين ذراعيها، لا بين جدران الخوف.