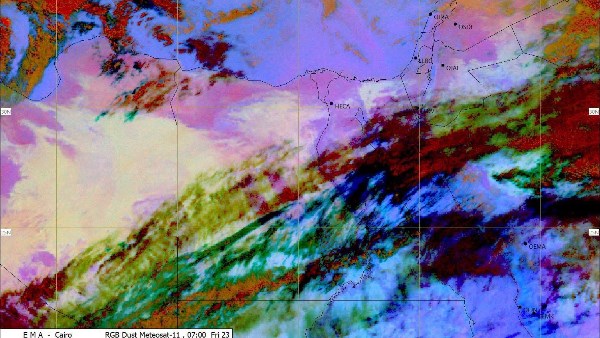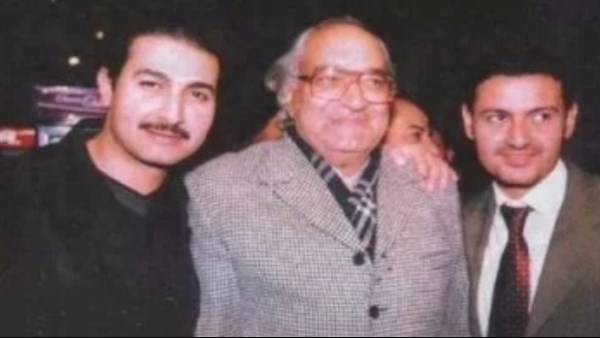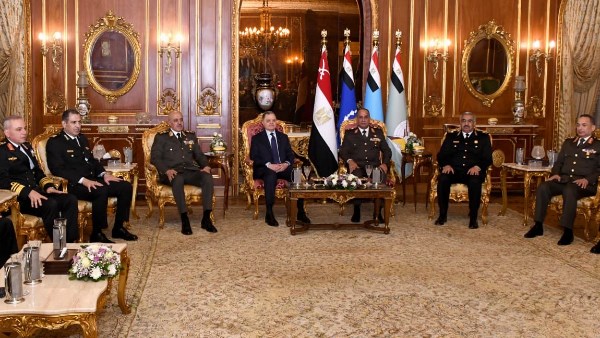في الأفلام والمسلسلات لا تُنتزع الموافقة دائمًا بالقوة؛ كثيرًا ما تُصاغ بهدوء عبر “هندسة المشهد”، موسيقى تُطمئن، زوايا كاميرا تُجمل، روتين يومي يُعود، وحبكة تضغط بحيث يبدو الخيار الوحيد “طبيعيًا”. هكذا تُدفع الشخصيات ــ وأحيانًا نحن كمشاهدين ــ إلى القبول دون أن ننتبه أن القبول نفسه مُصمم سلفًا.
هنا، يكمن لغز الموافقة المُهندَسة — حكاية قصيرة جدًا عن كيف نقول “حاضر” دون أن نلاحظ
لكن، قبل أن نبدأ، فلنسم الأشياء بأسمائها. “الموافقة المُهندَسة” ليست وحشًا يختبئ تحت السرير، لكنها طريقة مرتبة بعناية لفرش الطاولة كي تمتد يدك تلقائيًا إلى الطبق الأقرب. أول حيلة اسمها "بنية الاختيار"، يوضع أمامك ثلاثة أبواب، واحد واسع بإضاءة دافئة ولافتة “من هنا”، واثنان ضيقان خلفهما ممر طويل. لا أحد أجبرك، لكنك ستختار الباب المضيء لأنك بشر وتحب السهل...
ثم يأتي "التطبيع البصري"، فتعرض الصورة نفسها عدة مرات كافية حتى تصبح عادية—كوب القهوة المثالي، المكتب المرتب، الابتسامة المطمئنة، فتجد نفسك توافق لأنه ببساطة “هكذا تبدو الدنيا عادةً”، والعادي مريح...
يبدأ بعدها "الضغط العاطفي"، فيتم انتظارك عند نقطة تعبك، خسارة صغيرة، خوف مباغت، وحدة مسائية، ويقدمون الحل ملفوفًا بورق هدايا، نغمة موسيقى دافئة، كلمة “لا تقلق”. في لحظات الوهن، كلمة “نعم” تنزلق من الفم أسرع.
وأخيرًا يأتي "السرد المُحابي" وهنا، تلصقنا الكاميرا بجبهة البطل؛ نسمع دقات قلبه، نرى دموعه، فنمشي بقدميه وننسى أن هناك آخرين خارج الإطار. حين نحمل رأسه على أكتافنا، نحمل قراره أيضًا دون أن نسأل كثيرًا.
في النهاية، لا أحد قال لك “وقع هنا وإلا…”. أنت فقط قلت “ماشي” لأن الطريق مُمهد، والإضاءة جذابة، والقصة تحكي من زاوية تجعل الرفض يبدو قاسيًا. وهذه بالضبط هي اللعبة.
أول ما تعلمه الشاشة أنها لا تنتزع منك كلمة نعم، وإنما تربيها في قلبك حتى تمشي وحدها.
تبدأ الحكاية بضحكة خفيفة ولمعة عيون في « بـ100وش»، عملية وراء عملية، فيتحول الاحتيال إلى لعبة لطيفة ويمشي الضمير على أطراف أصابعه لأن الفريق جذاب والنتيجة مسلية. ثم تأخذك إلى «هذا المساء» حيث الهاتف يعرف كل شيء عن صاحبه، فيصبح الاختيار شكلاً مهذبًا للخوف، تقول نعم لأن الأسرار قاب قوسين من الانكشاف ولأن من يهمس لك لا تقلق يضعك في زاوية ضيقة. وفي «سهر الليالي» نفهم كيف يجمل الدفء صورة الحياة حتى نؤجل الرفض لليلة أخرى، نرضى بما هو مألوف لأن الطاولة مليئة بالأصدقاء ولا نريد كسر الكأس. وفي «جراند أوتيل» الفن والإضاءة والموسيقى تصنع ممرًا ناعمًا للطاعة، الفندق نفسه يعلمك أن تنحني بابتسامة وأن تمرر الورقة من دون جدال. وفي «ليه لأ» نرى العكس الجميل حين تتغير بنية الاختيار لصالح الحرية، لكن قبل ذلك كانت العيون كلها تراقبك حتى توافق حفاظًا على السلام الاجتماعي. و«تحت السيطرة» يثبت أن كلمة مطمئنة في توقيت هش تكفي لجر خطوة كاملة، ليس لأننا ضعفاء لكن لأن المشاعر الداخلية تريد راحة سريعة. وحتى «خلي بالك من زيزي» يعلمنا أن العلاج نفسه يمكن أن يصبح إطارًا ذهبيًا لدفع القرار، نوقع لأننا نبحث عن نسخة مرتبة من حياتنا. في النهاية لا أحد يجبرك حقًا، كل ما هنالك ترتيب لطيف للمشهد حتى يبدو الطريق الأقرب هو الطريق الوحيد، وهذا هو سر الصنعة...
وقبل أن نسدل الستار، يلزمنا اعتراف صغير، الشاشة لا تقول لك وافق، لكنها ترتب المواقف كي تقولها من نفسك. موسيقى تصعد خطوة خطوة مع البطل فتبرر له ما يفعل، ولقطة قريبة تحاصر وجهًا واحدًا فننسى الوجوه الباقية خارج الإطار. مونتاج سريع يقطع الطريق إلى نجاحات متتالية فيبدو الصعب سهلًا بطبيعته، وصوت الراوي يهب دوافعه شكل الحقيقة الهادئة. يدخل “الخبير” بثوب طبيب أو مدير فيمنح الاختيار لمعانًا رسميًا، وتمسح النكتة اعتراضك في اللحظة الحرجة. ثم يأتي الروتين الدافئ، قهوة تتبخر كل صباح، تحية على السلم، طريق محفوظ… فتلتصق الراحة بخيار واحد، ويضيق قلبك عن الباقي.
وهنا، علينا أن نتعلم أن السؤال الأهم ليس: هل وافقت؟
ولكن: كيف صُنِعت موافقتك؟
حين نُدرب أعيننا على كشف هذه الهندسة، لا نفقد متعة المشاهدة؛ لكننا نربح متعة أعمق، أن نرى الفيلم أو المسلسل مرتين في آنٍ واحد — قصة تُروى، وآلة تعمل