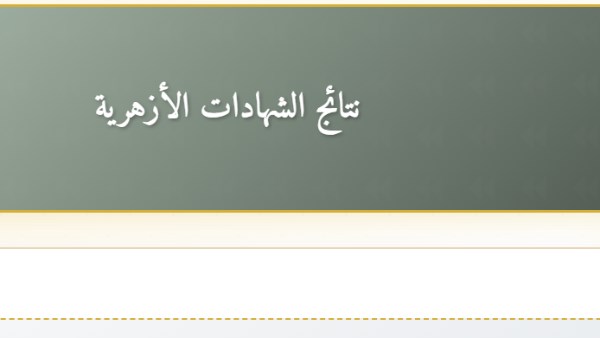لا أعرف لماذا، كلما قرأت هذه العبارة «التحدي الحضاري كبير وخطير»، ترد إلى ذهني صورة ذلك الرجل المسن الذي كان يجلس كل صباح أمام منزلنا في المنيا، يشرب شايه بنفس الطريقة، وينظر إلى الشارع بنفس النظرة الهادئة الحزينة، رغم الضجيج والزحام. كان يبدو وكأنه يعرف سراً لا نعرفه نحن الصغار المتحمسين. السر، كما أدركت لاحقاً، كان اسمه الصبر.
نحن أمة تتعرض لزلزال حضاري منذ قرون، ليس الزلزال مجرد غزو عسكري أو هيمنة اقتصادية، فهو أعمق من ذلك بكثير. إنه زلزال يهز أسس ثقتنا بأنفسنا، بتاريخنا، وبمستقبلنا أيضاً، إنه ذلك الشعور الغامض بأن العالم من حولنا يسير بسرعة الصاروخ، بينما نحن نمشي على قدمين، أو ربما نقف في مكاننا ندور حول ذواتنا. هذا هو جوهر التحدي الحضاري: إنه أزمة هوية في عصر العولمة، أزمة قيم في عصر المادة، وأزمة وجود في عصر اللامعنى.
مظاهر التحدي
التحدي الحضاري ليس مجرد منتجات غربية نشتريها أو أزياء نقتنيها، إنه ذلك الصوت الخفي الذي يهمس في أذن أطفالنا قائلاً: لغتنا جميلة لكنها لا تطعم خبزاً. إنه ذلك الإحساس بالدونية الذي يتسلل إلى نفوسنا حين نرى مبتكراً أو عالماً من ثقافة أخرى فنقول بأسى: كنا نحن الأسبق إلى هذا. إنه انقسام الشخصية إلى شقين: شق يتشبث بتراثه وهو غير مقتنع به تماماً، وشق يتوق إلى الحداثة وهو خائف منها. نحن نعيش في «المنطقة الرمادية» بين حضارتين، لا ننتمي إلى القديم بشكل كامل، ولا نندمج في الجديد بشكل طبيعي.
وهنا تكمن الخطورة، الخطورة في أننا قد ننساق بدافع القلق أو اليأس إلى حلول سريعة ومزيفة، إما الانغلاق على الذات والهروب إلى الماضي وكأننا نعيش في متحف شعبي كبير نكرر طقوساً بلا روح، أو الانسلاخ الكامل عن الجذور والاندماج في الحضارة الوافدة بشكل أعمى، مثل ذلك الطالب الذي سافر للخارج فعاد لا يتكلم لغته بطلاقة، ولا هو انتمى حقاً إلى الثقافة الجديدة. كلا الحلين هروب من مواجهة الحقيقة.
لماذا الصبر؟
في هذا المشهد، تبرز فضيلة «الصبر على المكاره» ليس كخيار من بين خيارات، بل كضرورة وجودية، والصبر هنا ليس سلبية أو استسلاماً، وليس مجرد قدرة على تحمل الألم، إنه أشبه بعملية «هضم حضاري»، كما أن الجسم لا يستفيد من الطعام إلا بعد أن يهضمه ويحوله إلى طاقة ولبنات بناء، هكذا الأمة لا تستفيد من احتكاكها بالحضارات الأخرى إلا إذا امتلكت صبراً على هضم هذه المؤثرات وتمثلها وإعادة إنتاجها في ضوء قيمها وهويتها.
الصبر هو أن نرفض الإجابات الجاهزة، هو أن نقبل بأن مرحلة «المراجعة والنقد الذاتي» و«إعادة البناء» هي مرحلة طويلة ومؤلمة قد تمتد لأجيال، هو أن نتحمل سخرية الآخرين من بطئنا، وسخط الداخليين من تعقيد طريقنا، الصبر هو أن نثق في أن الأمة، كالكائن الحي، لديها قدرة على التكيف والشفاء والنمو، ولكن في وقتها الخاص، وليس وفقاً لمواعيد الآخرين.
تاريخ النهضة في أوروبا نفسها، بعد عصورها المظلمة، يؤكد أنها لم تنتقل إلى النهضة بين ليلة وضحاها، بل احتاجت إلى قرون من التمهيد والصراع والصبر على مكاره التخلف والانقسام. نحن الآن في مرحلة المخاض، والمخاض عملية مليئة بالألم، ولكنها تؤدي إلى حياة جديدة.
لكن الصبر الذي أنادي به ليس صبر الانتظار السلبي، إنه صبر الفلاح الذي يحرث الأرض ويبذر البذور ثم ينتظر المطر، وهو يعلم أن انتظاره هذا جزء من عملية الزرع ذاتها، إنه صبر الناقد الذي يقرأ ويحلل ولا يسارع بإصدار الأحكام، إنه صبر المربي الذي يغرس القيم في الأجيال الجديدة وهو يعلم أن الثمار لن يجنيها هو، بل من يأتي بعده.
علينا، ونحن نصبر، أن نعمل في صمت، أن نعيد بناء الإنسان من الداخل بأن نعلمه كيف يفكر لا ماذا يفكر، أن نغرس فيه الثقة لا الغرور، وأن ننمي فيه حب المعرفة لا مجرد الشهادة، علينا أن نصلح تعليمنا لا بأن نضيف مناهج جديدة، بل بأن نغير فلسفة التعليم ذاتها من التلقين إلى الإبداع، علينا أن نعيد إنتاج ثقافتنا بلغة العصر لا بلغة الأمس.
التحدي الحضاري كبير وخطير بالفعل، لأنه اختبار لإرادتنا وجوهر إنسانيتنا، لكن التاريخ لم ينته بعد، الأمة التي أعطت العالم ابن خلدون وابن رشد والكندي، لم تضع قدرتها على العطاء، ربما كنا نمر بمرحلة سبات طويل، ولكن السبات ليس موتاً.
الصبر على المكاره في هذه المرحلة هو شجاعة الفارس الذي يتراجع خطوة إلى الوراء ليجمع قواه، لا هروب الجبان، هو الحكمة التي تدرك أن أعمار الحضارات تقاس بالقرون لا بالأيام، هو الإيمان بأن هذه الأمة التي صبرت على صنوف من المحن عبر تاريخها الطويل قادرة على أن تصبر مرة أخرى، ولكن ليس كي تبقى على قيد الحياة فقط، بل كي تعود إلى الدائرة من جديد، حاملة معها حكايتها الخاصة، ومعطاءة للعالم نوراً مختلفاً، هو نورها هي.
الهضم الحضاري
إذا كان الصبر في أصله اللغوي والشرعي يعني الحبس- حبس النفس عن الجزع وحبسها على طاعة الشرع- فإنه في سياقنا الحضاري يتعدى هذا المفهوم السلبي إلى عملية هضم نشطة، إنه ليس مجرد قدرة على تحمل الألم، بل هو آلية معقدة لتمثيل المؤثرات الحضارية الوافدة، واستخلاص ما ينفع وطرح ما يضر، ثم إعادة إنتاج هويتنا في قوالب جديدة تلائم العصر دون أن تفقد جوهرها.
وهذا الهضم لا يكون إلا بما أسماه القرآن «الصبر الجميل»، وهو صبر لا عتب فيه ولا شكوى إلا إلى الله، صبر يعرف أن «الله مع الصابرين»، وأن أجرهم موفور «بغير حساب»، إنه الثقة بأن وراء هذا التحدي حكمة إلهية، وأن هذا البلاء جزء من «التربية الإلهية» كما يذكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مما يحول السؤال من «لماذا أنا؟» إلى «ماذا يريد الله أن أتعلم من هذا؟».
مقومات الصبر الإيجابي: بين الفرد والأمة
لكي لا يتحول صبرنا إلى سلبية مميتة أو انتظار قاحل، فإنه يحتاج إلى مقومات تجعله قوة دافعة نحو البناء:
الوعي بالمعنى: فـ«الصبر ليس أن تنتظر، بل كيف تنتظر». في لحظات الألم والضيق، «ينهار من يعيش القلق، ويصمد من يعيش المعنى». وهذا المعنى يُستمد من فهم عميق للسنن الإلهية في الكون والتاريخ، ومن ثقة بأن مراحل الضعف ليست قدراً أبدياً، بل محطات لإعادة التشكيل والترقية.
التمسك باللغة والقيم: للغة أثر واضح في تشكيل الأخلاق والحضارة، فهي الوعاء الذي يحمل رؤيتنا للعالم، وهي حصن هويتنا الأخير، إن التمسك بلغة تتميز باتساع مفرداتها وتنوع معانيها وجمال ألفاظها هو شكل من أشكال الصبر النشط على التحدي الحضاري، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنظومة الأخلاقية التي هي أساس أي رقي حضاري، والتي بدونها تعم الفوضى ويكثر الدمار.
المراجعة والنقد الذاتي: الصبر الحقيقي ليس تغطية للعيوب، بل هو جرأة على كشفها ومعالجتها، وهو ما يتطلب صبراً من نوع آخر، هو الصبر على الحقيقة مهما كانت مريرة، وهذا يتناقض مع ثقافة الخوف والريبة التي تسود في المجتمعات الخاضعة للاستبداد، حيث يتحول المواطن إلى كائن ذي رأيين: رأي علني موافق ومؤيد دائماً، ورأي سري هو الرأي الحقيقي، ولا يمكن لأمة أن تواجه تحدياً حضارياً وهي مقيدة الفكر واللسان.
إننا اليوم، في معظم أوطاننا، ما زلنا نتراوح بين مرحلة «صبر المواجهة» و«صبر الهضم»، نصارع من أجل البقاء، ونحاول أن نهضم ما ينهال علينا من مؤثرات، ولكن الطموح يجب أن يتجه نحو «صبر البناء»، حيث نتحول من أمة تستهلك المعرفة إلى أمة تنتجها، ومن أمة تستجيب للتحديات إلى أمة تطرح الحلول.
الصبر الحضاري، في نهاية المطاف، هو ذلك «الصبر الجميل» الذي تجلى في أنبياء الله وأوليائه، الذين لم يكن صبرهم انتظاراً للخلاص، بل كان بناءً للذات، ودعوةً للحق، واستعذاباً للعسر في طريق الكمال، إنه الصبر الذي يعيد تعريف العلاقة مع الزمن، فلا يستعجل الثمرة قبل أوانها، ولا يقنط من تأخرها، وهو الذي يعيد للأمة ثقتها بنفسها، وبقدرتها على صناعة تاريخها من جديد، حاملة معها ذلك «النور المختلف» الذي تحتاجه الإنسانية في مسيرتها.